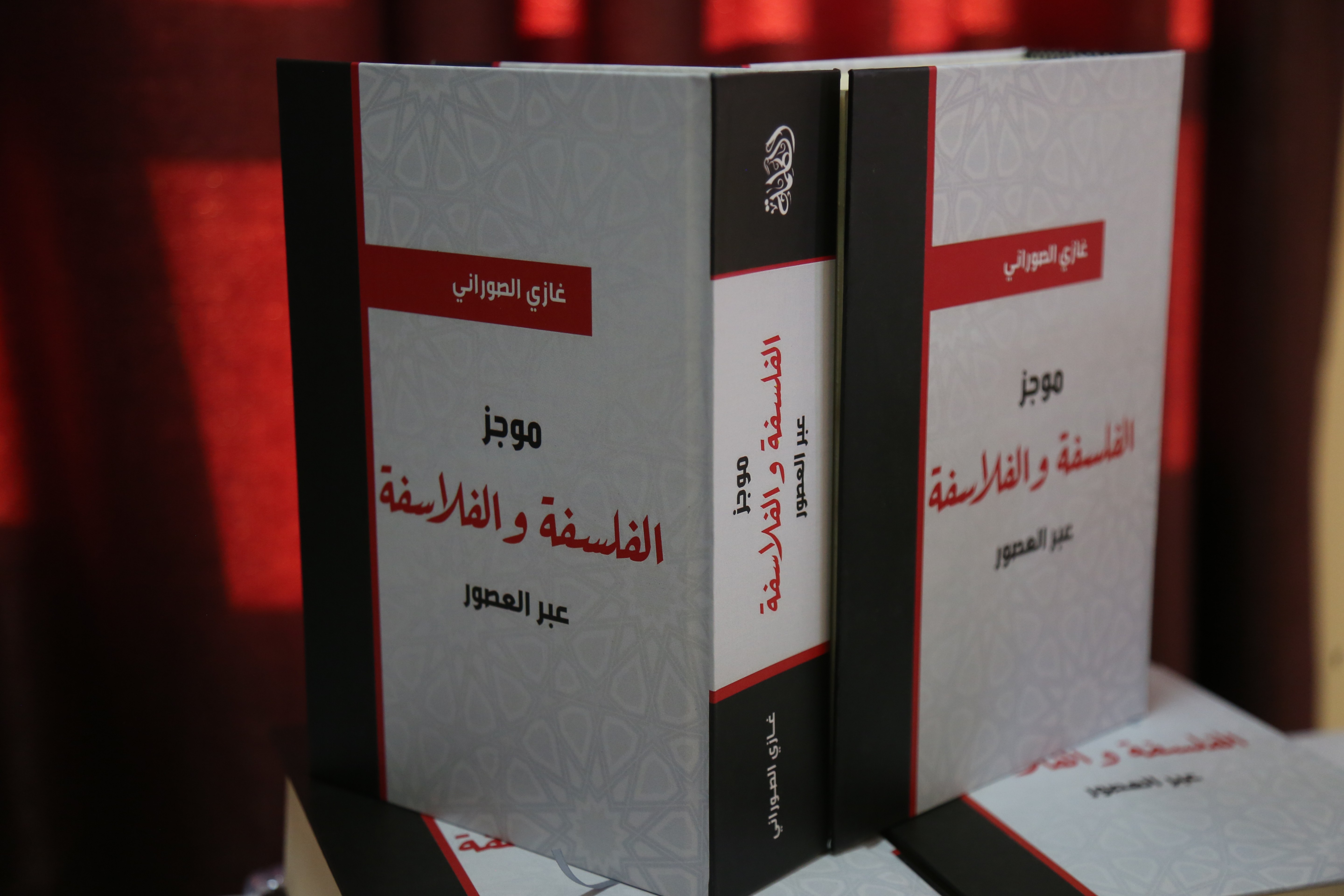(تنفرد بوابة الهدف، بنشر كتاب المفكر غازي الصوراني، المعنون: موجز الفلسفة والفلاسفة عبر العصور، الصادر عن دار الكلمة للنشر والتوزيع، في يونيو/ حزيران 2020، على حلقات متتابعة.. قراءة مثمرة ومفيدة نتمناها لكم).
الباب الرابع
الفلسفة الأوروبية في العصور الوسطى
الفصل العاشر
أبرز فلاسفة القرن التاسع عشر
ألكسي دو توكفيل (1805 - 1859):
ألكسيس دو توكفيل، مؤرخ ومنظر سياسي فرنسي، اهتم بالسياسة في بعدها التاريخي. أشهر آثاره: "في الديمقراطية الأمريكية" (1840 م)، و"النظام القديم والثورة" (1856 م).
أُعجب الأرستقراطي الفرنسي ألكسي دو توكفيل بالديمقراطية في أميركا، فقد رأى فيها وجود تطور لا يُقاوَم نحو مساواة أوسع في السلوك، وفي المواقف، وفي السياسة، وفي المؤسسات، "وبوصفه من طبقة النبلاء، "اتصف موقفه بالتضارب تجاه الحركة نحو الديمقراطية السياسية، غير انه كان واقعياً ومنفتحاً باعتباره مقرباً فكرياً من مونتسكيو. فمن جهة رأى أن الديمقراطية هي أكثر من كونها نظاماً قديماً، ومن جهة أخرى قَدَّر توكفيل مخاطر تسطيح المجتمع، أي : إذا كان الناس متساوين، سينشأ نقص في الجودة. ورأى أن الذي جمع الأميركيين كان، بشكل رئيسي الاهتمام المشترك بالمال والكفاءة.
غير أن توكفيل لم يكن يشعر بوجود تهديد للقيم الأرستقراطية وأفكار النخبة وحدها، فقد اعتقد بصعوبة التوفيق بين المذهب الفردي والحرية مع المساواة الديمقراطية، أي: عندما تتسلم الأكثرية الديمقراطية السلطة، في جميع المناطق، تصبح الأقلية المختلفة عنها والأفراد غير المنسجمين معها في خطر التعرض للقمع، وهذا القمع أكثر خطراً من سواه"([1]).
كان شعار الثورة الفرنسية هو: الحرية والمساواة والأخوة، غير ان توكفيل رأى أنه من الصعب الجمع بين الحرية والمساواة، وأن المساواة تميل إلى الفوز على حساب الحرية. وفضلاً عن ذلك اعتقد توكفيل أن الديمقراطية المبنية على المساواة السياسية، تؤدي إلى سلطة قوية للدولة، وأن الدولة، ستنظم أحوال الشعب المادية.
كما رأى توكفيل أن الميول لا تنحصر في التوجه نحو مساواة أوسع، وإنما نحو انقسامات طبقية جديدة، لان الميول نحو اللامساواة تجد جذورها في التصنيع، فمن جهة رأى توكفيل أن المساواة الديمقراطية تعزز ظاهرة التصنيع، لأن تأكيدها على الرفاهية المادية لكل إنسان، يخلق سوقاً متنامية للسلع الصناعية، ولأن المساواة الأوسع تيسر عملية تجنيد أناس موهوبين للعمل في التجارة وفي الصناعة.
ومن جهة أخرى، رأى توكفيل ميولاً نحو تصاعد في اللامساواة الاقتصادية، فالحرفيون المستقلون تحولوا إلى عمال في المعامل ليقوموا بعمل رتيب، والموظفون يديرون شركاتهم الكبيرة من دون اتصال بالموظفين إلا عند تبادل العمل والأجور.
لذا تنبأ بنشوء مساواة سياسية ولا مساواة اقتصادية، فكان توكفيل احد المفكرين الأوائل الذين شكوا بالإيمان بالتقدم، وناضل في سبيل نظرة متوازنة إلى فوائد وأضرار التطور الاجتماعي في النصف الأول من الثمانينيات (1800)"([2]).
أوغيست بلانكي (1805 – 1881 م):
مفكر ومناضل ثوري شيوعي، راديكالي، فوضوي، ولد في جنوب فرنسا، من أسرة ذات أصول إيطاليّة. انتقل إلى باريس، وهو في الثالثة عشرة من عمره. درس الحقوق والطبّ، إلاّ أنّه انخرط مبكّرا في العمل السياسي، و"انضمّ إلى جمعيّة الفحامين السرّيّة (الكاربوناريا)".
شارك في الحركات الطلابية ضدّ الحكومة الفرنسيه، وحمل السلاح سنة 1830 ضدّ نظام الملك شارل العاشر. واعتقل عديد المرات؛ فقد قضى معظم أطوار حياته بين السجون والمنافي، وكان ذلك ابتداء من سنة 1831 إثر مشاركته في المظاهرات ضدّ نظام الحكم القائم على أنقاض ثورة 1830، واعتقل أيضا سنة 1832 بسبب انتسابه إلى "جمعيّة أصدقاء الشعب" الثورية، ثم أُفرج عنه بعد عام، وأُعيد اعتقاله سنة 1836، حيث حكم عليه بالسجن مدّة عامين بتهمة صنع متفجّرات، وحُكِمَ عليه بالإعدام مرتين، وقضى ما يقارب نصف حياته مسجوناً، وفي عام 1848 -بعد الثورة- تمكن بلانكي من مغادرة سجنه، وشرع في تأسيس الجمعيات الثورية السرية، وأبرزها "الجمعيّة الجمهوريّة المركزيّة"، ثمّ عمل على تنظيم مظاهرات ضخمة للمطالبة بتأجيل الانتخابات، فأعيد اعتقاله مجدّدا، وصدر في حقّه حكم بالسجن لمدّة عشر سنوات، ولكنّه تمكّن هذه المرّة من الفرار في اتّجاه بلجيكا في نفس العام، ليعود مرّة أخرى إثر سقوط نابليون الثالث، وفي باريس أصدر صحيفة "الوطن في خطر"، ونشط في عديد المظاهرات ضدّ الحكومة، وهو ما تسبّب في اعتقاله، فلم يَحظَ بالمشاركة في كومونة باريس، وفي سنة 1880، أصدر صحيفة أخرى بعنوان "لا إله ولا سيّد".
قام بتنظيم جمعيات سرية اشتراكية شيوعية "تحت تأثير أفكار المفكر الثوري "بابوف"، حيث اعتبر "بلانكي" أن الحل النهائي للخلاص من الاستغلال والفقر والمِلْكية الخاصة، يكمن في تحقيق الثورة الشيوعية وإقامة ديكتاتورية العمال، ولكنه تبنى نهجاً انقلابياً عنيفاً من أجل تحقيق أهدافه، انطلاقاً من قناعته بأن مصدر الثروات الكبيرة هو في حد ذاته "دَنَسْ" نتيجةً للنهب والاستغلال الرأسمالي في عصره، كما رأى أن البرجوازية في فرنسا وأوروبا تحاول التغلب على أزماتها من خلال استعمار البلدان الفقيرة.
"عَرّف "بلانكي" الثورة بانها "حرب الفقراء ضد الأغنياء"، وقال بضرورة استيلاء أقلية منظمة على السلطة تمثل دكتاتوريتها مرحلة انتقالية نحو المجتمع الشيوعي، كما رفض فكرة الانتخابات ما دامت الجماهير "مُعْمى عليها"، بسبب عبوديتها، وَتَغَّنى بالإضراب بوصفه "السلاح الشعبي حقاً في مواجهة الرأسمال".
في افكاره وفلسفته، انتصر للمادية والالحاد، وهجا الأديان ناعتاً إياها بـ"آفة العالم" ورجال الاكليروس العاملين في خدمتها بانهم "جيش أسود"، كما انتقد اصلاحيي زمانه من السانسيمونيين والفوريويين والوضعيين متهماً إياهم بانهم "تفاوضيون" و"خونة للثورة"([3]).
أهم مؤلفاته: "النقد الاجتماعي"، صدر سنة 1886 إثر وفاته في أول يناير 1881، وله عديد المقالات منها: "الأبديّة والكواكب"، و"الجيش المستعبد"، "الوطن في خطر" "دفاع عن المواطن"....
دافيد فريدريك شتراوس (1808 - 1874):
"عالم عقيدة، وفيلسوف، وكاتب سِيَرْ، وثيولوجي بروتستانتي ألماني صَدَمَ أوروبا المسيحية بتصويره يسوع التاريخي ونفيه طبيعته الإلهية، ارتبط عمله بمدرسة "توبنغن" التي أحدثت ثورة في دراسة العهد الجديد والمسيحية المبكرة والأديان القديمة.
كان لكتاب شتراوس "حياة يسوع" تأثيراً هائلاً وضجة كبيرة، فعلى الرغم من عدم إنكار وجود يسوع، جادل شتراوس، بأن المعجزات في العهد الجديد، كانت إضافات أسطورية، مع القليل من أساسها بشكل حقائق مؤكدة، وبعد تحليل "الكتاب المقدس" من ناحية الترابط المنطقي الذاتي وإعارة الانتباه للعديد من التناقضات، خَلَصَ إلى أن قصص المعجزات لم تكن أحداثًا حقيقية، ووفقًا لشتراوس، طورت الكنيسة الأولى هذه القصص من أجل تقديم يسوع بوصفه المسيح للنبوءات اليهودية.
في عام 1840، نشر "شتراوس" كتابه عن العقيدة المسيحية في مجلدين، وكان المبدأ الرئيسي لهذا العمل الجديد هو أن تاريخ المذاهب المسيحية كان في الأساس تاريخ تفككها، كان ديفيد شتراوس أول من طرح السؤال حول شخصية يسوع التاريخية وفتح الطريق لفصل يسوع عن الإيمان المسيحي.
كَتَبَ سلسلة من أعمال السير الذاتية، والتي ضمنت له مقعدًا دائمًا في الأدب الألماني، وفي عام 1870 نَشَر محاضراته عن فولتير.
أنتجت أعماله الأخيرة، "الإيمان القديم والجديد" 1872، "ضجة كبيرة تقريبًا مثل "حياة يسوع"، وحتى بين أصدقاء شتراوس، الذين تساءلوا عن وجهة نظره من جانب واحد للمسيحية وتخليه المزعوم عن الفلسفة الروحية لمادية العلم الحديث، انتقد نيتشه بشدة في كتابه الأول "تأملات في غير وقتها"([4]).
"أعتبر شتراوس أن قصة السيد المسيح بميلاده المعجزي وطفولته ومعجزاته وقيامته وصعوده، ما هي إلاَّ أسطورة ظهرت في القرن الثاني الميلادي بقصد إعلاء المسيح، وتصويره في صورة المسيا الذي تنبأ عنه العهد القديم، وبالرغم من أن المجتمع رفض أفكار شتراوس وحُرم من الوظائف اللاهوتية، لكن كان له تأثيره البالغ على مدرسة النقد الأعلى.
كان من أكثر مؤيدي شتراوس " برونو باور" (1809 - 1882) تلميذ هيجل، والذي ادَّعى أن شتراوس قام بالخطوة الأولى نحو الفهم العلمي للإنجيل، كما قال أن المعجزات التي سجلتها الأناجيل لم تكن أساطير وإبداعات عفوية، إنما وُضعت من قِبل المسيحيين عن وعي وقصد، وقال " باور " أن شخصية المسيح لا وجود لها في التاريخ، لأنها شخصية وهمية، ودعى باور إلى فصل الكنيسة عن الدولة، وأن التحرُّر من الدين هو مقدمة للتحرُّر الاجتماعي"([5]).
وفي هذا السياق، يقول محمد رصاص: "من دون كتابَيْ ديفيد شتراوس ولودفيغ فويرباخ "حياة المسيح" (1835) و"جوهر المسيحية" (1841) ما كان للماركسية أن تُولَد، فقد حطّم شتراوس وفويرباخ أسس إلحاد القرن الثامن عشر الموجود عند المادية الميكانيكية الفرنسية، والتي كانت تتناول الدين من منطلقات ومساطر "العلم" و"المحسوس" و"المنطق"، حيث اعتبر شتراوس أنّ "الله" فكرة، يجب تناولها بوصفها تمثل كائناً حَمَلَهُ البشر في تاريخ مُعَيَّن، وبالتالي لا تجب دراسته ماورائياً، بل عبر دراسته كمحمول بشري لفكرة كائن ما وراء طبيعي، أيضاً، قال شتراوس بأن الأساطير والمعجزات لا تعالج علمياً أو من خلال المنطق ولا من خلال الشك الفلسفي، فهي ليست قصصاً للوعي، أو مبالغات لحوادث واقعية، بل هي رموز تخيلية لا تعبّر عن وقائع بل عن حالة الذهن البشري في مرحلة تاريخية محددة"([6]).
بعبارة أخرى –كما يضيف محمد رصاص- "شتراوس يرى الدين، كحالة تاريخية، يجب معالجته، كفكرة ماورائية، من خلال وظيفيته الاجتماعية عند حوامله البشريين في مكان وزمان معينين، وبالتالي فإن الأفكار لا تعالج بذاتها، ولا من منطلق هيغل بوصف الفكرة منطلقاً للواقع، بل بالعكس: الواقع هو منطلق الفكرة، أي الواقع الملموس والطبيعة كمبدأ أول وليس الفكر"([7]).
من هذا المنطلق، "لم يعالج شتراوس معجزات يسوع من خلال المنطق العلمي أو العقل أوباعتبارها حصلت فعلاً في الواقع التاريخي (أم لا)، بل بإعتبارها أساطير "تعبر عن التجارب الدينية، والأفكار الفلسفية، وحتى الحقائق التاريخية، في شكل ملموس هو أكثر تناسباً مع العادات الذهنية للعصر الذي ولدت تلك الأساطير فيه". وبالتالي فإن "الولادة المافوق طبيعية للمسيح، معجزاته، قيامته، وصعوده، تبقى حقائق داخلية في نفوس المؤمنين بها، حتى ولو حامت الشكوك حول صحتها كحقائق تاريخية""([8]).
ديفيد ستراوس"يرى أنه ينبغي ألا نفسّر قِصص العهد الجديد عن المسيح حرفيًّا وظاهريًّا على أنها حقائق تاريخيّة، ولكن يجب تأويلها على أنّها – مثلاً- رداء رمزيّ للحياة الدينيّة ليسوع المعلم اليهوديّ.
رأى شتراوس أن الإمبراطورية الرومانية عالمية وساهمت في صوغ دين يسوع الروحي الذي تخطى القبيلة والأمة"([9]).
تشارلز داروين (1809 – 1882):
هو سليل أسرة بريطانية معروفة، أسهمت إسهاماً كبيراً في ميداني الطب والعلم الطبيعي، والده الدكتور روبرت وارنج داروين، وكان جده "ارازموس داروين" عالماً ومؤلفاً بدوره، وداروين نفسه درس أول ما درس الطب، ثم اللاهوت، وأخيراً العلم الطبيعي، لكنه اشتُهِرَ بأنه عالِم تاريخ طبيعي وجيولوجي بريطاني.
أما التحول الكبير في أفكاره فقد حدث عندما أبحر، وهو بعد عالم ناشئ (في عام 1831)، في سفينة بحث البيغل (Beagle) في رحلة دامت خمس سنوات، وجعلت منه هذه الرحله عالماً بارزاً.
وفي عام 1859 أكمل داروين كتابه "أصل الأنواع" عن طريق الانتقاء الطبيعي أو حفظ الأعراق المفضلة في الصراع من أجل الحياة، وقد أشعل الكتاب جدلاً قوياً، واختار داروين عدم المشاركة فيه إذ بقي بعيداً، وظل إلى النهاية مكرساً نفسه لدراسات أوسع للنبات والحيوان.
وفي عام 1881 نشر كتاباً عن أهمية دودة الأرض للتربة. أما كتاباته الأخرى فقد شملت أصل الإنسان والانتقاء في علاقته بالجنس (1871)، وتعبير عن العواطف في الإنسان والحيوانات (1872).
اكتسب داروين شهرته كمؤسس لنظرية التطور والتي تنص على أن كل الكائنات الحية على مر الزمان تنحدر من أسلاف مشتركة، وقام باقتراح نظرية تتضمن "أن هذه الأنماط المتفرعة من عملية التطور ناتجة لعملية وصفها بالانتقاء (الانتخاب) الطبيعي، وكذلك الصراع من أجل البقاء له نفس تأثير الاختيار الصناعي المساهم في التكاثر الانتقائي للكائنات الحية".
أما نظرة "داروين" الفلسفية، فقد "كانت نظرة مادية بصورة كلية، فقد كان مفكراً جدلياً ملحداً"([10]).
ومن خلال ملاحظاته للأحياء قام داروين بدراسة التحول في الكائنات الحية عن طريق الطفرات وطوّر نظريته الشهيرة في الانتخاب الطبيعي عام 1838 م. ومع إداركه لردّة الفعل التي يمكن أن تُحدثها هذه النظرية، لم يصرّح داروين بنظريته في البداية إلا إلى أصدقائه المقربين، في حين تابع أبحاثه، ليحضّر نفسه للإجابة على الاعتراضات التي كان يتوقعها على نظريته، التي واجهت انتقاد كبير وخصوصاً من رجال الدين في جميع أنحاء العالم"([11]).
لقد أدت نظرية التطور الداروينية إلى "انهيار فكرة ثبات الأنواع الحية، وثبات الأعراق البشرية المعروفة لصالح الأصل المشترك لأشكال الحياة كلها مهما كانت، ولصالح الأصل المشترك للاعراق البشرية جميعاً إينما كانت، بعبارة أخرى، كما أن النظام الشمسي لم يعد نسقاً متكرراً من الحركات الأزلية التي لا تتبدل أو تتحول ليصبح نتاجاً لصيرورة فيزيقية انبعثت من كتلة سديمية أصلية واحدة، كذلك فإن أشكال الحياة لم تعد أنواعاً ثابتة خارج الزمان وأصنافاً مستقرة على حالها منذ بداية الخليقة لتصبح بدورها نتاجاً لصيرورة التطور الحيوي الموحدة المنبثقة من أصل واحد"([12]).
كيف يحدث الانتخاب الطبيعي: إن التبدلات الطارئة، يكون بعضها ضاراً، وبعضها الآخر مفيداً في الصراع من اجل الحياة، إذ أن الحيوانات التي تطرأ عليها تبدلات مفيدة، هي وحدها التي يقيض لها أن تبقى على قيد الحياة: وذلك هو مبدأ بقاء الأصلح، ولازمته الطبيعية هي التكوين المتصل لأنواع جديدة تتسم بقدرات جديدة على التكيف: ذلك هو الأصل الحقيقي للأنواع التي لا يستثنى منها في هذا المجال النوع البشري([13]).
ويرى داروين أن القسمات المميزة للإنسان، والتطور العقلي، والملكات المعنوية، والدين بالذات، هي تبدلات نافعة بيولوجياً، وهذا ما يصونها، وكان من نتيجة نظرية داروين، وتطبيقها على الوظائف العقليه والأخلاقية والاجتماعية، أن تغيَّر مفهوم الإنسان من حيث النشأة والوجود.
الانتقاء الطبيعي وأصل الإنسان:
كانت النظرة التقليدية إلى الأنواع البيولوجية تعتبرها ثابتة، وكل نوع (مثل حصان، بقرة.. إلخ) له أشكال ووظائف محددة وثابتة، ويمكن التعرف إلى هذه النظرة عند أرسطو، وعند الذين يؤمنون أن الأنواع مخلوقات الله مباشرة، فكل نوع له طبيعة لا تتغير، وبما أن الإنسان أحد الأنواع، والإنسان بوصفه نوعاً فهو لا يتغير.
"كانت حجة الداروينية مختلفة، فالحياة العضوية تخضع للتطور، أي: تُخلَقْ الأنواع المختلفة وتتشكل عبر تفاعل مع البيئة، وهكذا فإن جميع الأنواع تُخْلَق عبر سلسلة من التطورات، لذا فهناك علاقة أسروية بين الأنواع، ومن هذا المنظور يبدو أن لا وجود لنوع، وحتى النوع البشري، له وضعية فريدة، حتى ولو كانت هناك فروق مهمة بين الأنواع، من خلال صراع البقاء، وعلى مر الزمن والأفراد يتمتعون بصفات تكون أكثر ملاءمة مع البيئة هم الذين سيبقون، فالذين يكونون بصفاتهم الوراثية أكثر تلاؤماً، سيكونون الرابحين البيولوجيين، وسوف ينقلون هذه الصفات إلى ذريتهم، بهذا المعنى نقول بوجود انتقاء طبيعي، وبفضل الصراع على البقاء، هناك في المدى الطويل انتقال جيني أقوى، نسبياً، للمزايا الوراثية التي تسمح للفرد بأن يتكيف تكيفاً أفضل مع البيئة من تكيف الأفراد ذوي الصفات الأقل نفعاً من النوع ذاته"([14]). وعلى كل حال، هناك مسألتان في نظرية الانتقاء الطبيعي الداروينية وهما: مسألة كيفية الانتقال الجيني للصفات، ومسألة كيفية نشوء صفات وراثية جديدة:
المسألة الأولى شرحتها قوانين الوراثة عند "ميندل"، والثانية تم شرحها بتصور التغير الأساسي، أي تغيرات مفاجئة، وثابتة نسبياً في المادة الجينية، فقد كان التحدي الكبير للمذهب الدارويني متمثلاً في مفهومه للإنسان المفيد أنه نوع من بين الأنواع خَلَقَهُ الانتقاء الطبيعي، ولا ريب في أن للكائنات الإنسانية جميع الخصائص التي نعتبرها خصائص إنسانية، وإن في ذلك ما يميز الإنسان عن الأنواع الأخرى، والداروينية تقدم نظرة تبدو معها جميع تلك الخصائص نتيجة عملية تكيف آلياتها التحتية هي ذاتها عند جميع العضويات، وبصورة أساسية.
حصل نقاش عنيف، "حول السؤال: هل نحن من نسل القرود؟ لكن داروين لم يقترح مثل هذا النسل المباشر، كل ما قاله هو إن القرود والإنسان لهما سلف مشترك، وإن الإنسان نشأ نتيجة الانتقاء الطبيعي، وفي زمن طويل، وكان نشوؤه مشابهاً بشكل أساسي لنشوء الأنواع الأخرى جميعها.
هل تهدد هذه النظرية العلمية مفهومنا الثقافي للإنسان؟ تبدو الداروينية من منظور اللاهوت المسيحي التقليدي بمثابة إشكالية، هذا إذا أصرينا على تأويل حرفي للكتاب المقدس"([15]).
أخيراً، إن دعم العديد من الجامعات والمراكز العلمية، "يعطينا الحق في النظر إلى نظرية النشوء على أنها ذات أساس علمي حسن، على الرغم من أنها ليست معصومة من الخطأ ومفتوحة للتأويل، أما مذهب الخَلْق المستقل، فليس له مثل هذا النظام من الدعم المتسق، القول إن الله خلق الأنواع لا يعزز بحثاً علمياً مثمراً، فهو جواب من نوع آخر، وبشكل غير دقيق يمكننا القول إن العلوم الطبيعية تقوم على أسباب طبيعية، لا فوق طبيعية، على الرغم من أن الحتمية السببية في النظرية التطورية تظل محتاجة إلى الشرح، فالذين يعتبرون الله سبباً ليسوا بالباحثين العلميين، لكنهم قد يكونون فلاسفة طبيعيين"([16]).
إن النقاش الذي تبع ظهور الداروينية لم ينته سواء أكان على المستوى الإبستيمولوجي أو في النقاش العام حول الاخلاق، وحول مفهومنا للطبيعة الإنسانية"([17]).
توفي "داروين" عام 1882، "وتقديراً لتفوقه كعالم كُرِّم بجنازة رسمية، وتم دفنه في كنيسة وستمنستر بالقرب من جون هرشل وإسحاق نيوتن، وقد وُصِفَ دارون كواحد من أكثر الشخصيات المؤثرة في العالم"([18]).
برونو باور (1809 – 1882 م):
فيلسوف ومؤرخ وناقد ألماني، كان ممثل الجناح الهيغلي اليساري، لكنه "افترق عن الاشتراكيين، وعارض الأفكار الليبرالية لثورة 1789 بمذهب في التحرر الداخلي للأنا، طالب بفصل الكنيسة عن الدولة، وتطلع إلى تأسيس ما سماه بـ"ديانة الانسان" يدين "برونو باور" بشهرته، إلى حد ما، للنقد الذي وجهه إليه ماركس في الأسرة المقدسة أو نقد النقد ضد برونو باوروشركائه، وفي المسألة اليهودية، وفي الإيديولوجيا الألمانية"([19]).
ان حرية العقل وتحقيق استقلاليته –عند برونو باور- هي مكتسب إنساني مُؤَسس على جدل المعرفة والنقد، فكما حرر إبن رشد الإنسان من دوجما علم الكلام، عبر البرهان والتأويل –كما تقول د. فريـال حسن خليفة- فإن برونو باور ساهم في تحرير الوعي من التحجر، "وكان بذلك متوافقاً مع ماركس الذي حرر الإنسان من كل دوجما في الواقع، وطريقه إلى ذلك الجدل المادي والثورة الجذرية الاجتماعية الشاملة".
من مؤلفاته "في النقد التاريخي للمسيحية"، و"نقد الوقائع المتضمنة في انجيل يوحنا" (1840)، "نقد التاريخ الانجيلي" (1841)، "المسيحية مهتوكة الستر" (1843).
([1])غنارسكيربك و نلز غيلجي– مرجع سبق ذكره - تاريخ الفكر الغربي - ص 809
([2]) المرجع نفسه - ص 811
([3]) جورج طرابيشي – مرجع سبق ذكره – معجم الفلاسفة – ص 185
([4]) موقع ويكيبيديا - الموسوعة الحرة- الانترنت
([5]) حلمي القمص يعقوب– كتاب النقد الكتابي: مدارس النقد والتشكيك والرد عليها (العقد القديم من الكتاب المقدس) – موقع: لنا في موقع الأنبا تكلا هيمانوت -
([6]) محمد سيد رصاص – سطحية الإلحاد العربي الحديث والمعاصر – الحوار المتمدن – 17/12/2015.
([7]) المرجع نفسه.
([8]) محمد سيد رصاص – من أجل نظرة ماركسية وعلمانية عربية جديدة للدين – موقع الجولان – 14/9/2009.
([9]) عبده طلبة – من تاريخ الإلحاد (2/2) – موقع: ساسة بوست – 27 نوفمبر 2014.
([10]) لجنة من العلماء والاكاديميين السوفياتيين – مرجع سبق ذكره – الموسوعة الفلسفية – ص192
([11])غنارسكيربك و نلز غيلجي – مرجع سبق ذكره - تاريخ الفكر الغربي - ص717
([12])د. صادق جلال العظم – دفاعاً عن المادية والتاريخ – دار الفكر الجديد – بيروت – الطبعة الأولى 1990 –ص 141
([13]) اميل برهييه – تاريخ الفلسفة – الجزء السابع: الفلسفة الحديثة 1850 - 1945 – ترجمة: جورج طرابيشي – دار الطليعة – بيروت- الطبعة الأولى – آب (اغسطس) 1987– ص21
([14])غنارسكيربك و نلز غيلجي– مرجع سبق ذكره - تاريخ الفكر الغربي - ص 719
([15]) المرجع نفسه - ص 721
([16]) المرجع نفسه - ص 725
([17]) المرجع نفسه - ص 727
([18]) موقع ويكيبيديا – الانترنت .
([19]) جورج طرابيشي – مرجع سبق ذكره – معجم الفلاسفة – ص 150