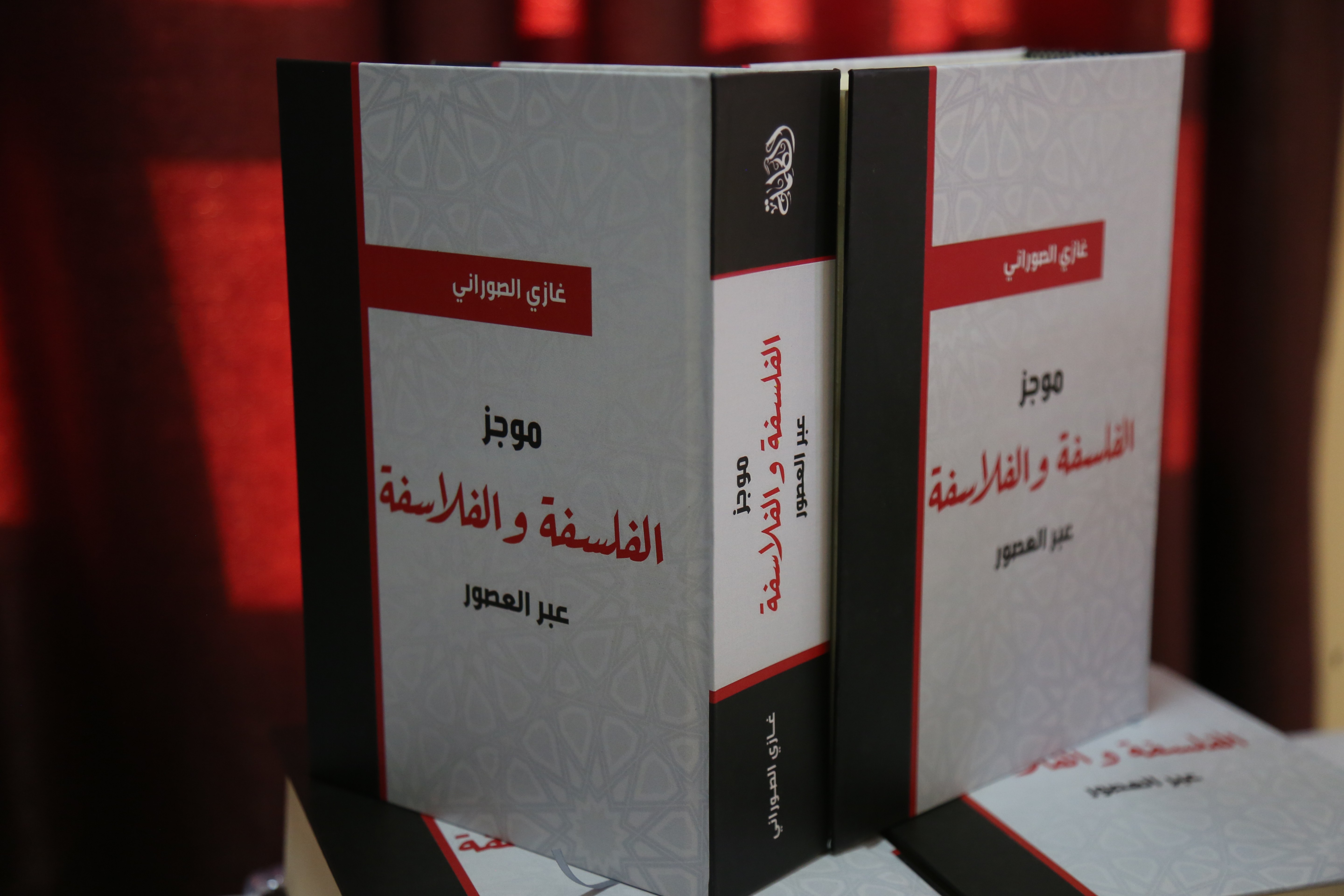(تنفرد بوابة الهدف، بنشر كتاب المفكر غازي الصوراني، المعنون: موجز الفلسفة والفلاسفة عبر العصور، الصادر عن دار الكلمة للنشر والتوزيع، في يونيو/ حزيران 2020، على حلقات متتابعة.. قراءة مثمرة ومفيدة نتمناها لكم).
الباب الرابع
الفصل الحادي عشر
الفلسفة في القرن العشرين
نظرة على فلسفة القرن العشرين:
أولاً: الوضعية المنطقية ([1])
نشأت في العشرينات من القرن العشرين من خلال "جماعة فينا" -الفلسفية- التي كان أبرز مفكريها "رودولف كارنابس" وفي أوائل الثلاثينات، انتشرت الفلسفة "الوضعية المنطقية" كأساس أيديولوجي "للفلسفة العلمية" للوضعية الجديدة، وكانت الولايات المتحدة معقلها الرئيسي في أواخر الثلاثينات.
تتخذ "الوضعية المنطقية" تراثها من فلسفة "ارنست ماخ" ومن التراث المثالي الذاتي بوجه عام، لدى "بيركلي" و "هيوم".
تقول "الوضعية المنطقة" أنه لا يمكن قيام فلسفة علمية إلا بواسطة التحليل المنطقي للعلم، ووظيفة هذا التحليل هي: التخلص من "الميتافيزيقا" ومن الفلسفة بمعناها التقليدي، لكن الجوهر المثالي الذاتي للوضعية المنطقية يلغي زعمها بانها "فلسفة العلم"، ومع ذلك فإن بعض ممثلي هذه الفلسفة (كونت وسبنسر وغيرهما) قد حققوا نتائج قيمة في مجال البحث المنطقي.
يمكن النظر إلى الوضعية المنطقية أو التجريبية – الحسية المنقطية، كما تدعي أحياناً، على أنها متحدرة من التجريبية – الحسية البريطانية (لوك وبيركلي وهيوم) وفلسفة عصر التنوير، كما يمكن النظر إليها في الوقت ذاته على أنها استجابة للإنجازات الجديدة التي حققها علم الفيزياء الحديث (إينشتاين) والمنطق الجديد، وأخيراً يمكن النظر إليها على أنها رد فعل على صعود الأيديولوجيات الكلية واللاعقلية في العشرينيات (1920) والثلاثينيات (1930) من القرن العشرين، وبخاصة النازية في ألمانيا.
واليوم، لا يوجد سوى نفر قليل يمكن أن يعتنق الوضعية المنطقية كموقف، وبشكلها الأرثوذوكسي، غير أن هذه المدرسة أدت دوراً مهماً عن طريق تأكيدها الأهمية الأساسية للإجراءات المتزنة والحجاجية في الفلسفة، وفي العمل الفكري عموماً، ونقدها للإبهام الفكري والبلاغة المضللة، وبهذه الطريقة كان للوضعية المنطقية تأثير تثقيفي مهم، على الرغم من النقد الذي راح يوجه تدريجياً ضد بعض من مزاعمها الفلسفية الأساسية – وهو النقد الذي صيغ حتى من مناصريها أنفسهم.
لقد تطورت الوضعية المنطقية بعد الحرب العالمية الثانية، لتتخذ شكلين من أشكال فلسفة العلم بتأكيد إما المنطق واللغة الصورية، أو تحليل التصورات (كما هو الحال عند "فتغنشتاين" والفلسفة التحليلية).
"انطلقت التجريبية – الحسية الكلاسيكية البريطانية، منذ لوك إلى هيوم، من الحواس، لذا، فإن تلك التجريبية – الحسية قامت على البسيكولوجيا، وبخلاف التجريبية – الحسية البريطانية، أُشيدت الوضعية المنطقية على علوم اللغة. وكانت معنية بالدرجة الأولى بالمسائل المنهجية، المتعلقة بكيفية إثبات المعرفة، وكيفية صياغة أقوالنا عن الواقع، وكيف تُعَزَّز الآراء أو تَضْعُفْ عند حَكِّها بالتجربة، وبهذا المعنى، يمكننا أن نتكلم على مُرَكَّبْ مؤلف من التجريبية – الحسية الكلاسيكية، والمنهجية الحديثة والمنطق، وتكون النتيجة تجريبية – حسية منطقية، لذا، فإن هذه الفلسفة، تلجأ إلى البنية المنطقية للغة (تركيب الكلمات في جمل)، وإلى التحقق المنهجي، فَيَدُلَّ اسمها "التجريبية الحسية المنطقية" على ذلك التحول من البسيكولوجيا إلى اللغة والمنهجية"([2]).
يوظف التجريبيون العقل– كما تقول أماني أبو رحمة- "بصورة آلاتية ذرائعية، في حين أنه بالنسبة للعقلانيين هو مصدر المعرفة، ومع ذلك، فإن ما لدينا هنا هو الفجوة بين الأُسسية العقلانية (ديكارت، سبينوزا، ليبنتز)، والأُسسية التجريبية (لوك، هيوم، بيركلي)، الأمر الذي أدى إلى مناقشات حادة بلغت ذروتها في فلسفة عمانوئيل كانط، حيث تتضح مساهمته الأساسية في دمج الأُسسية العقلانية والتجريبية، وقد مَثَّلَ فكر كانط في الابستومولوجيا لحظة ثورية في تاريخ الفكر الغربي، فقد أعلى كانط حالة الشخص المفكر من خلال إظهار دوره الفاعل في تكوين المعنى، فالحدس والإدراك الحسي يعملان معا في تكوين المعنى، وتبعا لذلك فانه يمكن القول أن نظرية كانط في الإدراك المعرفي كانت لإظهار أن المعرفة هي نتاج عمليات موحدة من الملكات والبديهيات (الكائنات المدركة) والمفاهيم (ابتكارات العملية العقلية)، بهذه الطريقة، تَمَكَّن كانط من أن يُظْهِر أوجه التكامل بين الرؤى التجريبية والعقلانية"([3]).
في الوضعية المنطقية لابد من تحقق شرطين قبل أن يمكن لجملة، التعبير عن معرفة، وهما:
1. يجب أن تكون الجُملة ذات صياغة جيدة، أي يجب أن تكون صحيحة من ناحية قواعد اللغة (منطقياً). 2. يجب أن تكون الجملة قابلة للاختبار التجريبي، أي للتحقق.
والجُمَلْ التي لا يتوفر فيها هذان الشرطان، لا تعبر عن معرفة، فهي جُمَلْ عديمة المعنى معرفياً (إبستيمولوجياً). أما الجُمَلْ الأخلاقية والدينية والميتافيزيقية، مثل: "لا تقتل" "والله محبة" و"الجوهر واحد" – فهي جُمَلْ لا معنى لها من الوجهة المعرفية طبقاً لتلك المعايير الوضعية للمعنى المعرفي، وهي جُمَلْ لا تعبر عن معرفة. أما إمكانية أن يكون لمثل تلك الجُمَل معنى عاطفي فمسألة لا ينكرها أتباع ذلك المذهب، فغالباً ما يكون للجُمَلْ التي تعبر عن قِيَم، مثلاً، معنى كبير عند الفرد كما عند المجتمع، والنقطة الرئيسية، بحسب تلك الأطروحة، هي أن تلك الجُمَل لا تمثل معرفة.
باختصار، يمكننا أن نُجْمِل الوضعية المنطقية بما يلي: لا يوجد سوى نوعين من الجُمَل ذات المعنى المعرفي، وهي الجُمَل التحليلية، والجُمَل التركيبية، التي تكون مصاغة بشكل جيد بعد التجربة، وبكلام آخر نقول، إن الجُمَل ذات المعنى الإبستيمولوجي، هي جمل العلوم الصورية (المنطق والرياضيات)، والجُمَل القابلة للتحقيق التجريبي. وببساطة نقول إن ذلك كان جوهر الوضعية المنطقية في فترة ما بين الحربين العالميتين في أوساط حلقة فيينا، حيث كان التمييز هنا بين الجُمَل ذات المعنى المعرفي، والجُمَل عديمة المعنى المعرفي، بين المعرفة الحقيقية والمعرفة الزائفة، مُعَرَّفاً بالتمييز بين الجُمَل التي يمكن التحقق منها والجُمَل التي لا يمكن التحقق منها، وهذا التمييز يطابق التمييز بين العلم والعلم الزائف. ومثلها مثل أشكال التجريبية – الحسية الأخرى، كانت الوضعية المنطقية رد فعل ضد المذهب العقلي، نعني ضد الجُمَل التي تَدَّعي أنها تقدم رؤية صادقة لكنها لا تفي بمتطلبات الاختبار الشاملة: الملاحظة والبحث القائم على منهج الفرضية والاستنباط، لذلك فإن اللاهوت والميتافيزيقا الكلاسيكية (مثل الأنطولوجيا([4])) مرفوضان بداعي أنهما عديما المعنى معرفياً" ([5]).
الوضعية الجديدة:
منذ بداية ظهورها جاءت الوضعية الجديدة ("الذرية المنطقية"، "الوضعية المنطقية"، "التجريبية المنطقية"، "التحليل المنطقي"، وغيرها) تياراً فلسفياً عالمياً، يتقاطع مع "المثالية الذاتية"، وقد لعبت مؤلفات عالم المنطق والرياضيات، الفيلسوف الانكليزي برتراند راسل، والعالم والفيلسوف النمساوي فيتجنشتين، لعبت دوراً كبيراً في ظهور هذه الفلسفة([6]).
كان وضعيو الجيل الأول (كونت، سبنسر) يرون أن المسألة الأساسية في الفلسفة، كغيرها من المشكلات الجذرية، ستبقى، إلى الأبد، دونما حل، وذلك لضعف العقل البشري وقصوره ومحدوديته.
وجاء الوضعيون الجدد ليتخذوا موقفاً أكثر جذرية من أسلافهم؛ فالمسألة الأساسية في الفلسفة، وجميع المشكلات العامة، التي كانت تعتبر سابقاً قضايا فلسفية، ليست، في نظرهم، إلا مسائل وهمية، كاذبة، مزيفة، ينبغي عدم إضاعة الوقت في التفتيش عن حل لها، وطرحها جانبا باعتبارها عقيمة علمياً.
يزعم الوضعيون الجدد أن معرفتنا عن العالم تأتي عن طريق العلوم التجريبية وحدها، فليس بامكان الفلسفة أن تزيد شيئاً عما تقوله العلوم الخاصة، كما أنها عاجزة عن تقديم تصور شامل عن الكون.
إن مهمة الفلسفة عندهم، تنحصر في التحليل المنطقي لمبادئ وأحكام العلم والحس السليم، التي من خلالها نصوغ معرفتنا عن العالم، حيث اقتصرت مهمة الفلسفة على التحليل المنطقي، معتمدين في ذلك على منجزات علم المنطق الرياضي المعاصر، وكان "برتراند راسل" من رواد هذه الفلسفة القائمة على تحليل الأسس المنطقية للرياضيات، ومن ثم ظهور علم "المنطق الرياضي" الذي أسسه "راسل" في اطار منهج التحليل المنطقي الذي يساعد على حل المسائل الفلسفيه، وبالتالي اعتبار المنطق هو لب الفلسفة" ([7]).
ثم قام فيتجنشتين، تلميذ راسل، بإعطاء معنى أدق لهذه العبارة حيث يؤكد، في "رسالة منطقية – فلسفية" (1921)، "أن الفلسفة ليست نظرية Theory، وإنما هي فعالية"، وهذه الفعالية تكمن في "نقد اللغة"، أي في التحليل المنطقي لها، إذ إن المسائل الفلسفية التقليدية تعود، في نظر فيتجنشتين، إلى الاستعمال غير الصحيح للغة، واقتفى فيتجنشتين أثر استاذه في القول بامكانية وضع لغة كاملة، تنص عباراتها إما على أحكام بخصوص الوقائع (العلوم التجريبية)، أو على تحصيل حاصل، كما في المنطق والرياضيات"([8]).
"بانتقال الوضعيين الجدد لتحليل معاني الكلمات والرموز،أَدخلوا في دائرة اهتمامهم عدداً من المسائل اللغوية والنفسية، كانت لها أهمية علمية وتطبيقية كبيرة (في صناعة الآلات الحاسية، مثلا).
واتخذت أعمالهم، احياناً، طابع الدراسة المتخصصة في مجالات اللغة والمنطق، وما إليها .. وعلى تربة القضايا السيمانتية برزت اتجاهات ومدارس، تنظر من مواقع مختلفة إلى مسألة تحليل اللغة كحامل للمعنى، وكوسيلة للاتصال بالآخرين، وقد أصر ممثلو هذه التيارات كلها على أن أعمالهم لا تمت بصلة إلى الفلسفة، وأنها بعيدة جداً عن صراع الاتجاهات الفلسفية، لكن هذه الآراء جميعاً، لم تخرج، في الواقع، عن اطار الفهم المثالي – الذاتي للقضايا الفلسفية الاساسية"([9]).
إن أحداً لاينكر أهمية التحليل المنطقي للغة، ولا سيما لغة العلم، لكن هذه المهمة هي واحدة من مهام الفلسفة، بين مهام أكثر شمولية وأهمية، فالفلسفة ماكانت، ولن تكون، منطق العلم، بقدر ما هي رؤية للعالم، مبنية على فهم معين للعلاقة المتبادلة بني المادة والوعي"([10]).
إن الوضعيين الجدد، "ينادون بطرد "الميتافيزيقا" قاصدين من وراء ذلك، وقبل كل شيء، رفض إقرار الفلاسفة الماديين بالوجود الموضوعي للعالم المادي، وانعكاسه في وعي الانسان، وهم يعلنون أن فلسفتهم ليست بالمادية، ولا بالمثالية، وإنما هي "اتجاه ثالث" في الفلسفة، لكن فلسفتهم معادية في جوهرها، للنزعة المادية، فهي لا تُصَرِّح علناً بنفي الوجود الموضوعي للعالم الخارجي، لكنها تَعْتَبِر أن أي سؤال "ميتافيزيقي" عن وجود هذا العالم، عن الطابع الموضوعي للظواهر التجريبية، هو مسألة مزيفة"([11]).
الوجودية، هي مدرسة فلسفية، بدأت فعلاً وعملياً مع الفيلسوف كيركجورد، الذي وضع أسسها، وأشاد قواعدها،لكن الفلسفة الوجودية ليست نسقاً واحداً، فهي تتوزع على اتجاهين اساسيين: 1- الوجودية المؤمنة –كيركيجارد. 2- الوجودوية الملحدة – جان بول سارتر.
أهم سمات الفلسفة الوجودية المشتركة بين الاتجاهين:
- النزعة الفردية، فالوجودية تبدأ من الانسان لا من الطبيعة.
- الوجودية تقول بأسبقية الوجود على الماهية، بعكس بقية الفلاسفة المثاليين والنظم والافكار الدينية.
"تشكل الفلسفة الوجودية الحديثة أحد أكثر تيارات الفلسفة البرجوازية في القرن العشرين انتشاراً، ظهرت في مرحلة، دخلت فيها الرأسمالية أزمتها العامة، حين جاءت لتعبر أصدق تعبير عن روح التشاؤم والسقوط، التي تسود الأيديولجوية البرجوازية، ومن أعلام هذه الفلسفة: مارتن هايدجر، وكارل ياسبرز– في ألمانيا، جبرايل مارسيل، وجان بول سارتر، وألبرت كامو – في فرنسا، أبانيانو– في ايطاليا، باريت – في الولايات المتحدة، وقد جاءت الفلسفة الوجودية وريثاً شرعياً لأفكار برجسون ونيتشه، واستعارت منهجها من فينومينولوجيا هوسرل، وأخذت أفكارها الأساسية من تعاليم المفكر الدانماركي كيركيجورد"([12]).
انتشرت الفلسفه الوجودية بصورة ملحوظة بعد الحرب العالمية الثانية، لتشمل العالم الرأسمالي بأسره، ويعود السبب في هذا إلى أن مفكري الوجودية طرحوا مسائل، لاقت صدى واسعاً في نفوس وقلوب جماهير عريضة من الناس عموماً، والمثقفين خصوصاً، وخاصة أولئك الضائعين في متاهات المجتمع البرجوازي وتناقضاته.
طرحت الفلسفة الوجودية، مجموعة من القضايا المتعلقة بمعنى الحياة الانسانية، ومصير الانسان، ومشكلات الاختيار، والمسئولية الذاتية، من موقع الفردية أو الذات الوجودية، في محاولة منها الإجابة على مسائل الحياة الإنسانية، فالوجوديون، ينطلقون من الفرد، الذات، ففي هذه الذات، تتركز اهتمامات الفرد ومصالحه، عن المسائل " الوجودية"، التي تشكل المضمون الوحيد لفلسفة الوجوديين، مسائل وجود الإنسان، ومحدودية هذا الوجود، وكذلك معاناة الذات لـ"أشكال الوجود" أو الحياة الإنسانية.
إن الوجود هو الموضوع الأساسي للفلسفة الوجودية، يقول هايدجر: "الوجود هو الشغل الشاغل للفلسفة، حاضرها وماضيها"، غاية الفلسفة – وجود الكائن"([13]).
وبما ان مفهوم "الوجود" واسع للغاية، لا يخضع للتعريف المنطقي، نرى الوجوديين يعلنونه "مفهوماً غير قابل للتحديد"، مستعصياً على أي تحليل منطقي، لكنهم بالمقابل يقولون ان هناك "شكل من الوجود، نعرفه جيداً، هو وجودنا الذاتي، لإن الإنسان يتميز عن سائر الاشياء الاخرى بانه يستطيع أن يقول: "أنا موجود"، والطريق إلى فهم الوجود، كما هو في ذاته، يمر عبر "وجودنا" الذاتي.
لقد "حاول هايدجر أن يطمئننا، بأن دراسة الوجود الانساني، ليست إلا بداية للبحث الانطولوجي، لكنه –وأتباعه جميعاً- لم يمضوا أبعد من هذه البداية، إن الوجودية فلسفة، يشكل "الوجود" البشري أو بعبارة أدق، معاناة هذا الوجود –والشعور بالقلق- مادتها الوحيدة"([14]).
بخلاف هايدجر، ينظر سارتر إلى جميع الاشياء – ماعدا الانسان- باعتبارها "وجوداً – في – ذاته"، أما الوجود الانساني، أو "الوجود – من أجل- ذاته"، الذي يجابه عالم "الوجود – في – ذاته"، فهو عدم.
سارتر إذن، أراد إعادة الاعتبار للإنسان، ليجعله مالكاً لوجوده ولنفسه ومصيره، وألا يكون عبداً للتصورات الغيبيه، فالإنسان هو مشروع وجود متجدد من خلال وعي ذاته، ووعي محيطه وحياته وتجاربه وخبراته، وكل هذه الأمور تجعل منه إنساناً متغيراً وفق إرادته، فالإنسان هو ما يصنعه بيديه ولا يخضع لماهية خارجيه محددة سلفاً، وهذا هو معنى حرية الانسان المطلقه، أي ان يكون حُراً أو أنه محكوم بالحرية، وتلك هي الوجودية، فوجود الانسان هو حريته، شاء أم أبى، حتى لو أراد غير ذلك، وهو يثبت وجوده عن طريق الفعل، فالفعل الانساني هو تجسيد للحرية الذاتية، وبالتالي فإن الإنسان –كما يقول سارتر- مسئول عن أفعاله سواء كان مؤمناً أو غير مؤمن، شجاعاً، كريماً، بخيلاً.. إلخ والمسئولية هنا هي إنعكاس لاختيار هذا الانسان أو ذاك.. ومن هنا قال سارتر: "إن الهزيمة التي تَعَرَّضَ لها الفرنسيين تحققت بسبب تقاعس الفرنسيين أنفسهم، وليست قدرا مكتوباً لا يمكن رده، بل يجب الخلاص منها عبر المقاومة ووعي الفرنسيين لدورهم في تحقيق النصر".
الوجودية بين الإيمان والإلحاد:
برز "في الوجودية تياران: مسيحي (كيركيجارد، ياسبرز، مارسيل، ..) وإلحادي (هايدجر، سارتر، .. ) لكن مؤلفات كلا التيارين، المسيحي والإلحادي، جاءت مُشَبَّعة بروح التشاؤم، فهي لا ترى في الحياة البشرية إلا سيلاً دافقاً من الأرق، والضياع، واللامعنى"([15]).
يرى كيركيجور أن الذعر، الذي يكشف عن محدودية الوجود البشري، يضع الإنسان أمام ضرورة اختيار موقف بالنسبة للموت، بالنسبة للعدم، في إمكانية مثل هذا الاخيتار تكمن، في رأيه، حرية الفرد.
حظيت مشكلة الحرية باهتمام كل مفكري الوجودية، "الحرية، في رأيهم، ليست ماهية ملازمة للإنسان، فحسب، بل هي جوهر وجوده، أيضاً. الانسان هو حريته، من هنا ينطلق كثير من الفلاسفة الوجوديين ليعلنوا أن آراءهم هذه عن الحرية تشكل دليلاً على الطابع الانساني لفلسفتهم، التي هي إرتقاء بالإنسان إلى أعلى".
إن أفكار الحرية، والاختيار الحر، والمسئولية، كانت قد لاقت صدى واسعاً في فرنسا، ولا سيما إبان الاحتلال النازي وبعده، لكن الوجودية، في طرحها لهذه المشكلات، لم تساعد الإنسان على إيجاد حل صحيح لها، بقدر مازادته ارتباكاً وتخبطاً. فالحرية، عند الوجوديين، أمر متعذر على التفسير، لا يُعَبَّر عنه بالمفاهيم، لاعقلاني، والوجوديون يعارضون الضرورة بالحرية، وينفون مشروطية الاختيار، الحرية عندهم، حرية خارج المجتمع، حرية الفرد المنطوي على ذاته، المنعزل عن الآخرين، إنها حالة باطنية، ومزاج نفسي، ومعاناة ذاتية، حرية، معزولة عن المجتمع، هي حرية بلا قيمة، ومبدأ شكلي فارغ، ونداء عقيم، لا جدوى منه.
إن الوجوديون لا يستطيعون، حتى ولا يحاولون، الكشف عن المضمون الحقيقي للحرية، إنهم يؤكدون على أن الإنسان يجب ان يختار مستقبله بحرية، لكنهم لا يشيرون إلى أية ركيزة، يعتمد عليها في هذا الاختيار، بذلك يبقى الإنسان دون أن يجد شيئاً يختاره؛ فما يمكن أن يختاره، ليس أفضل ولا أسوأ من غيره، ويبقى، في نهاية المطاف، اختياراً بلا مغزى([16]).
إن الوجودية تطرح جانباً المضمون الحقيقي التاريخي للحرية، ذلك أن مسألة الحرية، عندها، ليست مسألة تحرير البشر من قسوة الطبيعة، وظلم الطبقات الحاكمة، بل هي نصائح وارشادات، تهيب بالفرد أن يبحث عن حريته في أعماق "وجوده" الذاتي فقط.
في هذا الجانب، لا ينكر الوجوديون أن الإنسان لا يستطيع العيش إلا بين الناس الآخرين، إلا في المجتمع، لكن فهمهم لهذه الحقيقة يبقى فهماً فردياً متطرفاً، فالمجتمع، الذي يهيء الظروف لحياة أفراده، والذي فيه ينمو وعي الفرد وتتفتح شخصيته، ليس، في نظر الوجوديين، إلا قوة كلية، تضغط على الفرد، وتسلبه وجوده، وتجعله أسير أذواق وأخلاق ونظرات واعتقادات وعادات معينة.
إن أفكار الوجوديين هذه تعكس إلى حد بعيد حالة الفرد في المجتمع الرأسمالي، الذي يَظلِم الفرد ويضطهده، ويجرده من انسانيته، لكن الوجوديين يصححون سمات المجتمع البرجوازي هذه على الحياة الاجتماعية ككل، إنهم يحاولون تحويل احتجاج الإنسان على الظلم، الذي يعانيه في المجتمع البرجوازي، إلى احتجاج ضد المجتمع عموماً"([17]).
إن الوجودية، حين تنفي القيمة الكلية للمبادئ والقيم الأخلاقية، تنادي بالنسبية المتطرفة في الأخلاق، مما يحول الإنسان إلى طريدة، إلى كائن لا أخلاقي تماما؛ فكل شيء مباح، إن ظلال نيتشه الكئيبة ترتسم بوضوح فوق مؤلفات الوجوديين جميعاً.
صحيح أن بعض الوجوديين وقفوا ضد موجات الرجعية الامبريالية المتطرفة، وشاركوا في حركة أنصار السلم، ودعموا عدداً من المطالب التقدمية، بل إن الفيلسوف الفرنسي "سارتر" انحاز للماركسية، وهو صاحب العبارة الشهيرة "ان الفلسفة الماركسية لايمكن تجاوزها"، لكن الفلسفة الوجودية، تنطلق من اغتراب الفرد في المجتمع البرجوازي باعتباره مبدأ القياس ومعياراً لكل القيم" ([18]).
الإنسان عند الوجوديين([19]):
يؤمنون إيمانًا مطلقًا بالوجود الإنساني، ويتخذونه منطلقًا لكل فكرة، ويعتقدون بأن الإنسان أقدم شيء في الوجود، وما قبله كان عدمًا، وأن وجود الإنسان سابقٌ لماهيته، ويقولون: إنهم يعملون لإعادة الاعتبار الكلي للإنسان، ومراعاة تفكيره الشخصي، وحريته، وغرائزه، ومشاعره.
مفهوم الحرية:
يؤمن الوجوديون بحرية الإنسان المطلقة دون قيود، ويؤكدون على تفرد الإنسان باعتباره صاحب تفكير وحرية وإرادة واختيار ولا يحتاج إلى مُوَجِّه، وأن له أن يثبت وجوده كما يشاء، وبأي وجه يريد، دون أن يقيده شيء، وأنه على الإنسان أن يطرح الماضي وينكر كل القيود؛ دينية كانت أم اجتماعية أم فلسفية أم منطقية! ويقول المؤمنون منهم: إن الدِّين محله الضمير، أمَّا الحياة بما فيها فمقودة لإرادة الشخص المطلَقة.
تكرس الوجودية التركيز على مفهوم أن الإنسان كفرد يقوم بتكوين جوهر ومعنى لحياته. والإنسان هو من يختار ويقوم بتكوين معتقداته والمسؤولية الفردية خارجاً عن اي نظام مسبق.
الأفكار([20]):
- يؤمنون إيماناًمطلقاً بالوجود الإِنساني ويتخذونه منطلقاً لكل فكرة.
- يعتقدون بأن الإنسان أقدم شيء في الوجود وما قبله كان عدماً وأن وجود الإنسان سابق لماهيته.
- يعتقدون بأن الأديانوالنظريات الفلسفية التي سادت خلال القرون الوسطى والحديثة لم تحل مشكلة الإِنسان.
- يقولون إنهم يعملون لإِعادة الاعتبار الكلي للإنسان ومراعاة تفكيره الشخصي وحريته وغرائزه ومشاعره.
- يقولون بحرية الإنسان المطلقة وأن له أن يثبت وجوده كما يشاء وبأي وجه يريد دون أن يقيده شيء.
- يقولون إن على الإنسان أن يطرح الماضي وينكر كل القيود، دينية كانت أم اجتماعيةأم فلسفية أم منطقية.
الخصائص المشتركة بين الفلاسفة الوجوديين([21]):
أ) السمة المشتركة الرئيسية بين مختلف الفلسفات الوجودية في القرن العشرين تقوم في أنها جميعاً تتبع ابتداء من تجربة حية معاشة، تسمى تجربة وجودية، ومن الصعب تعريفها تعريفاً دقيقا، وهذه التجربة الوجودية تختلف بين فيلسوف وآخر من هؤلاء الوجوديين.
وهكذا، فإن تلك التجربة تأخذ في حالة ياسبرز، شكل إدراك هشاشة الوجود، وفي حالة هيدجر، شكل تجربة السير باتجاه الموت، وفي حالة سارتر، شكل تجربة الغثيان، ولا يخفي الوجوديون أبداً أن فلسفتهم نشأت من تجربة من هذاالقبيل، ومن هنا فإن الفلسفة الوجودية بصفة عامة، بما في ذلك عند هيدجر، تحمل طابعاً شخصياً بسبب هذه التجربة المعاشة.
ب) الموضوع الرئيسي للبحث الفلسفي عند الوجوديين هو ما يسمى "الوجود". ومن الصعب تعريف المعنى الذي يأخذ عليه الوجوديون تلك الكلمة، ولكنها تدل على كل حال، على الطريقة الخاصة بالإنسان في الوجود، ويرى الوجوديون أن الإنسان وحده هو الذي يحوز الوجود.
ت) يتصور الوجوديون الوجود على نحو فاعلي نشط، فلا يكون الوجود، وإنما هو يخلق نفسه بنفسه في الحرية، بعبارة أخرى هو "يصير".
ث) الفرق بين هذا الاتجاه الفاعلي عند الوجوديين، والاتجاه الفاعلي عند فلسفة الحياة، يقوم في أن الوجوديين يعتبرون أن الإنسان ذاتية خالصة، وليس مظهراً أو تجسيداً لتيار حيوي أشمل منه (أي التيار الحيوي الكوني) كما كان الحال عند برجسون على سبيل المثال، ويضاف إلى هذا أن الوجوديين يفهمون الذات، بمعناها الخلاق، فالإنسان يخلق نفسه بنفسه، إنه هو هوحريته هو.
ج) لكنه سيكون من الخطأ، مع ذلك، أن نستنتج أن الإنسان عند الوجوديين منغلق على نفسه، على العكس تماماً، فإن الإنسان، وهو الحقيقة الناقصة والمفتوحة، هو، من حيث جوهره ذاته، مربوط أوثق ارتباط إلى العالم، وعلى الأخص إلى البشر الآخرين.
ح) ويرفض كل الوجوديين التمييز بين الذات والموضوع، ويقللون من قيمة المعرفة العقلية في ميدان الفلسفة، فهم يرون أن المعرفة الحقة لا تكتسب بوسيلة العقل، بل ينبغي بالأحرى التعامل مع الواقع، هذا التعامل أو الخبرة يتم على الخصوص بالقلق، أو في تجربة القلق، وفيهيدرك الإنسان أنه موجود محدود قاصر، ويدرك هشاشة وضعه في العالم، هذا العالم الذي يلقى إليه الإنسان إلقاء، ويدرك أخيراً أنه سائر إلى الموت (عند هيدجر).
ومع ذلك،وبالرغم من هذه السمات المشتركة بين الفلسفات الوجودية، والتي يمكن إضافة سمات أخرى مشتركة إليها، فإنه توجد اختلافات عميقة بين ممثلي الوجودية، إذا أخذ كل منهم بمفرده.
وهكذا مثلاً، نجد أن مارسل، مثل كيركجارد، يعلن إيمانه بالألوهية،بينما يقول ياسبرز بوجود التعالي أو المتعالي، ولكن لا يمكن أن نقول إن هذا التعالي يعادل القول بوجود الألوهية أم بوحدة الوجود والألوهية.
أما فلسفة هيدجر فإنها تبدوفلسفة مُنكِرة للألوهية، ومع ذلك فإن هيدجر صرح بأنه لا ينبغي اعتبارها كذلك، وان كان هذا التصريح لا يعني الشيء الكثير. أما سارتر، أخيراً، فإنه يحاول إقامة مذهب منكرللألوهية صريح ومتسق الأركان"([22]).
ثالثاً: الفلسفة البنيويه([23])
تُعتبر الفلسفلة البنيوية أو البنائية أحدث المدارس التي ظهرت في أوروبا في القرن العشرين، وكان روّادها الأوائل هم: ليفي شتروس، وفرديناند دي سوسير، وجان لاكان، وقد اهتمّ كلٌّ منهم بتطبيق المنهج البنائي على إحدى فروع المعرفة.
مفهوم البنية:
ظل لفظ " البنية " حتى القرن17 محصورا على استعمالات الإطار المعماري، ولكن بدءاً منه استعمل اللفظ في الإطار البايولوجي، بواسطة هربرت سبنسر الذي نقل استعماله من الحيز المعماري إلى إطار علم الاجتماع في أواخر القرن19 دون أن يتجاوز اللفظ حدود اللغة والأدب والفلسفة. بيد أن علماء الاجتماع التقليديين أمثال كارل ماركس ودوركايم وباريتو وماكس فيبر استعملوا اللفظ بهدف تعيين الخصائص الاجتماعية. وفي أواخر القرن19 غدا اللفظ مفهوماً ملازماً للدراسات الاجتماعية، وأصبح من الممكن رؤية البنية على أنها: " تتواجد ضمنا في تحليل العلاقات والمؤسسات الاجتماعية، وأن أي رؤية للأحداث الاجتماعية كعوامل متعاقبة ومترابطة هي بنيوية"، ومع أعمال ألتوسير وميشيل فوكو وجاك لاكان ورولان بارت تَطَوَّرَ مفهوم البنية واكتست إرثاً جديداً، ويمكن النظر إلى كلود ليفي شتراوس باعتباره أبا حقيقيا للبنيوية. وبهذا التطور باتت البنيوية عبارة عن عدة تيارات فكرية واجتماعية مما يحتم الإحاطة بمبادئها وركائزها([24]).
ترى الفلسفة البنائية "إنَّ الظاهرة الكلية أو الفكرة، َتَتكوّن من طبقاتٍ مُتعددةٍ من البناءات أو الظواهر التي تتصل كلٌّ منها بالأخرى، ومن خلال تحليل تلك البناءات يُمكن الوصول إلى الحقيقة، فالمُجتمع يُمكن دراسته من خلالِ دارسةِ البناءات التي تكوّنه، وكذلك النصوص الأدبية واللغوية"([25]).
لقد "استطاعت البنيوية أن تشكل أداة بحث ايجابية في كثير من العلوم، إلا أن الفصل بين البنية والتاريخ، وبين البنية وتحديداتها الاجتماعية، قَصَرَ إيجابية البنيوية على بُعدٍ واحد، فهي تطمح إلى تأسيس جديد للعلوم الاجتماعية يسحبها من حقل التأويل الفلسفي إلى حقل العقلانية الكاملة، لكن هذه العقلانية عادت فالتقت بالمثالية حين جعلت من البنية " جوهراً " لا يقبل إلا بقوانينه الداخلية، وحين أغلقت فضاء البنية، وجعلته مكتفياً بذاته، أي ألغت منه مفهوم التناقض"([26]).
لكن "على الرغم من شيوع كلمة البنيوية ومفهوم البنية، فإن تعريفهما أو ادراجهما في تعاريف محددة، يثير بعض القضايا، فالبنية من حيث هي مفهوم لا توجد في الدراسات الأدبية والاجتماعية فحسب، بل انها قائمة في ميدان العلوم الدقيقة كالفيزياء والبيولوجيا والرياضيات، أما البنيوية فهي أبعد من ان تكون مدرسة فلسفية بالمعنى التقليدي للكلمة ويعود ذلك إلى اتساع مفهوم البنية، كما يعود إلى اختلاف النزوعات الفكرية لدى ممثلي البنيوية التي تمتد من حدود المثالية إلى حدود المادية، وقد انعكس هذا الاختلاف على تعريف مفهوم البنية، وسمح بتعددية التعريف واختلافه، بحيث جاء تعريف "جان بياجيه" مختلفاً عن تعريف "كلود ليفي شتروس"، وتعريف "رولان بارت" مختلفاً عن تعريف الماركسي لوسيان غولدمان.
مع ذلك فإن البنية في تعريفها البسيط هي نسق من العقلانية التي تحدد الوحدة المادية للشيء وهي القانون الذي يفسر هذه الوحدة، إن ربط البنية بالعقلانية يعني أولاً، أن البنية ليست وجوداً عيانياً، أو تجريبياً قابلاً للقياس، إنما هي بناء نظري للأشياء، يسمح بشرح علاقاتها الداخلية، وبتفسير الأثر المتبادل بين هذه العلاقات، ولهذا فإن البنية هي نسق من التحولات، يتألف من عناصر، يكون من شأن أي تحول في أي عنصر منها أن يؤدي إلى تحولات في باقي العناصر الأخرى. وبسبب هذه العلاقة تظل البنية ثابتة وغير متغيرة، على الرغم من التحولات الناجمة عن تحول العناصر، ولا يمكن تحويل البنية أو تغييرها إلا إذا اصطدمت ببنية خارجية. وبهذا المعنى فإن البنية لا تنطوي على أي بعد تاريخي، لأن التاريخ يعني التحول، والبنية لا تتحول وبالتالي فهي لا تعترف إلا بزمانها الخاص"([27]).
ركائز البنيوية([28]):
-
-
- انطلاقا من اللغة، فقد اعتبرت البنيوية أن الظواهر الثقافية، هي أنظمة لُغَوية لا بد أن تُحَلَّل باتساق بواسطة تقنيات ومناهج مستقاة ومشتقة من الألسنية كالتركيب اللغوي، الصوت اللفظي، وحدة الأصوات، التضاد الثنائي، الاستعارة، الكتابة، … إلخ
- كل ظاهرة ثقافية ينبغي أن يتم التعامل معها كما يتم التعامل مع اللغة، أي أن لها دال ومدلول، وبالتالي لا بد من علاقة تُظْهِر الكوامن بمجرد تسليط الضوء على الأول.
- من المفترض أن ينصب التحليل البنيوي على الجانب التزامني وليس التعاقبي(التاريخي) أو التطوري.
- التحليل البنيوي يتعامل مع القطيعة المعرفية واللاستمرارية، إذ أن مختلف التحولات التاريخية تعكس نماذج من القطائع المعرفية واللا إستمرارية، فكل مرحلة أو حقبة زمنية لها هوسها وهواجسها المركزية التي تعكسها النصوص التاريخية التي تَسِمُها.
- لا تعطي البنيوية للإنسان مكانة خاصة في العالَم الاجتماعي، فهو ليس شيئاً ولا معنى له خارج نطاق البنية والتفاعل البنيوي.
- يلاحظ في التحليل البنيوي ارتباط الظواهر الثقافية عن قرب بالسلطة، إذ كيف يمكن ملاحظة بنية أو دراستها خارج نطاق السلطة؟ إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الانضباط، العقاب، الخطاب الأيديولوجي، موجودة أصلا ضمن نطاق ممارسة السلطة؟
- تنظر البنيوية إلى عالمية( وحدة) المعايير التي تتحكم في دراسة المظاهر الثقافية، إذ أن تنوع الثقافات يؤدي إلى تنوع التعبير عنها، لكن البنى التي تتحكم في هذه المعايير متماثلة.
- البحث البنيوي يقوم على ملاحظات إمبريقية (تجريبية) تشكل خطوة مركزية لاكتشاف البنى اللاشعورية للمظاهر الثقافية.
-
([1]) الوضعية المنطقية :اسم أطلقه بلومبرجوفايجل عام 1931م على الأفكار الفلسفية الصادرة عن الجماعة التي أطلقت على نفسها (جماعة فينا) (تيارات فلسفية معاصرة .. أهم التيارات الفلسفية المعاصرة – الفيس بوك)
([2]) غنارسكيربك و نلز غيلجي – مرجع سبق ذكره - تاريخ الفكر الغربي - ص 874-875
([3]) أماني أبو رحمة – التحولات الفلسفية نحو بعد ما بعد الحداثة – موقع: لغو – الانترنت- بدون تاريخ.
([4]) أنطولوجيا (علم الوجود): يعود استعمال هذا اللفظ في الفلسفة إلى القرن السابع عشر. وكان قد أصبح من الألفاظ الفلسفية المتداولة عندما كرسه كريستيان وولف 1679-1754 م للدلالة على القسم الأول العام من الميتافيزياء أو على ما سماه أرسطو "الفلسفة الأولى". إذن فلفظة "أنطولوجيا، وهي يونانية الأصل، نشأت في الفلسفة المدرسية الألمانية التي تأسست على تعاليم لايبنتز1646-1716م. وتعني هذه اللفظة علم الكينونة أو العلم الذي يعنى بمبادئ الكائن من حيث هو كائن. أي أنه لا يعنى بالكائنات من حيث هذه الكائنات أو تلك، بل بوصفها مجردة من كل التعينات المقومة للفروقات بينها. بذلك يتضح لنا أيضاً أن الأسئلة التي تطرحها الأنطولوجيا كعلم والموضوعات التي تعالجها هي- شأنها بذلك كلفظة أنطولوجيا ذاتها- أيضاً يونانية المنشأ. وفي كتاب "الماورائيات" يستأنف أرسطو المسيرة الأنطولوجية اليونانية بقوله: من قديم الزمان والآن ودائماً يطرح السؤال الصعب: ما هو الكائن؟ إن كتابات أرسطو طاليس تحتوي على أنطولوجيا عامة وذلك بقدر ما تحاول هذه الكتابات طرح مفهوم معين لمبادئ الكينونة وماهية الكائن من حيث هو كائن. فيما بعد دعيت هذه الأنطولوجيا، وكان أرسطو قد سماها "الفلسفة الأولى" كما جاء أعلاه ميتافيزياء، واكتسبت في العصور الوسطى، وعلى يد السكولاستيين، حلة لاهوتية، وذلك عندما أصبحت بين أيديهم نظرية في ماهية وجود الله، إذ رأت في هذا الوجود الحقيقي الوحيد وكل ما عداه معتمداً في وجوده عليه. إن كون الأنطولوجيا علماً يعنى بالمبادئ الأولى للكينونة أو بماهية الكائن من حيث هو كائن يعني أن هدفها الأخير هو استكشاف ماهية الأشياء في حد ذاتها وباستقلال تام عن أفعال الوعي. من هنا أن كل نظرية فلسفية تحاول اختراق الصفات العرضية للأشياء إنما هي من باب التنظير الأنطولوجي. (انطوان خوري - الموسوعة الفلسفية العربية - رئيس التحرير: د. معن زيادة – المجلد الأول - معهد الانماء العربي – الطبعة الأولى 1986 –ص 150)
([5]) غنارسكيربك و نلز غيلجي – مرجع سبق ذكره - تاريخ الفكر الغربي - ص 881-882
([6])جماعة من الأساتذة السوفيات – موجز تاريخ الفلسفة – تعريب: توفيق ابراهيم سلوم – دار الفارابي – طبعة ثالثة (1979 م) – ص 975
([7]) المرجع نفسه - ص 976
([8]) المرجع نفسه - ص 977
([9]) المرجع نفسه - ص 986
([10]) المرجع نفسه - ص 977
([11]) المرجع نفسه - ص 980
([12]) المرجع نفسه – ص 967
([13]) المرجع نفسه - ص 968
([14]) المرجع نفسه - ص 969
([15]) المرجع نفسه - ص 970
([16]) المرجع نفسه - ص 971
([17]) المرجع نفسه - ص 973
([18]) المرجع نفسه - ص 975
([19]) غادة الشامي – الفلسفة الوجودية (عرض المذهب ونقد الفكر) – الانترنت- شبكة الألوكة - 9/11/2014..
([20]) المرجع نفسه.
([21]) بوشنسكي – الفلسفة المعاصره في أوروبا – ترجمة د. عزت قرني – عالم المعرفة 165 – سبتمبر 1992.
([22]) المرجع نفسه.
([23]) بلغت البنيوية أو (البنائية) ذروة ذيوعها كاتجاه فكري فلسفي في الستينات من القرن العشرين، وبات مألوفاً بين المثقفين أن يُنظَر إليها كمذهب فلسفي يتسم بالشمول ويهدف إلى تقديم تفسير موحد لعدد واسع من قضايا الفكر والمعرفة، فقد امتدت إلى ميادين متنوعة انبسطت على عدة مجالات، ففي مجال اللغويات نجد (جاكوبسون) و(شومسكي)، وفي التحليل النفسي نجد (لاكان)، وفي النقد الأدبي (رولان بارت) الذي فتح عهداً جديداً في تفسير النصوص على أساس بنائي، وفي الفلسفة كان (ميشال فوكو) يبهر الجماهير بآرائه في كتابه (الكلمات والأشياء)، أما (التوسير) فقد كان يقرأ التراث الماركسي (رأس المال) قراءة بنائية جديدة، وكان عالم الانتربولوجيا (كلود ليفي شتراوس) يواصل جهوده الحثيثة في قراءة القرابة والأسطورة في المجتمعات التقليدية، هذه الجهود التي حققت مكانة بارزة للبنيوية بين المذاهب الفلسفية في النصف الثاني من القرن العشرين.
وتعود الأفكار الأساسية لهذا المذهب إلى مؤسسها الأول السويسري فرديناند دي سوسير (1857 ـ 1913م) الذي عمل على تحديد موضوع علم اللغة، وان كان بعضٌ يذهب إلى أن مفهوم البنية وجد قبل "سوسير" في أعمال جان جاك روسو، وإمانويل كانط، وماركس، وفرويد، وغيرهم، بيد انه لم يصبح أداةً للتحليل وقاعدة لمنهج نظري معين إلا بعد عام 1928م. وأبرز ما تمتاز به البنيوية فلسفياً هو محاربتها للنزعة التجريبية من جهة، وللنزعة التاريخية من جهة أخرى، فهي تذهب إلى أن العقل ينمو نمواً عضوياً بحيث تظل فيه صور هي أشبة بالنواة الثابتة، وان كنا نزيدها على الدوام توسيعاً وتعميقاً. (الفلسفة من العصر الوسيط إلى الفترة المعاصرة – موقع: كتاب – الانترنت- بدون تاريخ- https://www.ktab.xyz/p/blog-page_20.html)
([24]) د. أكرم حجازي – البنيوية التركيبية .. فلسفة "بيير بورديو" – منتدى: مجمع اللغة العربية – 8 ابريل 2013.
([25]) ليلى العاجيب – بحث حول الفلسفة المعاصرة – الانترنت- موقع: موضوع – 31 يناير 2016.
([26]) الموسوعة الفلسفية العربية – المجلد الأول – معهد الانماء العربي – 1986 .
([27]) فيصل دراج - الموسوعة الفلسفية العربية – المجلد الأول – ص198.
([28]) د. أكرم حجازي – البنيوية التركيبية .. فلسفة "بيير بورديو" – منتدى: مجمع اللغة العربية – 8 ابريل 2013.