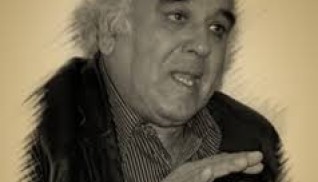بعدَ هزيمةِ حزيران عامَ 1967، واحتلال ما تبقّى من فلسطين وتشرّد الفلسطينيين في المنافي والشتات؛ كانت الحركةُ الصهيونيّةُ قد وصلت إلى قناعةٍ أن مشروعها قد اكتمل، ولكن الشعب الفلسطيني كان له رأيٌ آخرُ على الرغم من هذه المأساة الكبرى التي حلّت به، فلا يمكن الحديث عن بلورة الهُويّة الوطنيّة الفلسطينيّة وانسكابها في مشروع التحرّر الوطنيّ إلا بعد أن وقعت هزيمة حزيران؛ فجاد الفلسطينيّ بكلّ ما يملك وانخرط الجميع في مسيرة التحرير وظهر على القمم الرجال والبنادق، حينها أرّخ الفلسطينيُّ روايته بقلم غسّان كنفاني.
الرجلُ الصلبُ والعنيدُ والمتمكّنُ في كلّ المجالات التي عمل بها، الذي ترك خلفه إرثًا ثقافيًّا عظيمًا داخل جبهته التي انتمى إليها، وداخل المشروع الوطني الفلسطيني، هذا الإرثُ الذي تجلّى بمساراتٍ عديدة؛ فكأنّ غسان على سباق مع الوقت؛ فمن جهةٍ ينجز رواية الفلسطيني عن النكبة والنكسة ومن جهةٍ أخرى يبني مؤسّسةً إعلاميّةً وما بينهما يطارد نجمة الصبح، يقينه كان دائمًا بأنّ النصر قادم.
أسئلة كثيرة تطرح عن غسان سواء في الماضي والحاضر وستبقى مفتوحة على المستقبل: كيف استطاع هذا الرجل أن ينجز بسنواتٍ قليلةٍ كلّ ما أنجز؟
ولأنّ غسّان انخرط في فكرة الحلم وأصبح من الصعوبة بمكان الفصل بينهما؛ ليتوج بلحظة الشهادة والاستشهاد، حيث تطابق القول بالفعل، فهذا المثقف الثائر الذي انخرط بكل وعي في هذا المشروع كان يدرك منذ البداية بأن المصير الشخصي للفرد الفلسطيني لا معنى له أمام مصير الشعب ومصير الأمة التي آمن بها غسان وآمنت به.
ومن اللافت أن كتاباته وإبداعاته كانت في فترة الهزيمة التي جيّرها غسان بصيغة المنتصر، فما يعنينا هو إبداعات الفكر وتجليّاته الذي كان يتحلّى به غسان، النابع من رحم معاناة الشعب الفلسطيني وامتداد لنضالاته المديدة؛ فغالبًا ما نتّجه إلى النظريات الفكريّة المستوردة إلينا من خارج الحدود لتكون المرشد لنا في معالجة مسائلنا الوطنيّة والاجتماعيّة والسياسيّة، بالرغم من وجود الإرث الثقافي الإنساني الذي يختزنه مجتمعنا، ولا نقلل هنا من شأن التفاعل مع الثقافات العالمية الأخرى، ولكن القصد أن نكون في تفاعلنا مع الثقافات المغايرة مستندين إلى ثقافتنا القومية ذات الجذور الثقافية الحاضنة لقيمنا وتاريخنا لتبقى ثقافتنا البوصلة التي توجهنا إلى ما يمكن التناغم معه من الثقافات الأخرى المنسجمة مع حيثيات واقعنا.
وفي سياق التاريخ واجه مجتمعنا العربي عمومًا والفلسطيني على وجه التحديد أمواجًا عاتيةً من الثقافات والأفكار الوافدة مطلع القرن الماضي وبدت ملامحُ بلبلةٍ فكريّةٍ من خلال تبني نظريات وأفكار سياسية، دون منح الثقة إلى مقاييس ثقافتنا الذاتية، وربما يكون هذا ناتجًا عن حالة ارتباك ترى أن الآخر أكثر كفاءة من ابن البلد، أو أنه يتميز بالنضج والتقدم، ولا يعني هذا أن نتقوقع ونرفض الآخر بل يعني أننا إلى جانب تعاملنا مع ثقافات الآخرين؛ يتوجب علينا اعتماد نتاج مخزوننا الفكري والثقافي التاريخي النابع من أرضنا وبيئتنا الحضارية المكتنزة بنتاجها المتراكم عبر العصور. لقد ظهرت مدارس فكرية شتى وبرز من خلالها رموز الفكر والثقافة والسياسة الذين أرسو قواعد العقيدة التقدمية والثورية التحررية، ولكن لم يتح لها أن تحقق وتنجز كل أهدافها في العالم العربي، بسبب الحروب المتتابعة عليها وبسبب حكومات الاستبداد التي كان من بين إجراءاتها التضييق على الحياة الحزبية والفكرية، حيث لم تفصل في إجراءاتها بين الحزب وبين الفكر ووضعتهم في ذات الهدف، وليس هنا مجال لعرض أفكارهم، ولكن في حالة غسان فقد برز كقائد وأديب منذ بداية حروفه الأولى، حيث حدد البوصلة والهدف في الحرية والاستقلال والكرامة الإنسانية وعنون في استشهاده على أنه في فلسطين قادة مفكرين وأدباء ضحوا بأرواحهم، من أجل القضية الوطنية الفلسطينية.
المؤسف أن البعض اتخذ مواقف من فكر غسان كنفاني بسبب الخلافات السياسية ودون الاطلاع على ما جاء بنتاجه الأدبي والفكري والسياسي، ولقد تذرع البعض بأنه لو لم يكن منتميا إلى حركة القوميين العرب وفيما بعد إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لكانت أفكاره أكثر رواجا وانتشارا ، ولكن الأصح أن انتماء كنفاني إلى الحزب وضع الفكر في مسار مؤطر بانتظام يؤدي إلى تفعيله وتطبيق الأفكار بشكل عملي في الحزب والمجتمع، فلا تبقى أفكارا مبعثرة يقتصر تأثيرها على أفراد وتجمعات مبعثرين، والقصد أن وجود حزب يؤمن بالتحرير ومقاومة الظلم والعدوان لا يجوز أن يكون سببا للرفض المسبق له، ولا لاتخاذ مواقف منها قبل التعرف إلى الجوهر والمضمون لهذه الأفكار. وبغض الطرف عن الخلافات والتباينات السياسية، فإن كنفاني لم يضع فكرا يخص جزء من الشعب الفلسطيني أو العربي أو يخص بعض مكوناته، بل كانت أفكارا لكل الفلسطينيين ولكل الأحرار في العالم، وإذا كان قد تبناها بعض الفلسطينيين في إطار حزب فلا يعني أنها ملك لهم وحكرا عليهم فقط؛ فهي كما أي عقيدة فكرية ملك للجميع ومن حق أي مجتمع في العالم ومن حق أي فرد أيضا اعتناقها أو تبني أفكارها أو بعضا منها دون أن ينتمي للحزب. لذلك من المستحسن أن يتعرف الفلسطينيون سيما الأجيال الناشئة إلى أفكار هذا الأديب الروائي المناضل الثوري والمنبثقة أفكاره من البيئة الفلسطينية الطبيعية المعبرة عن مفردات المجتمع الفلسطيني الذي يكابد مأساة اللجوء والشتات ومقاومة المحتل، وذلك لإيجاد حلولا هي أقرب إلى شخصيتهم ونفسيتهم الناشئة عن تفاعلهم مع واقعهم أينما كانوا.
القصد مما تقدم أن رؤية غسان كنفاني تمحورت حول ضرورة الاستقلال الفكري الذي يشكل بدوره دليلاً للاستقلال في شؤون قضيتنا الوطنية والقومية، وإذا ما استعرضنا بإيجاز أحد الجوانب الفكرية السياسية التي كان ينادي بها غسان كنقطة ارتكاز في العمل الفكري السياسي الثوري، حيث كان يؤكد على أهمية الفكر السياسي في توجيه الثورة وحمايتها من الانحراف والاستغلال والفوضى، ووضوح الخط السياسي يفوت على الانتهازيين والمتآمرين إمكانية تضليل الثورة وتشويه مواقفها.
إن الفكر السياسي لدى غسان يعني وضوح رؤية المعركة وأبعادها وقواها وعدتها وعتادها، بحيث يتحول هذا الفكر إلى قوة تتوحد حولها الجماهير والتي ستستطيع بدورها أن تفهم عدوها ونقاط ضعفه وقوته والقوى التي تسانده وتتحالف معه، وبالمقابل تفهم قوة الثورة التي تنتمي إليها وتتفحص ماهيّة العدو وقوته ومن خلال أية برامج تنظيمية وتعبوية وسياسية وعسكرية؛ تستطيع أن تتصاعد بقواها حتى تلحق الهزيمة بالعدو وتحقق الانتصار.
الفكر الاستراتيجي الواضح لدى غسان يستوجب وقبل كل شيء الإجابة عن أول سؤال يواجه الثورة وقيادتها وجماهيرها: "من هم الأعداء؟" الذين يحتلون التناقض الأساسي وعلى كل أطراف قوى الثورة أن تتوجه لمواجهتهم بكل الجهود أنهم كما حددها فكر غسان كنفاني وأكدت التجارب صحة ذلك: "إسرائيل" و "الحركة الصهيونية العالمية" التي تمثل عمقها وامتدادها على الصعيد الدولي، وتزودها بالمهاجرين والمستوطنين وتمدها بما تحتاج إليه من دعم واسناد. ومن الأعداء أيضا "الإمبريالية العالمية بقيادة الولايات المتحدة الاميركية" الشريك الاستراتيجي والراعي الرسمي للكيان ليس باحتلال فلسطين فقط؛ وإنما بضرب حركة التحرر العربية والهيمنة على المنطقة ونهب خيراتها والإبقاء على حالة التخلف والتبعية والتجزئة في الوطن العربي. يضاف إلى هؤلاء الأعداء الخارجيين العدو الداخلي "الأنظمة الرجعية العربية" التي أوجدها الاستعمار وربطها معه بمصالح مشتركة لنهب خيرات وثروات شعوبها. ويرتبط السؤال الأول "من هم الأعداء؟" بالقدر ذاته من سؤال "من هي قوى الثورة؟" ذات المسؤولية والمصلحة في التصدي لهؤلاء الأعداء. هنا تأتي أهمية القراءة الطبقية للمجتمع الفلسطيني لدى غسان، وذلك لتحديد من هي القوى الثورية صاحبة المصلحة في التغيير الثوري والقادرة عليه إذا جرى إعدادها وتأهيلها للقيام بهذا الدور من خلال تحليل موضوعي يستند إلى تقييم مسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية منذ بداية التصدي للمشروع الصهيوني والانتداب البريطاني من جهة وتجارب ثورات ناجحة من جهة أخرى.
في واقعة اغتياله التي مضى عليها نصف قرن من الزمان ما يكثف رحلة عمره القصير وحياته العريضة؛ أطل في بداياتها من نافذة منزله في عكا على أرضه السليبة وعلى الساحل الفلسطيني، حيث الأفق اللامتناهي مروراً بنشاط نضالي متعدد الأشكال والسمات الكفاحية؛ كشف في شخصيته بذور التمرد على واقع يحياه ولا يعترف بواقعيته؛ فالثقافة لا تفعل فعلا سياسيا إلا إذا خرجت من رحم الممارسة الكفاحية ومعبرة عنها. وكما وصفه محمود درويش في رثائه: "أحد النادرين الذين أعطوا الحبر زخم الدم... ونقل الحبر إلى مرتبة الشرف وأعطاه قيمة الدم". فقد كان غسان يكتب ويبحث عن ذاته ويكتبها تارة أخرى ليجسد ثنائية البحث والكتابة التي تكثفت في سؤال سر الصمود والمقاومة؛ معتنقا لحظات التحول واتخاذ القرار عند الثوار الحقيقيين وهي ثنائية استمرت معه وانتهت بجواب جسد تناثر عاليًا الأفق، حيث تلتقي الأرض بالسماء بفضاء أكبر من أن يحاصر.