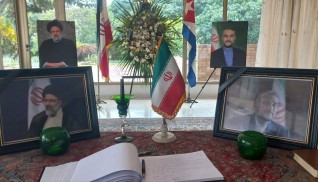تقعُ روايَةُ "مَوَّالُ شَمسٍ"(1)؛ وهي الأولى للكاتب الرِّوائي تَوفيق وصفي، في نحو 440 صفحة من القطع المتوسط، وتتزَيَّا بغلافٍ زيَّنته لوحة للفنان التشكيلي الفلسطيني حسني رضوان، وغلافٍ صَمَّمه الفنان شربِل إلياس. ولَئن كانَ الكاتبُ، وهو نفسُه الرَّاوي على مدى السَّردِ، إلاَّ باستثناءاتٍ نادرةٍ تُوحيِ بتمايزِهِ، قليلاً، عَنهُ ، قد حَرصَ على أنْ يُنَوِّهَ، في تَوطئَةٍ رأَها ضَروريَّة للقارئاتِ والقارئينَ، على أنَّ روايتَة "قد تبدو سيرة ذاتية، بالرَّغِم من كونها تَتَمحورُ حول امرأةٍ اسمها شَمْس"(2)، فإنَّ هذه الرِّوايَة، وبالرَّغِم من كَونِها كذلِكَ، سرديَّةٌ فلسطينيَّةٌ صُغْرى لا تنقِطِعُ، بأيِّ حالٍ عنِ السَّرديَّة الفلسطينيَّة الكُبْرى، وإنِّما تُكْمِلُها بالتَّركيزِ على تفاصيلَ جَوهريَّة،تُضيئها وتُعَزِّزُ صدقيَّتها الحياتيَّة والوجودِيَّة، فيما هي تَسْردُ، كما يُفِصِح الرِّوائيُّ مُتساوقاً مَع إفْصَاحِ روايتِه، "حكايَةَ جيلِها (أي جيْلِ شِمْسٍ)، وجيلنا الذي عاشَ رجالهُ ونساؤه مرحلَةً فاصِلَةً من تاريخنا الجَمْعِيِّ، تركَّزتْ في لحظَةٍ حاسِمَةٍ، كان لِهَا ما بِعدَها"(3).
ولِهذا الإفْصَاحَ التَّمهيديَّ أنْ يُهَيِّئنَا لِتلقِّي حكايَةٍ، هي "حكايَةُ شَمْسٍ" الضَّافِرةُ في إهابِها سَلاسِلَ حكاياتٍ تتداخَلُ وتَتَشَابَكُ، ولا تَكُفُّ خُيوطُها السَّرديَّة عَنِ تبادُل التَّأثيرِ والتَّأثُّرِ، وعن الإسهام، بفاعليَّة رؤيَويَّة وجماليِّة، في بنْيَنَةٍ الروايَة، وفي بلورة رؤيَتها الكُلِّيَّة للعالَم، وذلكَ عبرَ تحديد عناوينَ ومُحتَوياتِ فُصُولِها البالغِة اثنين وأربعينَ فصلاً، ينضافُ إليها ما يُمكِنُ اعتباره فصلاً آخَر من فُصُولها، وهُو، في حدِّ ذاتِه، خاتِمَةٌ وبِدايَةٌ وخُلاصَةُ خلاصاتٍ أسفرتْ عنهَا تجارب أفرادٍ انصهرت في تَجربَةٍ ٍ جمعيَّة أراد الرِّوائيُّ الذي هو نفسُه الرَّاوي، وأَوَّلُ شَخصيَّتين رئيستينِ في الرِّواية، إعادة إضاءَتِها بسطوعٍ وجلاءٍ يَسْعَيَانِ إلى قول الحَقَائِقِ التي أدركَهَا، بِتَبَصُّرٍ تَأَمُّليٍّ عميقٍ، وإلى فَتْحِ السَّرديَّة الفلسطينيَّة، واللُّبنانيَّة أيضاً، على أزمنَةٍ ستأتي، وذَلِكَ بدلالة العنوانِ التَّساؤليِّ الأخير: "أَفَصْلٌ أخيرٌ أم سرديَّةٌ أُخْرى؟"، مقروناً بعنوانٍ فَرعيٍّ: "جُنُوحُ شَمسٍ وتشظِّيات جسد"، وهُو العنوانُ الذي يُقدِّمُ نفسَه كاستعارةٍ مُوسَّعَةٍ تَفتَحُ السرديَّة التي أتْمَمنا قرأتها، للتَّوِّ، على قراءاتٍ وتأويلاتٍ تَصِلُ كُلَّ خاصٍّ بِكُلِّ عامٍ، وتَوازي سيرة "شَمْسٍ" وسيرة عاشِقُها المُوَلَّه "ناجي"، على سِيرَ عشراتِ الشَّحصيَّاتِ الرِّوائيَّة، الأُنثويَّة والذُّكوريَّة، العديدة، والمُتنوِّعَة الخصائص الهُوِيَّاتيَّة، والملامح والسَّمات وتجلِّيَّات السَّلوك، لِتَضْفُرهَا، جَميعاً، بسيرِ آلافِ "الشَّموس"، و"النَّواجي"، وُسِيَرِ عُشَّاقِ "فلسطينَ" وعاشِقاتِها النَّاذرينَ والنَّاذراتِ أَنفُسَهُم وأنْفُسِهنَّ، وكُلٌّ بطريقته وبحسبِ قُدْرَتِه، لإعادتها إلى نفسها، عبر تَحريرها من الاحتلال الصُّهيونيّ العُنْصُريِّ الاستعماريِّ الاستيطانيِّ المُتَوحِّش، وإزالة القناعِ الاسْميِّ الزَّائفِ الذي أُلقاهُ هذا الاحتلالُ، بالتَّزوير والادِّعاءِ والاستلابِ والإرهابِ المُتَوحِّشِ والتَّطهير العرقيِّ والقَهْر، على وجهها، إذْ غافَلَ التَّاريخَ الإنسانيَّ الحضاريَّ الحَقَّ، وأَسْمَاهَا، في لَحظَةٍ يأبى هذا التَّاريخُ انتسابَها إلى لحَظاتِهِ: "إسرائيل".
***
تُقَدِّمُ "مَوَّالُ شَمسٍ" تَجلِّياً مُميَّزاً لكيفيَّة تَحويل سيرةِ ذاتيَّةٍ يرويها صَاحِبُها بِصَوتِه ضَافِراً إيَّاها بمجْموعَةٍ كبيرة من السِّير الغيريَّة المروِيَّة بِصوتِه أيضاً، ودائماً وِفْقَ رؤيَتِه الخَاصَّةِ للأشخاصِ الآخرينَ وتجلِّيات سُلُوكِهم وأشكال استجاباتِهم للتَّحدِّياتِ التي تُواجههم كأفرادٍ مُتعدِّدي الخَصائص والسِّمات، ومُكوِّنات الهُويَّاتِ، والحاجاتِ، والأحلام والتَّطلُّعات، وينتمونَ، كلٌّ بطريقتِه ووفق حاجته، وبِما يستجيبُ لمُكَوِّناتِ هُوِيَّتِه القائمَة، أو المُتَطلَّع إليها، ومُحَدِّداتِ رؤيَتَه الواضِحة، أو الغامِضَة، لذاتِه وواقِعه وعالمِه، إلى مجموعَةٍ، أو جَماعَةٍ، أو شَعبٍ، أو أُمَّةٍ، إلى سِيْرةٍ جمْعيَّة تُشَارِفُ حُدود الفَهْمِ اللًّوكاشيِّ، المُعَدَّلِ من قِبَلِنا، قليلاً، ليستجيبُ لشروطِ الواقِعِ الحياتيِّ الوجوديِّ الذي أنتج هذه الرِّوايَة كسيرةٍ جَمعيَّة لأشخاصٍ هُمْ، في أَعَمِّهِم الأغلب، لاجئون فلسطينيون، ووطنيُّونَ لبنانيُّون، ومُهَجَّرونَ مُقْتلَعونَ من بيوتِهم وأوطانِهم، وبرجوايونَ صِغارِ، ومُثَقَّفُونَ قَلِقُونَ، شَاكُّونَ ومُتسائلونَ، ومُتَمرِّدون ومأزومون، للروايَة كـ"ملحَمَة برجوازيَّة"(4).
تَدورُ أحداثِ هذه الرِّوايَة: "مَوَّالُ شَمس"، على مِحورٍ رئيسٍ يَضْفُرُ مِحورينِ ويجَعلُهما مُلتَحمينَ على مدى صيرورة السَّرد الروائيِّ؛ وما هذا المِحورُ المزدوجُ والمُلتَحمُ إلا مِحْوَرُ العلاقَةِ المُتشَعِّبَة، والمُفْعَمة بالتَّوتُّر الدِّراميِّ الدَّاخِليِّ، والخارجيِّ، النَّاجِمِ أوَّلُهُما عنِ الشَّغَف العِشْقيِّ الغَامِضِ القائمِ على نحوٍ تبادليِّ مَكبوحٍ عن التَّجلِّي في الواقِع المَوضوعيِّ كعلاقَة عشْقيَّة صَائرةٍ وقابلِهٍ للاستمرارِ، أو مُفْصَحٍ عَنْهُ، ليُكْبَحَ من جديدٍ، بين "شَمس" و"ناجي"، وبينَ كُلٍّ منْهُما بِمفرده، وبين كليهما مَعاً، والوَاقِع المُتَقَلِّبِ، والضَّاري، الذي تَجري فيه أحداث الرِّواية، فيما يَنْجمُ ثانيهما وفي تَواشُجٍ مُتَّصِلٍ مَع أوَّلِهِما، عن التَّحدِّيات الحياتيَّة والوجوديَّة التي يُمْلِيها هذا الواقِعِ، التَّهديديِّ القَهريِّ النَّاجِم عن تواصُلِ الحرب الإسرائيلية العدوانيَّة الاستعماريَّة التَّوحُّشيَّة على فلسطين ولبنان، وعلى غيرهما من "بلادِ العرب"، من جِهَةْ أولى، والمُقاومِ بإصرارٍ شعبيٍّ فلسطينيٍّ ولبنانيٍّ وعربيٍّ وإنسانيٍّ لاجتراحِ نِضالٍ تَحرُّري مُتشَعِّب الحُقول والمجالات والأنشِطَة، من جِهَةٍ ثانيَةٍ، على هَذِيْنِ العاشِقَينِ المقهورينِ والمُنتَفِضيْنِ في وجه القَهرِ، سَوِيَّةً أو بانفرادٍ، وعلى غيرهما من "سًكَّانِ الرِّوايَة" من شخصيَّاتٍ شبه أساسيَّة، واُخرى ثانويَّة، أو عَابرةٍ، استوجبَ إسهَامُهَا، الفَاعِلُ أو المُنْفَعِلُ، في صُنْعِ حدَثٍ مُعيَّنٍ، التَفَتَ السَّاردُ، أو غيره من شخضيَّاتٍ الرواية المسهِمَةِ في تحفيزِ السَّرد، إليه، أنْ تُوجَدَ على هذا النِّحوِ الثَّانويِّ، أو العابِرِ، بالرَّغم من انطواء أغلبها على بِذْرة شخصيَّة روائيَّة حَيَويَّةٍ، قابِلَة للإنْضَاج والبلورة، ليسَ بالضَّرورة في هذه الرِّوايَة، وإنَّما في أكثرِ من روايَةٍ لاحِقَة.
وثَمَّةَ فُروضٌ عديدةٌ أصَّلتْها مُعطياتُ قراءاتٍ مُتكَرِّرةٍ تباعدت أزمنتها، وتواكبتْ، في كُلِّ حِينْ، مع تحليلاتٍ نَصِّيَّة مُتَعدِّدةُ المداخِلِ ومُتَشَعِّبَة الإجراءاتِ، لِهذه الرّوايَّة، أحسبُ أنَّهُ من المُلائم وضْعَ ما يتعلَّق من هذه الفرُوضِ بِبِنْيَة الرِّوايَة الكُلِّيَّة أمام تبصُّرِ القارئاتِ والقارئينَ تحفيزاُ لَهُنَّ ولَهُم على قراءاتِها، كتمهيدٍ ضروريٍّ لِتَوخِّي إسْهامَهُنَّ وإسهامَهُم الخَلَّاقِ، في التَّبَصُّر التَّفاعُليّ في ما ستَقُدِّمُه مُقاربَاتنا النَّقدِيَّة التي نَتوخَّى أنْ تَكونَ شامِلَةً، ومُتكامِلَةً، لِتُسْهِم في تحقيق قراءاتٍ مُستقبليَّة، وتأويلاتٍ، ذاتِ ثراء معرفيٍّ، وإمتاع جَماليٍّ، لهذه الرِّوايَة الفريدة، وذلكَ بالرَّغِم مِمَّا اعْتُورها منْ هِناتٍ بنائيَّةِ، أو أخطاءٍ في الصَّوغ، أو التباسٍ في الإحالةِ، في هذا الموضِعِ السَرديَّ أو ذاك، وهي في كلِّ حالٍ هِناتٌ وأخطاءٌ والتباساتٍ قليلةٌ، قابِلَةٌ للإدراكِ، والتَّصْويب، فلا تَكادُ تُحْسبُ بالرغِم من تأثيرها السَّلبيِّ على سلاسَة القراءء، وعلى وُضُوحِ الانعكاسات القبليَّة والارتجاعيَّة المُتبادَلَة، والنَّاجِمَة، أصلاً، عن اعتماد الروايَة أسُلُوباً مُمَيَّزاً في بناء الشَّخصيَّات الرئيسة، وشبه الرئيسة، بل والثَّانويَّة أيضاً، وفي تجلية خلفياتِها ومُكَوِّنات هُوِيَّاتها، بحيث لا نَعْرفُ جَوهَرَ هُوِيَّاتِ، ولا نُدركُ مُسبِّباتٍ سُلوك، عديدٍ مِنْها، إلَّا بعد قراءةِ السَّطر الأخير من الرّواية.
يَتَعلَّقُ أوَّل فَرضٍ تتَوجِّبُ إضاءَتُه بالزَّمن: زمنِ السَّردِ والزَّمنِ الروائي. فيما يتعلَّق الثَّاني بالدَّورات السَّرديَّة التي تُشَكِّلُّ، في تداخُلٍ تَفاعُليِّ، البنيَة السرديَّة الكُليَّة للروايَّة. أَمَّا الثَّالِثُ، فيتَعلَّقُ بالطَّبيعة النَّوعِيَّة لِهذه الرِّوايَة؛ أو بالنَّوع الرِّوائيِّ الذي تنتمي إليه في إطار انتمائها إلى الرِّوايَة كجنسِ أدبيٍّ جامِع. أمَّا رابِعُ الفُرُوض الأساسيَّة، فيتعلَّق بأمداءِ التّوازنِ القائمِ ما بينَ الواقعيِّ والمُتَخَيَّل والذي يبدو أنَّ الروايَة قدْ سَعَتْ إلى إحكامِ إقامتِه في سياقِ استجابتها للكشوفِ السَّرديَّة التي وجدتْ نَفْسَها مُلْزمَةٍ بكشفٍ أبعادها، وللرسائلِ الرؤيَويَّة والجماليَّة التي تَوخَّت إيصالها لِقارئاتٍ وقرَّاءَ مُفتَرَضِين. وثَمَّة فُروضٌ أُخرى تتعلَّقُ باللُّغَة والأسلوب، وبآلياتِ السَّرد وتقنياته الأسلوبيَّة، وببناءِ الشَّخصيَّات، وبالعلاقات القائمة بين الشَّخصيَّات والأحداث، وبطبيعة العلاقَة القائمة بينَ أيٍّ منهما، وبينهما معاً، بالأزمنَة والأمكنَة (أي بالزَّمكانات الرّوائيَّة)، وغير ذلك من فُرُوضٍ تفصيليَّةٍ ذات صِلاتٍ صميميَّة بِما أوردناه من فُروضٍ، سيتوالى الكشْفُ عنها، ومناقشتها، مَع توالي أقسام المُقاربَة التَّحليلية النَّصِّية النَّقديَّة التي نَفتتحُها بهذا القسم التَّمهيدي.
***
تبدأُ الرِّوايَة بـ "خبر صَغير" يُعَنْونُ فَصلها الأوَّل؛ ولم يكُنْ هذا الخبرُ، المنشورٌ في "مُربَّعٍ صغيرٍ" في إحدى الصُحف اللبنانيَّة التي شرعَ "ناجي هادي" في تصَفُحَها في مكتبَه في مَجلَّة فلسطينيَّةٍ يَعْملُ مُدَقِّقاً لُغَوِيَّاً فيها، إلَّا خَبراً عنوانهُ "مصرع الرَّائد شَمس"؛ ولَم يُلْفت ناجي فيه إلَّا الاسم: "شَمْس"، الذي لَم يكُن قد قرأَ عنهُ أو سِمِع به، كرائدٍ، أو كقائدٍ عسكريٍّ من قَبلُ، فيما هُو يحفظُ الاسم عن ظهرِ قلبٍ لكونَه اسم معشوقَتِه التي تركها في بيروت يَومَ الترحيل القسريِّ لقواتِ المُقاومَة الفلسطينيَّة عنها في غُضونِ الثُّلثِ الأخير من آب (أُغسطس) من العام 1982. وهو الأمرُ الذي حفَزهُ، تحفيزاً وجدانيَّاً على الأغلبِ، على استجلاءِ حقيقة هذا الخبر الصَّغير، ليتبيَّن لنفسِه، وليُبيِّنَ لنا كُقرَّاءَ لروايَتِه، عُقبَ إعلامنا قراءته تذييل الخبر الذي يَقولُ إنّ "القائد القتيل امرأة"(5)، وعُقْبَ إخبارناَ ما أسفَرَ عنه استقصاءٌ إجراهُ وزميله في المجلَّة الرَّسام "شَوقي" مَع زميلةٍ لَهما في المجلَّة نفسها، هي "زهية" ابنة خال "شمسٍ" القاطنة مَع أُمِّها "أُم حَلُّوم" مخيَّمَ شاتيلا"، أنَّ "الرَّائد شَمس" هو نفسُه "شَمْس" التي يعرفانها عن كَثبٍ؛ إذْ أكَّدتْ لَهما "زهيَّةُ"، بموجبِ خبرٍ تلقَّته من أهلها قبلَ يَومينِ أنَّ "شَمسَ قد ماتت"(6)، وأنَّ الرِّوايات المُتداولَة بِشأن مقتلها كثيرةٌ، ومُتَبَايِنةٌ، فَثَمَّة رواية تقولُ إنِّها قَتَلَتْ، بمسدسها، مساعداً لها حَاولَ قَتْلَهَا، ثًمَّ حاولت الفرار من "عين الحلوة" قبل أنْ يَتمكَّنَ أهلُهُ من قتلها، وثَمَّة من يقولُ إنَّهم "أطلقوا على سيارتها قذيفة آر بي جي"(7)، و"رصاصٌ كثيرٌ"(8)؛ "فَتَشَوَهَت ملامحها وتفتَّتَ لَحمها"(9)، وثَمَّة من يُؤَكِّدُ أنْ "غُمُوضَاً يكتنفُ موتِها"(10).
ومَفجُوعاً بإيجاز زهيَّة القاسي، يُسارع نَاجي بإبلاغ صديقه "شوقي"، أنَّه سُيهاتِفُ صديقهما "أمير" الذي يرأس تحرير مجلَّة فلسطينيَّة تصدر في نيقوسيا، لُيْبْلِغَهُ هذا الخَبر الفَاجِع، الذي "سيحُزنُه كما أحزننا"(11)؛ لأنَّ "ثَمَّة ما نتشارك فيه إزاءَ شَمس"(12). ومفجُوعاً، كما ناجي وشوقي، بتَأكُّد خبرِ مَقتَلِ "شمس" التي عرفَها في إطار تجاربَ عملٍ حيويٍّ عديدة ومُشتركة، فأعزَّها وقدَّرها وأثنى على جَدِّيَّتها وصِدْقيَّتِها، ينتهي أميرُ إلى ترديد العبارة: "جيفارا ماتَ ولا جِدال"(13)، ويدعو ناجي إلى المَجِيءِ، مساءً، بصحبَة شوقي، إلى منزلِه، لِيكونَ هُو، وبصحبته زميلهم "يونس"، في انتظارهما، وبِصُحْبَة سيرة "شَمسٍ" ومُوَّال شَمْسٍ" الذي أخذهَا التشبُّثُ به، أو رُبَّما الكفُّ عَن غِنَائِهِ، إلى هذا المصير المأساويِّ الفاجِع.
ما إنْ أتى "ناجي" وبصحبته "شوقي"، إلى منزلٍ "أمير"، وجُلُوس ثلاثتهم في الشُّرفَة حيثُ كانَ يجلسُ "يُونُس"، يَكونُ المُغلَّف الذي جاءَ بِه ناجي لِيَضعَهُ فَورَ وُصولِه على "الطاولِةِ التي تتَوسَّطُ الشُّرفَة"(14)، مُثيراً بهذا فُضولَ "يونُس" الذي تساءَلَ عَن مُحتوياتِه، ليُسَارعَ، من ثَمَّ، إلى فتْحه، بإيعازٍ من ناجي، ليكتشَفَ، كما "شَوقي" و"أمير"، أنَّه مُغلَّف صُورٍ وأوراقٍ ورسائل احتفظَ بها "ناجي"، وهي تتعلَّق بشمسٍ وبجانبٍ أو آخَرَ من جَوانبِ التَّجاربِ التي انخرطتْ في خَوضها بِمشاركَة آخرين عديدينَ، يكونُ هذا المُغَلَّف قد تَحوَّل إلى مَكنَزِ مُحفِّزاتٍ لانطلاق السَّرد الرِّوائيِّ، فيما تكُونُ الشُّرفَة الكائنة في "بيت أمير"، في نيقوسيا، قد صارت إطاراً مكانيَّاً لانْطِلاقِه، والمساءُ النِّيقُوسيُّ الحارُّ حيَّزاً زمانيَّاً لصيرورته وتَوالي انبثاقاتِه، بينما يكونُ أربَعَة الحاضرين الآنَ في الشُّرفَة، في ذلكَ المساءِ غير المُحَدَّد توقيتُهُ بِدقَّةٍ، وهُم: "ناجي"، و"شوقي" و"يُونس"، ومُسْتَضِيْفُهم "أمير"، أربِعَة شخضيَّاتٍ روائيَّةٍ تَتهيَّأُ لِسُكْنى "بيتَ الرِّوايَة" الجاري بناؤهُ، فيما هي مُرشَّحة، بالتَّالي، لتولِّى هذا الحيِّز أو ذَاكَ الحيِّزِ من مساراتِ السِّردِ الروائيِّ القابِل، بطبيعَة المبنى الروائي البانوراميِّ المُتَشَعِّبِ، لتوظيفِ أسلوبِ تعدُد الأصوات وتنويع منظورات الرُّؤيَة، أو لأنْ تكونُ مُرشَّحةً، على الأقلِ، لإطلاقِ أسئلَةٍ واستفساراتٍ وتعقيبات وتعليقاتٍ تُحفِّزُ تدفُّقَ السَّرد، أو تُؤَجِّلُهُ تدفُّقَ صيرورتِه قليلاً أو كثيراً، أو تُجلِّي ما غَمُضَ منْه، أو تُفسِّرُ أمراً أو آخرَ تطرَّقَ السَّردُ إليه، أو تتبصَّرُ في أيٍّ من مُحتَوياتِه على نحوٍ وامضٍ، أو على نحوٍ مُوَسَّعٍ، بدرجَةٍ أو بأُخرى.
وهكذا نَكُونُ إزاءَ احتمالِ أنْ نُصغي، كَقُرَّاءَ سامعينَ، إلى صَوت سَاردٍ، يُصْغيِ إليه معنا، دائماً وفي كُلِّ وقتٍ وحالٍ، ثلاثٌ من شخصيَّاتِ الرِّوايَة، بحيثُ تَتولَّدُ فَرضيَّة أنْ تكونَ الرِّوايَة بأكملها، أو في مقاطِع متعيَّنة منها، مولونوجاً سردِيَّاً دراميَّاً أو عدَّة مونُولوجاتٍ سَرديَّةٍ دراميَّة، تتداخَلُ وتتفاعَلُ وتتبادلُ الانعكاسَ، والتَّأثُّر والتَّأثيرَ، والتَّرائي. ولعلَّنا نذهَبُ، الآنَ، إلى افتراضِ أنْ يتطابَقُ زمنُ السَّردِ، مع زمنِ الإصغاء إليه، وبالتَّالي مع المُعَدَّل الزَّمني الذي تتطلَّبُه قراءة روايةٍ بلغَ عددُ صَفحاتِهَا أربعمائةٍ وأربعينَ صَفْحة.
ولئن كانَ هذا التَّطابُقُ الزَّمنيِّ مُمْكِناً، وقابلاً للتَّجلي في هذه الرِّواية، وهو الأمرُ الجَماليُّ الذي سنسعى إلى تَبيُّنِ أمداء حُضُوره وكيفيَّاتِ وآليَّاتٍ تَحقُّقِه فيها، كما سنسعى إلى تبيُّنِ أمداء تَعدُّد الأصوات السَّاردةِ، وتغاير السَّاردينَ، وكيفيَّاتِ وآليَّاتِ تحقُّقِهما، فإنَّ أمرَ تَطابُق زمن السَّرد مع زمن الحكاية، أو أزمنَة الحكايات، التي ستأتينا محمولَة عليه، لنْ يَكونَ مُتطابقاً بطبيعَة الحالِ، وبأيِّ حالٍ، فالزَّمنُ الذي يُغطِّيه السَّردُ الروائيُّ المُكثَّفُ في بضعَة أعوامٍ، ورُبَّما في أشهرٍ تتوزَّعُ بين العامين 1981 و1982، سيخترقُ أزمنَةً قدْ تربُو على أربِعَة عُقودٍ من الزَّمانِ، وذلِكَ في سياقِ سعي الرِّواية إلى تبيُّن خلفياتِ شخصيَّاتها والظُّروف التي أحاطت بميلاد بعضهم ونشأتِهِ، والشُّروط الحياتيَّة والوجوديَّة التي أحاطت بِه وأمْلتْ عليه، أو عليها، ضرورات حياةٍ وتحدِّياتِ وُجودٍ استوجبت إقدامه، أو إقدامَها، على تبنِّي هذا الشكل، أو ذاك، من أشكال السًّلوكِ، والاستجابَات الواعيَة، أو الشَّرْطِيَّة غير الواعية، إليها.
وتقيُّداً بالحيِّز النَّصيِّ المُتاحِ للنَّشْرِ، سَنَتَوقَّفُ، الآن، لُنَتابِعَ تَبَصُّراتنا التَّحليليَّة، الرؤيويَّة والجماليَّة، في هذه الرواية اللافِتَة، على مدى أقسامٍ لاحقَةٍ، سُنتابِعُ نشرها في أعدادِ مجلَّة "الهدف" المرموقَة، وسيَكونُ لمُعطياتِ التَّحليل النَّصِّي المصحوبِ بِمقارباتٍ نَقْدِيَّة مُتعدِّدة المداخِلِ، أنْ تُحدِّد موضوعاتِ الأقسام اللاحقِة، وعناوينها الرئيسة.
هوامش وإشارات:
(1) توفيق وصفي: مَوَّالُ شَمس، مكتبة كُل شيء، حيفا، الطَّبْعة الأولى، 2019.
(2) المصدر نفسه، ص 12.
(3) المصدر نفسه، والصَّفحة نفسها.
(4) أُنْظُرْ في ذلك، جورج لوكاش: الرِّوايَةُ كملحمة برجوازيَّة، ترجَمة: جُورج طرابيشي، دار الطَّليْعة، بيروت، الطِّبْعة الأولى، 1979.
(5) مَوَّالُ شمس، ص 17.
(6) المصدر نفسه، والصَّفحة نفسها.
(7؛ 8؛ 9؛ 10؛ 11؛ 12؛ 13) المصدر نفسُه، ص 18.
(14) المصدر السابِق، ص 19.