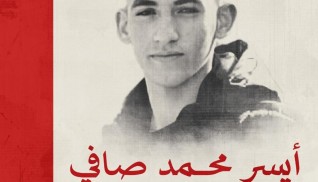شهد العالم العربي مؤخراً حركة احتجاج واسعة سلمية ومدنية من حيث التوجه، والأهداف، والممارسة، وعبثاً حاولت جهات مختلفة جرّها إلى العنف، وظلّت متمسّكة بسلميّتها التي هي أساس شرعيّتها، وهكذا تمكنت من الإطاحة بالرئيس السودان ي عمر حسن البشير، واضطرّ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى الإقلاع عن الترشح لدورة خامسة، كما استجاب لها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بتقديم استقالته، وأُجبرت حكومة عادل عبدالمهدي على تقديم استقالتها.
وفي كل التجارب التاريخية، فإن حركات التغيير تفجّر معها جميع التناقضات الإيجابية، والسلبية، سواء أحدثت التغيير المنشود، أم لم تحدثه، الأمر الذي يثير صراعات جديدة في المستقبل، علماً بأن التغييرات لا تتحقّق دفعة واحدة، ولا تأتي ناجزة، أو كاملة، أو نهائية، بل متدرجة وتراكمية، وستواجهها عند كل منعطف تدافعاً ومطاولة، بين من يريد إبقاء القديم على قدمه، وبين قوى التغيير ذاتها التي سينفجر الصراع داخلها أيضاً، بحكم تعارض المصالح، ومحاولة كل فريق الاستحواذ على أكبر قدر من النفوذ، والامتيازات للهيمنة.
ومن دون تفاؤل مُفرط، أو تشاؤم مُحبط، لابدّ من الإشارة إلى أن حركات التغيير ليست هندسة منجزة، أو رسماً بيانياً جاهزاً، أو خريطة طريق ذات خطوط مستقيمة، كما أنها ليست وصفة سحرية لأمراضنا الاجتماعية من دون منغصات، أو أخطاء، أو حتى خطايا، إنها مثل كل عمل بشري معرّضة للنقد، والمراجعة، والتقصير، لاسيّما إذا لجأت إلى العنف، أو مارسته كردّ فعل على ما تمارسه السلطات بحقها.
ويمكن القول إن حركة التغيير هي جزء من قانون التطور التاريخي، الذي لن يحدث من دون تراكمات، وهي حتى إن بدت مفاجئة، إلّا أنّ ثمة أسباباً موضوعية وذاتية ضرورية لاندلاعها، وباستعادة مفهوم الانتفاضة في «الأدب الماركسي»، فهي ظاهرة خصوصية في كل مجتمع مع ما يمكن أن تفعله القوانين العامة، إذْ لا توجد صيغة جاهزة يمكن اقتباسها، أو تقليدها، أو نسخها، لأنها تختلف من مجتمع إلى آخر باختلاف درجة تطوره التاريخي بطبقاته، وأديانه، وقومياته، ولغاته، وهوّياته الثقافية المتعددة.
لقد حار البعض في تفسير انطلاق حركة الاحتجاج، وبهذا الحجم، والاتساع، والامتداد، فلم تسعفه الدعاوى الأيديولوجية من عدم وجود حامل اجتماعي، أو قيادة معلومة للحركة محاولاً قياسها بمسطرة قديمة، لم تعد تصلح لعصر العولمة، واستسهل البعض الآخر اتهامها بالخضوع لتعليمات قوى مريبة وتدخلات خارجية، وهي موجودة بالفعل، بل وحاضرة عند كل متغيّر، تستطيع أن تحشر نفسها فيه سريعاً.
وثمة خصائص مشتركة في حركة الاحتجاج الجديدة، وهي علنيتها، وعمومية شعاراتها، وتشبّثها بهويّتها الوطنية، واستخدامها شبكة التواصل الاجتماعي، فلم يكن لها «عرّاب واحد»، أو «أب قائد»، أو «زعيم ملهم»، ولا حتى وجود«حزب ثوري» يقودها، وليس هناك «نظرية ثورية» كمرشد للعمل، كما يقال عادة بالنسبة للثورات، فقد رفضت الشابات والشبان «قفص الدجاج» الذي وُضعوا فيه سنوات تحت تأثير تخديرات الأيديولوجيا الغيبية، وغير الغيبية، وادعاء امتلاك الحقيقة، والزعم بالأفضلية وتقديم ذريعة الأمن على الكرامة، وكل هذه العوامل قادت إلى نضوج «اللحظة الثورية» بارتفاع نبض الوعي الوطني، واليقظة الإنسانية، والتشبث بفكرة المواطنة، مع ميزة مذهلة هي قدرة الشابات والشبان على التمسك بسلمية الحركة، ولا عنفيتها بصورة واقعية فائقة، بحيث أصبحت حركة احتجاجهم «قوة ناعمة» جبارة وعقلانية،حتى إنْ كانت تذكّر بعصر المداخن إبان الثورة الصناعية.
ولعل قول جرامشي «القديم يحتضر والجديد لم يولد بعد»، هو ما ينطبق على تجارب التغيير جميعها تلك التي عانت، وتعاني طول الانتظار وعسر الولادة، وأحياناً عدم اكتمال المولود بسبب ثقل الماضي، وامتداداته، وتأثيرات القوى المخلوعة، أو التي يُراد خلعها، لكن التغيير إذا ما بدأ فلا يمكن وقف قطاره، حتى إن انحرف، أو تعثّر، أو تأخر، أو تلكأ بفعل القوى المضادة، وهو ما توضحه التجربة التاريخية بحكم وجود بيئة مشجعة له داخلياً وخارجياً، فضلاً عن مشاركة وازنة من المرأة ودور متميّز لمؤسسات المجتمع المدني، والتساوق مع روح العصر، وحتى لو كان الطريق وعراً ومنعرجاته كثيرة، فإن بقاء الأوضاع على ما هي عليه أصبح مستحيلاً، مثلما هي العودة إلى الماضي، والأمر له علاقة بإحياء الهوية الثقافية والمعرفية لدى المحتجين الذين شعارهم بشكل عام «نريد وطناً».