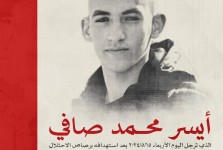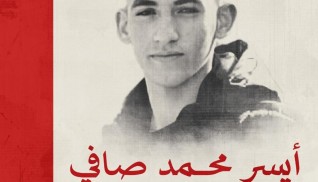كاتبٌ سياسيٌّ فلسطينيّ
إدارةُ الرئيسِ السابقِ ترامب، كانت قد أعلنت أنّها ستنهي حروبَ أمريكا المكلفة. وفي شباط ٢٠٢٠؛ بدأت إدارة ترامب محادثاتٍ مع ممثلي طالبان في الدوحة لترتيب اتّفاقٍ أمريكي – طالباني؛ يُمَهِّدُ لانسحابِ القوات الأمريكية من أفغانستان التي خاضتها، كأطول غزواتها في تاريخها.
للتذكير، إنّ قرار غزو أفغانستان كان قرارًا أمريكيًّا - بريطانيًّا من خارج مؤسسات الشرعيّة الدوليّة، وللتذكير أيضًا، إنّ الولايات المتّحدة وإدارتها الجمهورية (إدارة بوش الابن) لم يكن لها أية مشكلةٍ مع نظام طالبان قبل عام ٢٠٠١، إلا ما ارتبط بوجود "أسامة بن لادن" وإقامته؛ المتّهم الرئيسي في الهجمات على سفاراتها، وبشكلٍ خاصٍّ، هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١.
عندما رفضت طالبان تسليم أسامة بن لادن أو حتى الطلب منه مغادرة أفغانستان؛ كان سببًا مباشرًا للغزو الأمريكي – البريطاني، هذا الغزو الذي كلّف الإدارة الأمريكية؛ حسبَ مصادرَ رسميّةٍ أمريكيّة ٧٧٨ مليار دولار من الإنفاق العسكري، و ٤٤ مليار من الإنفاق على مشاريع الإعمار عن طريق وزارة الخارجيّة الأمريكيّة، وهذا يعني أن مجمل ما أنفقته الإدارة الأمريكيّة ٨٢٢ مليار دولار، وإذا ما أضفنا لها نفقات بريطانيا ٤٠ مليار، وألمانيا ١٩ مليار... وغيرهم من الدول المشاركة، فإن الرقم سيتخطّى الترليون. أما الكلفة البشرية؛ فكانت على النحو التالي: ٣٥٠٠ قتيلٍ للتحالف، منهم ٢٣٠٠ جندي أمريكي، و٤٥٠ بريطانيًّا. وتتوزّع البقية على التحالف والمتعاقدين، أما عن الإصابات، فقد تجاوزت ٢٠٦ آلاف جندي أمريكي، هذه الأرقام حسب ما ورد في تقارير ال ( BBC). أما عن الخسائر في الجنود والشرطة الأفغانية، فقد صرح الرئيس الأفغاني أشرف غني؛ بأنّ أكثرَ من ٤٥ ألفَ جنديٍّ وشرطي أفغاني؛ قُتلوا منذ أن وصل إلى الحكم عام ٢٠١٤، وحسب بحثٍ لجامعة براون ٢٠١٩، فإن الجيش والشرطة الأفغانية؛ خسرا منذ بداية غزو أفغانستان ٢٠٠١ أكثر من ٦٤ ألفًا.
الأسئلةُ الملحّةُ التي تفرضُ نفسَها:
١. ما الذي جرى بين الإدارة الأمريكية - وطالبان في محادثات الدوحة التي أفضت إلى الاتفاق على الانسحاب الأمريكي؟
٢. ظهور طالبان، وسرعة حركتها اللوجستية على الأرض يفرض سؤالا ملحًّا: من المموّل والداعم لها طيلة ٢٠ عامًا؟ وما عدد مقاتلي طالبان حتى يتمكنوا من فرض السيطرة على مساحة أفغانستان؟
٣. الاختفاء السريع لــ ٣٠٠ ألف جندي أفغاني يعيد إلى الأذهان؛ اختفاء وحدات الجيش العراقي بعد الوصول إلى حدود بغداد - هذا يطرح سؤالًا: ما الأسبابُ التي دفعت الجيش الأفغاني وشرطته لعدم القتال والدفاع عن نظام كابول؟
٤. ما دورُ الدوحة في استضافة قادة طالبان على مدى ٢٠ عامًا؟
قبل الإجابة عن الأسئلة؛ لا بد من الإشارة إلى التدخل العسكري للاتحاد السوفييتي الذي كان بناءً على طلب الحكومة اليسارية الأفغانية التي كان يقودها حزب الشعب الديمقراطي، هذا التدخل الذي حُرّض عليه من قبلِ إدارة جيمي كارتر، الذي وقع في ٣ يوليو ١٩٧٩، توجيهًا بدعمٍ إعلاميٍّ ضد الحكومة الثورية لحزب الشعب الأفغاني، والتدخل السوفييتي (من مذكرات روبرت غيتس _ في الظلال).
استثمرت الإدارة الأمريكية في المعارضة الإسلامية في أفغانستان، وجعلت من عنوان الجهاد ضد الكفر أرضيةً لعاملٍ مشتركٍ لتلاقي الاتجاهات الإسلامية كافةً؛ من أجل العمل على تجميع المقاتلين الإسلاميين من أنحاء العالم كافةً وإرسالهم؛ بتمويلٍ سعوديٍّ، ودعمٍ باكستانيٍّ، وغطاءٍ أمريكي.
أصبحت أفغانستان؛ خزّانًا بشريًّا للمقاتلين الجهاديين الأجانب، وبنى تنظيمُ القاعدة قاعدتَه الرئيسية في أفغانستان، وكان أسامة بن لادن؛ يشكّل مرجعًا عقائديًّا للمجاهدين الأفغان والعرب قبلَ ظهور حركة طالبان، التي أُنشئت بدعمٍ من المخابرات الباكستانيّة والسعوديّة، وبرعايةٍ أمريكية. إن القاعدة الاجتماعية لطالبان هي: قبائل البشتون الممتدة ما بين أفغانستان وباكستان و إيران وإقليم البنجاب، حيث يشكّل البشتون ما يقارب ٣٨% من الأفغان الــ40 مليونًا.
ما بين انسحاب القوات السوفييتيّة من أفغانستان، وظهور طالبان عام ١٩٩٤؛ عاشت أفغانستان حروبًا بين الفصائل المتنازعة على السلطة السياسية، حتى حسم الصراع القائد الطاجكي أحمد شاه مسعود، الذي خاض صراعًا مع القائد حكمتيار المدعوم من أسامة بن لادن، وانتصروا عليه بمساعدة حركة طالبان التي استولت على كابول من ١٩٩٦ حتى ٢٠٠١. دائمًا كان النزاع على السلطة في أفغانستان؛ يحمل طابعًا قبليًّا قوميًّا بمسحةٍ دينيةٍ، ومؤشره الرئيسي كان دائمًا بين الطاجيك والبشتون.
لقد كانت ولادة طالبان نتيجةً لتوافق باكستاني – سعودي؛ بغطاءٍ أمريكي -كما سبق القول- وكانت بنيتها المعرفية متأثرةً بالعلاقة القوية بين المُلّا عمر وأسامة بن لادن، هذه العلاقة التي أنتجت مزيجًا بين الأصوليّة الإسلامية (الإخوانية) والوهابية التي انعكست في العلاقة التحالفيّة بين حركة طالبان والقاعدة.
إنّ الموقف الباكستاني من طالبان كان دائمًا متوافقًا عليه داخليًّا ومرتبطًا بالصراع الباكستاني- الهندي، في حين دفع تطور العلاقة الأمريكية – الهندية؛ باكستان تجاه توطيد العلاقة مع الصين؛ وفي الوقت ذاته كانت تدعم مقاومة طالبان في الداخل الأفغاني، حيث نظرت باكستان إلى إعلان الانسحاب الأمريكي من أفغانستان أنه فرصةٌ لعودة النفوذ الباكستاني لإنهاء النفوذ الهندي في أفغانستان .
باكستان شجّعت طالبان على قَبول دخول الحوار مع الولايات المتحدة، والظهور بحلّةٍ جديدة؛ تمكنها من إقناع الأمريكيين أن طالبان ٢٠٢١، ليست طالبان ١٩٩٦، لكن يبقى الخطأ التكتيكيّ الأمريكي؛ هو الاتّفاق المعقود مع طالبان، بعيدًا عن حكومة كابول؛ القاضي بعدم التعرّض للقوّات الأمريكيّة أثناء الانسحاب، وهذا ما يلاحظه أيّ مراقب. أما ما تعلّق في الوضع الداخلي؛ فلم تُلزَم طالبان بأيّة اتفاقيّةٍ موقّعة؛ بضماناتٍ باكستانيّةٍ أو قطر يّةٍ لشكل النظام الجديد بأفغانستان.
مع بَدْءِ انسحاب القوات الأمريكية كانت طالبان، قد بدأت حركتها للسيطرة على المنافذ الحدوديّة، في إشارةٍ فُهمت من أنصار حكومة كابول على أنّها تمّت باتّفاقٍ من خلف ظهر نظام كابول، الذي تُرك وحيدًا دون أيّ غطاءٍ لمواجهة تقدّم طالبان المدعومة باكستانيًّا. إنّ سرعة تفكّك الجيش الأفغاني يعطي مؤشّرًا على أن أفراده وقادته لا يريدون الدفاع عن نظامٍ فُرض بصيغةٍ فوقيّةٍ، ولا يعكس توازن القوى الاجتماعية (القبلية)، ناهيك عن شعورهم بالإهانة عندما لم تشركهم الإدارة الأمريكية الترامبية في المحادثات الثنائيّة، وطلبت منها الحوار مع حركة طالبان بعد أن أنجزت اتفاقها معها .
تصريحات الCIA التي أفادت أن طالبان ستصل كابول خلال ٩٠ يومًا؛ فُهمت من قبل طالبان على أنّ الطريقَ مفتوحٌ لكابول، في حين فهمها نظامُ كابول على أن هنالك ضوءًا أخضرَ أمريكي لطالبان لدخول كابول، وهذا سرّع من انهيار منظومة النظام، وهروب الرئيس أشرف غني الذي فهم الرسالة جيّدًا.
طالبان كانت تسعى لهذا المشهد الدرامي للانسحاب الأمريكي، لتعطي دفعةَ ثقةٍ لحواضنها، وتعود للسلطة من موقع المنتصر، وليس من موقع المساومة والتقاسم مع ممثلي النظام المدعوم أمريكيًّا. فبالرغم من أن طالبان تسعى للظهور بحلّةٍ جديدة، لكن الواقع يقول: أن طالبان سوف تواجه أزمة إدارة النظام الذي سيعكس التناقض بين بنيتها المعرفية، وبين متطلبات إدارة الدولة والمجتمع وقيادتهما؛ فطالبان، كسائرِ القوى الدينية التي تقوم فلسفتها على أساس صياغة الواقع، بناءً على متطلبات النصّ الديني، ونمط التفكير هذا سيفرض علاقةً تناقضيّةً بين متطلبات النص، ومتطلّبات الواقع الإنساني وحاجيّاته، من حريةٍ وعدالةٍ ومشاركة. وفي هذا السياق؛ تطرح عناوين وأسئلة، مثل: حرية المرأة وحقها في التعليم والعمل وحرية خياراتها، وكذلك بالنسبة للأطفال والمناهج الدراسيّة، التي ستقررها حركة طالبان وعلاقاتها مع القوى والفئات الاجتماعية الأخرى.
المشكلة الأخرى؛ أن طالبان ليس لديها الخبرات والكفاءات لقيادة الدولة ومؤسساتها المدنيّة واللوجستيّة العسكريّة، وهي ستسعى للطلب من كوادر النظام القديم أن يقوموا بالمهمّة.
الملاحظ أن طالبان أرسلت إشاراتِ حسنِ نيّةٍ لجيرانها، هذا فُهم في واشنطن على أن طالبان لن تكون أداةً أمريكيّةً لمواجهة كلٍّ من: الصين، وروسيا وإيران، وهذا ما ستدعمه باكستان التي تنظر بريبةٍ لتطور العلاقة الهندية – الأمريكية.
طالبان بنسختها ٢٠٢١؛ تعمل في ظروفٍ مختلفةٍ عن (١٩٩٦-٢٠٠١)؛ فالعلاقة الأمريكيّة – الباكستانيّة، ليست على ما يرام، وكذلك السعوديّة – الباكستانيّة. أما قطر؛ فعلى ما يبدو أنها قد بلعت طعمَ طالبان الذي أربك موقفها وحركتها، وصرّح وزير خارجيتها أن سلوك وأفعال طالبان هي التي ستحدد الموقف منها.
المعضلة التي ستواجه طالبان هي الصراع الداخلي الذي سينشأ حولَ النصّ الدينيّ وتطبيقاته العمليّة، وهنا ستظهر الاتجاهات المتعارضة حولَ فهم تطبيقات النصّ الديني، وانعكاسه في منظومة القوانين المدنيّة التي يتعارض أغلبها مع بنية طالبان المعرفية، هذا من جهةٍ. أما من جهةٍ أخرى، فسيكون النصّ الدينيّ خلافًا مع الاتجاهات القاعديّة والداعشيّة التي تنظر للصراع على أنه صراعٌ شمولي، وما التحذيرات من هجومٍ لداعش على محيط المطار، إلا إشارة للدعوة لها لممارسة نشاطها في أفغانستان.
أفغانستان لن تهدأ، وستشهد مزيدًا من الصراع المركّب؛ داخليًّا وخارجيًّا .