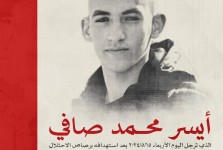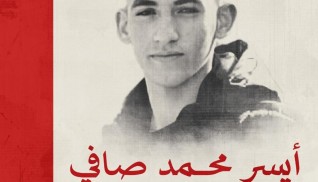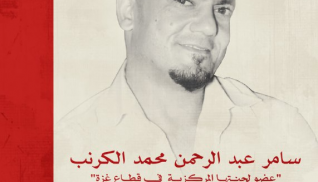يسعدني أن أستجيبَ لدعوةِ الرفيقاتِ والرفاقِ في هيئةِ تحريرِ الهدف؛ للمساهمةِ في موضوعِ الطائفيّة والطوائف، من خلال تناول العوامل الداخلية والخارجية لهذه الظاهرة في العالم العربي؛ تكمن أهميّةُ الموضوع إلى جانب بُعدِهِ التاريخي، في راهنيّته بعد الموجة الجديدة من السيرورات الثورية التي عاشتها شعوبُنا مع نهاية سنة 2010. لم يعد من المقبول تجاهلُ أو تغييبُ طرحِ موضوعِ الطائفية وقضايا الأقليّات عند كلِّ صياغةٍ جديدةٍ لمعادلة التغيير الثوري بمنطقتنا، وهذا ما سنحاول تناوله باقتضابٍ شديدٍ احترامًا للحيّز المتاح في الملف بالمجلّة.
ارتبط الاهتمامُ البالغُ بموضوع الطوائف وتعبيراتها الفكريّة والسياسيّة المشمولة فيما نسمّيه بالطائفيّة مع تشكّل الدولة المركزيّة، أو القوميّة، المنبثقة عن مرحلة الاستعمار المباشر. غنيٌّ عن القول: إنّ التدخل الاستعماري، أو التوسّع الإمبريالي في العديد من المناطق من العالم استعمل الطوائف والأقليّات بشكلٍ عامٍّ، "كحصان طروادة"؛ لتسهيل سيطرته. وتشمل الطوائف المعنية هنا، كل الطوائف الدينية أو العرقية/ الإثنية أو اللغوية والثقافية. ومن جهةٍ أخرى، يلاحظ المهتمون بأن استعمال الطائفية لم يخضع لنموذج تدخُّلٍ واحد، بل تم اعتماد نماذجَ متنوعةٍ تفرضها طبيعةُ الوضع القائم في كلّ حالةٍ لخدمة المصالح الاستعمارية المباشرة؛ فعندما كانت تقتضي تلك المصالحُ تأجيجَ تناقضات الطوائف، وتسعيرَ الطائفية من أجل تسهيل الهيمنة والسيطرة العسكرية، كانت الإمبريالية توظّف ترسانتها الاستخباراتية والأكاديمية والبعثات الاستكشافية لزرع الفتنة، أو إشعال فتيل الاقتتال الطائفي، وفي حالةٍ أخرى، إذا كانت المصالح الاستعمارية تقتضي إقامةَ السوق الواسعة، وإخضاعَ المناطق الشاسعة، فإنّ القوى الاستعمارية كانت تقمع الطوائف وتقتل روحها... وفي حالاتٍ أخرى تمت المزاوجة بين الخطتين سالفتي الذكر.
بشكلٍ عام؛ يمكننا القول، ودونَ أن نجانبَ الصواب: إنّ استعمال الطائفية وتأجيج تناقضات الطوائف عرف تطورًا نوعيًّا مع هيمنة الدول الرأسمالية على العلاقات التجارية العالمية، وبلغ مستوى غيرَ مسبوقٍ مع دخول الرأسمالية إلى المرحلة الإمبريالية؛ هذا ما تجلّى في استعمال العنف ضدّ الشعوب، متمثّلًا: في الاستعمار المباشر، وحتى الاستيطان للعديد من البلدان عبر العالم. لقد تم تدمير البنيات الاقتصادية والاجتماعية، أي أنماط الإنتاج ما قبل الرأسمالية السائدة في تلك البلدان، وتم تعويضها باستنبات نمط إنتاجٍ جديدٍ هجينٍ نسمّيه نمطَ إنتاج الرأسمالية التبعيّة. كان من نتائج هذا التدخل العنيف، إجهاضُ النمو والتطور الطبيعي لقوى الإنتاج التي كانت تشكل الأساس المادي لأنماط الإنتاج ما قبل الرأسمالية، ودمّروا معه علاقات الإنتاج وكل البنية الفوقية السائدة آنذاك.
في هذا الإطار، فإن منطقتنا تعرضت بدورها إلى نصيبها من التدخّل العنيف، استهدف مؤسّسة القبيلة (وفي بعض البلدان العشيرة). لقد خضع المجتمع القبلي لعملية تدميرٍ ومحاولةِ اجتثاثٍ غيرِ طبيعيّةٍ طالت بنيتَهُ الفوقية، وشكلَ تنظيم السلطة التي كانت تحملها القبيلة، وعُوِّضتْ ببنيةٍ جديدةٍ عبارةً عن أنوية الدولة المركزية، كدولةٍ ترعى مصالح كتلة "طبقات" أو فئات اجتماعية مرتبطة المصالح مع الاستعمار المباشر. على أنقاض التشكيلات الاجتماعية القديمة؛ قامت تشكيلاتٌ اجتماعيّةٌ جديدةٌ مختلقة، وكأنّها خرجت من العدم، ولأنّ عوامل المجتمع القديم لم تتح لها إمكانيّة النضوج والتطور الطبيعي، ولم يخرج المجتمع الجديد من أحشاء القديم، فإنّ كلَّ مكونات نمط الإنتاج ما قبل الرأسمالي التي كُبح تطورُها الطبيعي؛ بقيت مطمورةً تحت الأنقاض، خاصّةً منها: القبيلة، وبنيتها، وذهنيتها، وتناقضاتها، وأيضًا كلّ ما يتعلّق بالتناقضات الإثنية، أو العرقية، وبالإرث الثقافي واللغوي، وفي بعض الحالات: الجانب الديني والمعتقدات، أي بالمجمل ما يمكننا اعتباره خصوصيّات من صميم هذه التشكيلات الاجتماعيّة القديمة أو المطمورة.
من أجل معالجةٍ سديدةٍ لقضية الأقليّات والخصوصيّات
استعملت الإمبريالية من أجل سيطرتها إلى جانب العنف والحروب الاستعمارية كلَّ الوسائل بما فيها: قضايا الطوائف، أو عوامل الخصوصيّات، وفي مراحلَ معينةٍ، في بعض المناطق، عملت هذه القوى الغاصبةُ على خلق عواملِ التفرقةِ والمنازعات واستنباتها، ومنها، على سبيل المثال: وضع حدود تمزّق أوصال العائلة الواحدة، فما بالك القبيلة، أو العشيرة؟
إنّ الوضع الراهن لجميع الشعوب التي خضعت للاستعمار المباشر أو غير المباشر، يتّسم بوجود حالةِ تفتيتٍ وتصدعٍ تضرب في العمق كلَّ مقومات الوحدة الديمقراطية والطوعيّة لهذهِ الشعوب. لقد زرعت في أحضانها قنابلَ الفتنة والتشظي التي تهدد بالانفجار كلما دعت مصالح الإمبريالية وعملائها إلى ذلك، هذا ما عايشه العديدُ من القوى الثوريّة، لمّا عزمت على إطلاق شرارة الثورة التحرريّة من قبضة الإمبريالية ووكلائها.
فما العملُ من أجل معالجة قضايا الأقليّات والخصوصيات؟
عند الجواب على هذا السؤال ينتصب أمامنا توجّهان رئيسيّان:
التوجّه الأول، ويمكننا اعتباره استئصاليًّا لا يعترف بالأقليّات، أو بالخصوصيّات. يرى أصحاب هذا التوجّه مصلحة كلّ مكونات شعبهم تخضع لقرارهم، وهم من يمثّلون جميع مكونات الشعب، وينطقون باسمها، وهذا التوجّه يُعطي نفسَهُ حقَّ الإنابة عن الشعب، وتعويضه في القيام بما يعدُّهُ نضالًا وكفاحًا ضدَّ الاستعمار ووكلائه. واستطاع هذا التوجّه أن يفرض سلطته وأن "يوحّد" كل المكونات تحت قبضته. لكن اتّضح فيما بعد، أن تلك الوحدة كانت شكليةً، وأن التناقضات والخصوصيات بقيت تنخر المجتمع، وهي ما اعتمدتها القوى الإمبريالية والصهيونية في تفتيت تلك المجتمعات، وضرب وحدتها في مقتل، وهذا ما تشهد عليه حالة السودان والعراق وليبيا. ازداد هذا التوظيف للتناقضات الداخلية في فترة السيرورات الثوريّة التي شهدتها شعوب منطقتنا بعد 2010. لقد أدركت القوى الرجعية، ومعها حماتُها الإمبرياليون والصهاينة، بأن هذه السيرورة الثورية تختلف عن التجارِب السابقة؛ لأنّها اندلعت بعد أن تأكّد لجميع شعوبنا أنّ معارك الاستقلال والتحرر الوطني قد أُجهضت، وأنّ الأنظمة القائمة لا تعدو عن كونها عميلةً، وتخدم مصالح الاستعمار غيرِ المباشر، وبأن موعد استكمال معارك التحرر قد أزفَ ولم يعد هناك مجال للانتظار أو الصبر.
أما التوجّه الثاني في معالجة قضية الأقليات والخصوصيات؛ فهو الذي يعدّ أن الثورة اليوم تتخذ طابعًا طبقيًّا ووطنيًّا، أي أنّ للثورة بعدين يتفاعلان جدليًّا، ولم يعد من الممكن حصرُها في بُعدٍ وحيد. إنّ مسألة البعد المتعلّق بوجود الأقليّات في المجتمع، وما يترتّب عليه من حقوقٍ أساسيّة لا يمكن طمرُهُ أو استبعادُهُ من برنامج الثورة وأهدافها.
يعدّ أصحاب هذا التوجه هذه الأقليات وقضية الخصوصيات ذات مفعولٍ متناقض: من جهةٍ، يمكنها أن تكون عاملَ قوةٍ، ومهماز إشعال الثورة والتقدم بها خطوات، ومن جهةٍ أخرى، يمكنها أن تكون عاملَ تشتيتِ الصفوف وتمزيقها، ومدخلًا لقتل روح الثورة في المجتمع برمته. إن إدراك هذه الحقيقة هو ما يميز هذا التوجه النضالي عن التوجه الاستئصالي الأول.
لم تعد قضيّةُ الوحدة النضاليّة للشعوب مقتصرةً على تأجيج مشاعر السخط على العدو، فهي تتطلّب أيضًا، معالجةَ التناقضات الثانوية والداخلية لتلك الشعوب معالجةً ديمقراطيّةً، تعبر فيها الأقليّاتُ وأصحابُ الحقوق الخاصة، الثقافية أو اللغوية أو الإثنية عن مواقفها، وتعقد التحالفات الاستراتيجية لتلبية تلك الحقوق ولحل تلك التناقضات، ومثل هذه الاتفاقيات الاستراتيجية، تصبح هي الخط الاستراتيجي الذي تقوم على أساسه الثورة والتغيير المنشود.
تجدر الإشارة إلى كون هذا التوجه الثاني يتشكل بدوره من مرجعياتٍ وحساسياتٍ مختلفةٍ، مع العلم بوجود مكونٍ رئيسي له مرجعيةٌ فكريةٌ وأيديولوجيةٌ وسياسيةٌ توحّد جدليًّا النضال الطبقي بالنضال الوطني؛ وهي مرجعيةٌ تعدّ الثورة من صنع الطبقات الاجتماعية التي لها مصلحةٌ في القضاء على الاستغلال، وبناء اقتصادٍ متحرّرٍ من القبضة الإمبريالية. ومن خلال التجارِب العالمية ذات الصلة بالموضوع، ومن أجل اكتساب الدروس ومراكمة عوامل النجاح والانتصار لهذه الثورات؛ لا بدّ من تحصين كل العملية الثورية، وذلك بتحمل مسؤولية القيادة، والتوجيه إلى الطبقة الاجتماعية التي لا يمكنها أن تتحرّر إلا بتحرّر المجتمع برمته، وهي الطبقة العاملة. وتؤكد دروس التجارِب التاريخية أيضًا، بأن الطبقة العاملة بقيادة حزبها المستقل قادرةٌ على عقد التحالف الاستراتيجي مع الفلاحين الفقراء والمعدمين، ومع كادحي المدن عبر بناء جبهة الطبقات الشعبية الأساسية؛ لقيادة خوض معارك التغيير من أجل الدولة الوطنية الديمقراطية في أفق المجتمع الاشتراكي.