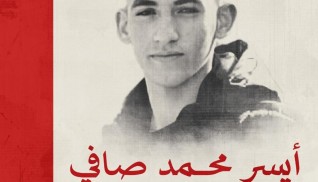(7-7)
عرض وتلخيص كتاب
(1876-1983)
(تأليف: باميلا آن سميث، ترجمة: إلهام بشارة خوري، دمشق – دار الحصاد للنشر – 1991)
القوميون العرب:
بينما كانت البرجوازية الفلسطينية في الضفة الغربية منهمكة في السعي من أجل تحقيق الإصلاح الديمقراطي في الأردن، شُغل فلسطينيون آخرون فيما أصبح لاحقاً حركات مهمة في التغيير السياسي في العالم العربي خلال سنوات الستينات. أهم هذه الحركات كانت: حزب البعث الاشتراكي وحركة القوميين العرب والناصريون. اعتنقت هذه الحركات مبادئ الوحدة العربية ومعاداة الإمبريالية والتغيير الاجتماعي. ولكن أيديولوجيات واستراتيجيات وتكتيكات هذه الحركات اختلفت، كما اختلفت القاعدة الاجتماعية التي دعمت كل منها.
البعثيون:
أسسه في أوائل الأربعينات معلمان تلقيا تعليمهما في باريس، وأسسا فروعاً له في لبنان و الأردن والعراق وسوريا بعد الحرب العالمية الثانية.
في الأردن جذب التزام الحزب بقضية الوحدة العربية والحرية والاشتراكية المثقفين الشباب، خصوصاً أساتذة المدارس والطلاب والبيروقراطيين الصغار. وتلقى الحزب دعماً فعالاً من آلاف اللاجئين الذين خرجوا إلى شوارع عمان لدعم مطالب الحزب بإنهاء وجود الإمبريالية البريطانية وتصفية جميع المشاريع الهادفة إلى دمج اللاجئين في المجتمعات المجاورة. في انتخابات عام 1950 البرلمانية حصل مرشح الحزب عبد الله نعواس من القدس على أكثر من 5000صوت، وحصل مرشح آخر للحزب هو عبد الله الريماوي، من رام الله، والذي كان يرأس تحرير جريدة الحزب على عدد كبير من الأصوات، إلا أن السلطات اعتقلتهما. أما في انتخابات عام 1956 فقد ارتفع عدد الأصوات التي نالها البعثيون إلى 34 ألف صوت، أي ما يكفي لاحتلال الحزب المركز الثالث في الانتخابات البرلمانية بعد الحزبين القومي الاشتراكي والشيوعي.
أدى سقوط حكومة النابلسي، وطلب الملك من بريطانيا إنزال قواتها في الأردن إلى انتهاء دور حزب البعث من على المسرح السياسي في الأردن. ولكن وعلى عكس الليبراليين المنحدرين من الأسر الثرية في الضفة الغربية، دفع زعماء حزب البعث وكادراته ثمناً باهظاً بسبب مواقفهم السياسية المعارضة، حيث تم اعتقال العشرات من مؤيدي الحزب أو طردهم من وظائفهم، هذا إضافة إلى إبعاد زعماء الحزب أنفسهم أو نفيهم إلى خارج البلاد.
هدد إصرار حزب البعث على إعادة السياسة الخارجية الأردنية إلى عدم الانحياز، وإلى دعم القومية العربية بالقضاء على القاعدة الاقتصادية للأرستقراطية الفلسطينية وتقليص الفوائد التي حصلت عليها هذه الطبقة من النظام الملكي. إضافة إلى ذلك فإن مطالبة الحزب بالاشتراكية قد تصادمت مع آمال الليبراليين لتوسيع الامتيازات التي حققتها البرجوازية الوطنية، والدور الكبير للاقتصاد الحر.
أخيراً هددت مطالبة الحزب بتسليح اللاجئين والسماح لهم بالعمل من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الأساس الذي قامت عليه المملكة، كما هددت تحالفها مع ملاك الأراضي الكبار والتجار في الضفة الغربية.
على الرغم من حظر الحزب في الأردن، وما كان يعنيه ذلك من تقلص قدرة الحزب على الجذب وقدرة أعضائه الفلسطينيين على تعبئة جماهير اللاجئين، إلا أنه استمر في استيعاب الفلسطينيين في أماكن أخرى من العالم العربي حيث كانت نسبة الفلسطينيين فيها عالية نسبياً. ركز الحزب خلال العشر سنوات التالية على بذل الجهود، من أجل تحقيق الوحدة العربية، أولاً عبر إقامة تحالف مع الرئيس جمال عبد الناصر.
حركة القوميون العرب وعبد الناصر:
أُسست حركة القوميين العرب أصلاً في الجامعة الأمريكية في بيروت في أوائل الخمسينات(*). ومثل حزب البعث تبنت قضايا الوحدة العربية ومعاداة الإمبريالية. انحدر معظم أعضائها من الشباب المثقفين في العالم العربي. ولكنها، خلافاً لحزب البعث تبنت قضية الإصلاح الاجتماعي وليس الاشتراكية الثورية. وبقيت، حتى تم تحولها إلى حزب ماركسي في أوائل الستينات، تحمل نظرة قاتمة عن الشيوعية. كانت حركة القوميين العرب، مقتدية بمثلها الأعلى وبطلها جمال عبد الناصر، تركز على الحاجة إلى التحديث والوحدة القومية. إضافة إلى ذلك، وخلافاً لحزب البعث، كانت حركة القوميين العرب تعمل بقيادة فلسطينية حيث كانت مسألة استعادة فلسطين بالنسبة لها في غاية الأهمية على الرغم من إيمان الحركة بأنه لا يمكن تحقيق ذلك دون القضاء على الإمبريالية والاستعمار الجديد في العالم العربي أولاً.
انذر تبني الحركة للأيديولوجية الماركسية ومبادئ الاشتراكية العلمية، في عام 1962، بانفصال الحركة عن الناصرية التي تبنتها في مرحلة تشكلها. وبعد نشوء تيار يساري في الحركة، وُضعت وجهات نظر بعض مؤسسي الحركة – الذين اعتبرتهم الأنتليجينسيا الشابة برجوازيين صغار – موضع التساؤل. في عام 1968، وبعد أن قامت قيادة حركة القوميين العرب الفلسطينية بتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وبدأت بتدريب الفدائيين على التسلل إلى المناطق التي تحتلها إسرائيل، انشق الجناح الذي يقوده حواتمة وأبو ليلى من الجسم الرئيسي للجبهة ليشكلوا الجبهة الشعبية الديمقراطية لتحرير فلسطين، والتي عرفت فيما بعد باسم الجبهة الديمقراطية. وقد أيدت الجبهة الديمقراطية العمل المباشر مع العمال والفلاحين ورفضت دور الحزب الطليعي ال لينين ي. على أية حال أدت هزيمة عبد الناصر في حزيران 1967، وما كشفت عنه هذه الهزيمة من عدم الجاهزية العسكرية المصرية، إلى خيبة أمل كبيرة في العالم العربي، وفي الأوساط الفلسطينية خصوصاً. ومن الآن فصاعداً سينظر إلى الوحدة العربية وإلى تحرير فلسطين، التي أصبحت كلها تحت الاحتلال الإسرائيلي، على أنهما أمران مستحيلان بدون المشاركة الفعالة والتثقيف السياسي للجماهير العربية، ودون إسقاط النظم الملكية المحافظة مثل النظام الأردني ونظام العربية السعودية ودول الخليج.
على أية حال فشلت الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية التي انشقت عنها، رغم أيديولوجيتهما الماركسية – في جذب عدد كبير من العمال والفلاحين إلى صفوفهما، بينما نجحت فتح في ذلك. استوعبت الجبهة الشعبية أعداداً كبيرة من الأتباع في مخيمات اللاجئين في لبنان وسوريا والأردن، ويعود السبب في ذلك إلى الجهد الاجتماعي الواعي الذي بذله أعضاؤها. أما الجبهة الديمقراطية، ورغم اهتمامها الخاص بالعمال والفلاحين، فإن معظم كوادرها كانوا من صفوف المثقفين.
لم تقتصر معاناة الجبهتين على عداء الأنظمة العربية وإسرائيل وحكومات الولايات المتحدة وأوروبا فقط، بل واجهتا صعوبة في محاولة تنظيم الجماهير، فقد كان عدد العمال الصناعيين قليل، وكانت البروليتاريا مشتتة وخاضعة لقيود ضاغطة على حركتها. إضافة إلى ذلك لم يكن للفلاحين الفلسطينيين في الشتات قاعدة إنتاجية، أي على عكس الوضع في فيتنام وكوبا والجزائر.
أما الخلافات مع فتح حول دور الأنظمة العربية فقد تركتهم عرضة للانتقاد والهجوم من داخل حركة المقاومة وخارجها، خصوصاً من أولئك الذي اعتقدوا أن تبني الاشتراكية العلمية من شأنه إعاقة النضال في سبيل التحرر الوطني. واتضحت هذه الصورة بشكل جلي أثناء الحرب الأهلية في الأردن 70/1971 عندما تحملت كوادر الجبهة الشعبية عبء القتال والخسائر في الرجال والمعدات(*).
وفي عام 1974، كما سنرى لاحقاً، انقسمت الحركة الوطنية الفلسطينية بين الذين دعوا إلى استمرار النضال الثوري في سبيل التحرير الشامل وبين الذين فضلوا التسوية السلمية وتحقيق الاستقلال السياسي بالتحالف مع الأنظمة العربية.
الحزب الشيوعي:
رغم أن الحزب الشيوعي الفلسطيني كان من أكبر الأحزاب وأكثرها تأثيراً في الشرق الأوسط في فترة الانتداب إلا أنه عانى كثيراً خلال السنوات الأخيرة من الحكم البريطاني بسبب الخلافات التي نشبت بين أعضائه حول المسألة الوطنية. وبعد حل الكومنترن عام 1943 انشق الحزب إلى حركات عدة كان معظم أعضائها من اليهود، بينما انضم الأعضاء العرب إلى عصبة التحرر الوطني التي أسست في أيلول 1943.
بدلت العصبة مقرها ونقلته إلى الضفة الغربية عام 1949، أي في أعقاب نشوء دولة إسرائيل، وأصبح اسمها (الحزب الشيوعي الأردني). الذي التزم بالوحدة العضوية بين الشعبين الأردني والفلسطيني، واشترك الحزب بالانتخابات البرلمانية عام 1951 رافعاً شعار تحقيق الجمهورية، وإلغاء المعاهدة الأردنية – البريطانية وتوسيع الحريات الديمقراطية. ودعى الحكومة إلى إعادة توزيع الملكيات الكبيرة على الفلاحين، وإنشاء مصانع للدولة ومشاريع إنمائية توفر العمل للعاطلين.
أما في انتخابات 1956 فقد شكل الحزب جبهة وطنية ضمت حزب البعث والقوميين الاشتراكيين، وحصل على المرتبة الثانية بعد القوميين الاشتراكيين، وتم انتخاب عبد القادر الصالح وثلاثة مرشحين آخرين كانوا إما أعضاء في الحزب وإما مدعومين منه وهم: عبد الخالق يغمور عن نابلس وفايق وراد عن رام الله ويعقوب زيادين عن القدس، أعضاءاً في مجلس النواب. وعين الصالح وزيراً للزراعة في حكومة النابلسي، حيث كانت هذه هي المرة الأولى التي يشترك فيها حزب شيوعي في حكومة دولة في العالم العربي.
وكما حدث لليبراليين والبعثيين والقوميين العرب، أدت حملة القمع وإلغاء الدستور وحظر الأحزاب السياسية إلى إنهاء نشاط الحزب العلني في المملكة. وذهبت هباء كل الجهود لإعادة تجميع القوى التقدمية في مواجهة قمع النظام ومحاولة تشكيل جبهة تحرير وطني، وأُجبر الحزب عام 1959 على الانتقال إلى العمل السري.
في الستينات عانى الحزب من عدم قدرته على التوافق مع القومية العربية ومن التأييد الشعبي الهائل الذي تمتع به جمال عبد الناصر في أوسط جماهير اللاجئين الفقراء في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة.
ورغم ما بذله أعضاء الحزب في الضفة الغربية من جهد يحث الحزب على تبني الخطط المطروحة للوحدة العربية وتحرير فلسطين إلا أن أعضاء المكتب السياسي للحزب واصلوا الأخذ بعين الاعتبار أن التحالف مع البرجوازية الوطنية في العالم العربي يشكل انحرافاً، وأن المطالبة بتأسيس دولة فلسطينية مسألة انفصالية ومناقضة لفكرة الصراع الطبقي والتضامن الأممي للطبقة العاملة.
أدت هذه المواقف إلى تراجع الدعم الجماهيري للحزب خصوصاً بين صفوف الفلاحين المشردين والعمال المدنيين في مخيمات اللاجئين، وكان هذا التراجع لصالح عبد الناصر وحركة القوميين العرب وبنسبة أقل لصالح حزب البعث. فترك أعضاء كُثر من الشباب المثقف الحزب الشيوعي ليساهموا في تأسيس مجلة (فلسطيننا) الشهرية التي عكست آراء منظمة سرية أخرى هي فتح.
الإصلاح الإسلامي:
لم تكن الحركات الدينية المتشددة تلقى تأييداً كبيراً بين الفلسطينيين. ولكن في الفترات التي شُوّهت بها سمعة الحركات الوطنية والأحزاب العربية المختلفة، ازداد التأييد الفلسطيني لحركات الإصلاح الإسلامي بشكل ملحوظ. وظهر ذلك التأييد بشكل واضح في فترة ما بعد هزيمة 1948، ومؤخراً في بداية الثمانينات بعد الثورة الإسلامية في إيران ونمو النزعة الإسلامية في مصر، وفشل الحكومات العربية بوقف الغزو الإسرائيلي للبنان واستمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وغزة.
م.ت.ف. والوطنية الفلسطينية 1964-1983:
على عكس اللاجئين الفلسطينيين وضعت الدول العربية في الخمسينات والستينات مسألة تحرير فلسطين في أسفل قائمة أولوياتها. ولكن موت أحمد حلمي باشا، ممثل الفلسطينيين في جامعة الدول العربية عام 1963 وضع الدول العربية أمام مشكلة تسمية خليفته في هذا المنصب.
في اجتماع للجامعة العربية عقد لمناقشة هذه المسألة في أيلول 1963، أصرت العراق على إعادة فتح ملف مسألة الكيان الفلسطيني. واقترحت العراق وأيدتها سوريا – حيث يعمل حزب البعث الذي وصل حديثاً إلى السلطة على تعزيز قوته – إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة. مثل هذه الخطة، التي اعترفت أخيراً بحقوق الفلسطينيين، ستعطي ولاء اللاجئين الكامل للنظامين البعثيين في بغداد ودمشق، وتزيح السيطرة المصرية والأردنية عن تلك الأجزاء من فلسطين التي ما زالوا يحتلونها. ولكن نتيجة معارضة كل من القاهرة وعمان للخطة، قررت الجامعة العربية تعيين محام من عائلة معروفة في عكا هو أحمد الشقيري الذي كان في السابق الأمين العام المساعد للجامعة العربية خليفة لأحمد حلمي.
صاغ الشقيري وثيقة عرفت فيما بعد باسم الميثاق الوطني الفلسطيني، الذي أصبح لاحقاً القاعدة الأساسية لمنظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف)
تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية:
تمت المصادقة على الميثاق وعلى تشكيل م.ت.ف. في أيار 1964 في اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني المؤسس حديثاً. عقد هذا الاجتماع في القدس وحضره 242 ممثلاً فلسطينياً اختارتهم حكومات كل من الأردن، وسوريا، ولبنان، ومصر، والكويت، و قطر والعراق.
في أيلول 1965، وأثناء مؤتمر القمة العربي الذي عقد في الإسكندرية، وافقت الدول الأعضاء في الجامعة العربية على تأسيس جيش التحرير الفلسطيني.
أُهملت مطالب الفلسطينيين النشيطين في الحركات القومية العربية والحركات اليسارية المختلفة بالمشاركة في تشكيل هيئات م.ت.ف. الدستورية، وأصبحت م.ت.ف. عبارة عن ملتقى للرموز الفلسطينية المتحالفة مع الحكومات العربية المختلفة.
فتح تستولي على م.ت.ف:
وضعت الهزيمة المفاجئة للجيوش العربية في حرب حزيران 1967 العاصفة وفتح في مركز الاهتمام الدولي. وأظهر الانتصار المؤثر في معركة الكرامة في أيار 1968، عندما صد الفدائيون هجوماً كبيراً شنته الهاغانا ضد الضفة الشرقية، قدرة فتح على التفوق على الجيش الإسرائيلي النظامي.
في شباط 1969 أي في الدورة الخامسة للمجلس الوطني الفلسطيني المنعقدة في القاهرة، حصلت حركات المقاومة التي تنادي بالكفاح المسلح، ومن بينها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والصاعقة إضافة إلى فتح على 57 مقعداً من مجموع المقاعد التي بلغت 105 مقاعد، مما أعطاهم الأغلبية المطلقة. على أية حال أدت مقاطعة الجبهة الشعبية لمؤتمر القاهرة، وإصرارها على حل م.ت.ف. حلاً تاماً، وإعطاء كافة المنظمات المسلحة أصوات متساوية في قيادة الكفاح المسلح إلى إعطاء فتح الموقف الحاسم. هذا إضافة إلى استفادة فتح من تعاطف عدد من المستقلين المنتخبين إلى المجلس الوطني الفلسطيني، وكذلك تعاطف ممثلي اتحاد العمال الفلسطيني بالإضافة إلى 23 مقعداً حصلت عليهم الحركة.
في انتخابات اللجنة التنفيذية، تم انتخاب ياسر عرفات (الذي ظهر لأول مرة في العلن كناطق رسمي لحركة فتح في دمشق في نيسان 1968) رئيساً لـ م.ت.ف.
ورغم الجدل الداخلي الذي نخر م.ت.ف. منذ تأسيسها، فقد تم تقديس مبدأ فتح بالأولوية الفلسطينية وبإقامة دولة ديمقراطية علمانية، وكذلك قُدّس الكفاح المسلح كأيديولوجية أساسية لحركة المقاومة الفلسطينية.
الوطنية والصراع الطبقي داخل م.ت.ف:
كان توجه فتح الأساسي، وخلافاً لتوجهات سابقيها أو منافسيها، نحو الفلسطينيين وحدهم، وأثر تركيزها على الوحدة الوطنية في صفوف الفلسطينيين على الفلاحين والمدنيين على السواء. الحركة شرعية في أعين اللاجئين، الفقراء منهم والأغنياء .
أما بالنسبة للطبقة الوسطى المدينية، فقد استجاب إصرار فتح على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني مع الشعور بالقمع والاستغلال الذي أحسه أبناء هذه الطبقة أثناء إقامتهم تحت سيطرة البرجوازيات العربية، واستجاب أيضاً مع آمالهم بتحقيق الاعتراف بدولة تخصهم. أما إنكار فتح الضمني لأهمية أي عامل آخر، إن كان طبقياً أو دينياً، فقد كان مناسباً للبرجوازية الفلسطينية في الخليج والعناصر الشابة من أبناء العائلات المالكة للأراضي، الذين أملوا بأن يأخذوا ما اعتقدوا بأنه موقعهم الطبيعي في حكومة أو إدارة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وفيما يتعلق بالفلاحين، أدى إدخال فتح للرموز الكبيرة في التاريخ العربي والإسلامي، وإبطاله وأساطيره، وفكرة الجهاد والتضحية والاستشهاد، وكذلك اختيار اللباس (مثلاً الكوفية)، أدى كل هذا إلى إعطاء الحركة سلطة وقوة فاقت سلطة النظرية والتحليل المنطقي. والأهم من ذلك، فإن تركيز فتح على فكرة "العودة" استجاب بشكل فريد مع توق أولئك الذين يعيشون في المخيمات، ولم يستطيعوا تحصيل الثروة ولا التعليم، والذين كانوا يريدون نتائج مباشرة. لم تعن فكرة العودة إلى الأرض بالنسبة لكثير من الفلاحين المهجرين الحرية والعيش في ظل دولة مستقلة بقدر ما عنت الاستعانة المادية والبسيطة للبيت ووسيلة الحياة والإنتاج.
إضافة إلى إمكانية الحياة مع الأقارب واستعادة المجتمع التقليدي وشبكات العلاقات القديمة التي دمرت في الفترة بين 1948-1967 إضافة إلى ذلك فإن الوعد الذي بشرت به فتح كان جذاباً للعديد من اللاجئين أكثر بكثير من الدعوة التي طرحتها الحركات الماركسية إلى التحرير من خلال الصراع الطبقي في المحيط العربي الأوسع. هذا إضافة إلى حقيقة أن فتح تدفع لمقاتليها مخصصاً شهرياً، فإن وعودها لهم برعايتها لزوجات وأطفال من يقتل أو يجرح منهم، جذبت إليها العديد من الشباب الذين لولا هذا الضمان لفضلوا العمل لتأمين معاش عائلاتهم على الانخراط في العمل السياسي وفي الكفاح المسلح.
تشكلت المعارضة الأساسية داخل حركة المقاومة الفلسطينية من الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، اللتان – مثل فتح – نظرت إليهما الجماهير الفلسطينية على أنهما مستقلتان عن الأنظمة العربية المختلفة.
اتضحت إحدى الخلافات الرئيسية التي أبعدتهما عن فتح أثناء الحرب الأهلية في الأردن. ففي حين التزمت كوادر فتح بسياسة "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للأنظمة العربية"، دعت الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية بعد حرب أكتوبر 1973 حول مسألة العلاقة مع الملك حسين.
وفي نهاية 1982، عندما انشق المجلس الوطني الفلسطيني حول الموقف من مشروع ريغان، سعى عرفات ثانية إلى التقارب مع الملك، الذي كان يسعى وبالتناغم مع الخطة الأمريكية، إلى تأسيس حكم ذاتي في الضفة الغربية يكون متحالفاً مع وتحت سيطرة الأردن الكاملة.
أما الخلافات حول الموقف من الأنظمة العربية فقد أدى إلى انشقاق صريح في حركة المقاومة بعد الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982. ففي الوقت الذي استمر به العديد من قادة فتح بدعم وتأييد حملة عرفات الديبلوماسية لكسب دعم الأنظمة العربية من أجل تعديل خطة ريغان، هذا التعديل الذي يؤدي إلى إقامة "كيان" ذو حكم ذاتي في الضفة الغربية، أصرت الجبهة الشعبية، وعدد كبير من مقاتلي المنظمات الأخرى على أولوية الكفاح المسلح وعلى أهمية محاربة الإمبريالية الأمريكية والصهيونية والرجعية العربية. ورغم أن الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية قد امتنعتا عن دعم المنشقين على حركة فتح عندما فتحوا النار على "الموالين" في شمال وشرق لبنان في صيف وخريف 1983، إلا أن مدى الانقسامات داخل فتح نفسها أثر على درجة الانقسام التي وصلت إليها حركة المقاومة ككل حول مسألة الموقف من الأنظمة العربية، وحول مسألة الكفاح المسلح(*).
هاتان المسألتان المترابطتان، والخلافات حولهما داخل حركة المقاومة، عكستا الانقسام بين الفلسطينيين في الشتات حول الدور الذي يجب أن تلعبه الثورة الاجتماعية داخل حركة التحرر الفلسطينية بشكل خاص، وداخل العالم العربي بشكل عام. فالبرجوازية الفلسطينية في العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، وإلى درجة أقل في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية فضلت سياسة فتح بالجمع بين المفاوضات الديبلوماسية والكفاح المسلح وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية للأنظمة العربية وتجنب تأييد حركات المعارضة في العالم العربي. أما المطالب الراديكالية للجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية بضرورة الثورة العربية، ورفض المساعدة الديبلوماسية والمالية من الملكيات المحافظة في الخليج، وبتصعيد الحملة ضد المصالح الغربية في العالم العربي، فقد هددت مواقعهم الخاصة إضافة إلى أنها تجعل الهدف النهائي، وهو تحرير فلسطين، بعيداً جداً (حسب وجهة نظرهم).
على أية حال هذا لا يعني أن الصراعات الطبقية الخفية في الأيديولوجيات والممارسات المختلفة في حركات المقاومة هي العامل المقرر أو الأساسي في سلوك المقاومة، فإن القمع المستمر الذي شعر به كل الفلسطينيين – خلال سنوات التشرد والاحتلال الطويلة، بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها الفلسطينيون في لبنان والأردن والمناطق المحتلة في الضفة الغربية و غزة – قد غطّى على الانقسامات الاجتماعية في المجتمع الفلسطيني. فرغم تنامي الوعي الطبقي وتجلي هذا الوعي في التغيرات داخل قيادة م.ت.ف. وفي طريقة تنظيم المقاومة، فإن الشعور الوطني يبقى هو الأيديولوجية المهيمنة، في الوعي أو في اللاوعي، وهي التي ينتمي إليها كل الفلسطينيون. قد تنمو المطالب بالإصلاح الاجتماعي أو بالتحويل الاجتماعي الثوري داخل المجتمع الفلسطيني والعالم العربي ككل، ولكنها تنمو إلى جانب، وليس في صراع مع، الرغبة في التحرر الوطني.
بعد خمسة وثلاثين عاماً من إقامة دولة إسرائيل، فإن الفلسطينيين ينزفون الدماء ولكن ليسوا براكعين. فبالمهارات والتصميم الذي اكتسبوه خلال أعوام النفي الطويلة سيستمر نضالهم من أجل تحقيق دولة لهم، وسيستمر هذا النضال كما كان منذ عام 1920.
* – للحصول على تفاصيل تاريخ الحركة انظر أطروحة الدكتوراة "حركة القوميين العرب 1951-1971: من مجموعات ضغط إلى حزب اشتراكي"، كتبها الدكتور باسل قبيسي للجامعة الأمريكية، واشنطن، 1971. الدكتور القبيسي أسهم في تأسيس الفرع العراقي للحركة وكان رفيقاً قريباً من الدكتور جورج حبش خلال سنوات دراسته للطب في الجامعة الأمريكية في بيروت. اغتيل القبيسي في باريس في نيسان 1973. .
* - في وقت تدهورت العلاقات بين فتح والجبهة الشعبية بشكل سيء جداً حيث اتهمها كمال عدوان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عام 1971 بأنها تعمل وكأنها عميلة للنظام الأردني واتهم عدوان الجبهة أيضاً بأنها أعطت للنظام مبرراً لتصفية المقاومة في البلاد، وكان يُشير افتراضاً إلى حادث اختطاف الطائرات الأربعة في أيلول 1970. وأشار إلى أن فتح فكرت بتصفية الحسابات مع الجبهة الشعبية عندما اندلعت الحرب الأهلية. الريس ونحاس، ص40. وانظر أيضاً جون كولي، "آذار الأخضر وأيلول الأسود: قصة العرب الفلسطينيين"، (لندن1973).
* – إلى جانب المنشقين عن فتح، حصلت مراجعة مطولة داخل اللجنة المركزية لحركة فتح حول موقف الحركة من الأنظمة العربية بعد الغزو الصهيوني عام 1982. قال صلاح خلف علنياً في الوطن الكويتية في تموز 1983 أنه يشعر أن مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول العربية الداخلية كان سياسة خاطئة اتبعتها الحركة. الوطن العربي 15 تموز 1983.