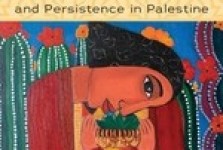إن التصوف على مر الأعوام ارتبط ارتباطًا وثيقًا بأصل الجمال كله، ألا وهو الحق سبحانه وتعالى، مبدع الوجود والموجودات، فمن هنا كانت العلاقة الوثيقة بين التصوف والجمال والفنون والإبداع عمومًا، علاقة أصيلة تتصل بمنابع الجمال والجلال، والترقي في معارج الروح والخيال، حيث التجاذب الفني، والتداخل الصوفي بين كل من الإبداع ومنبع الجمال وأصل الجلال ومصدر الكمال، ومن ثم جاءت التجربة الصوفية في الأدب والفن رحلة روحية ومعراجًا للروح إلى عالم الملكوت، تغوص من خلاله في عالم الأحوال، عابرة لعالم الأقوال من أجل البحث عن الحقيقة، عن الحق والروح والجمال، لهذا نرى أن الموروث الصوفي العربي قد قدم لنا نصوصًا أدبية ومواقفًا ورؤىً وتصورات تصل بالمتلقي إلى أقصى حالات الجمال والجلال والإبداع، حيث يظهر واضحًا في الأدب الصوفي، شعرًا ونثرًا، كما في مخاطبات النفري، وفتوحات ابن عربي، وحكم ابن عطاء الله، وفي المنقذ من الضلال للإمام الغزالي، وكتابات المحاسبي، والبسطامي، والجنيد، وشعر ابن الفارض والحلاج، وغيرهم، حيث تحمل كتاباتهم الروح الصوفية والذوق الأصيل إلى جانب كدح ومجهود شاق للمبدع على مستوى اللغة للترقي في معارج الخيال والصورة والتشكيل وبالتالي حمل القارئ بسهولة ويسر إلى ما وراء الحروف والكلمات والدلالات، ومن هنا يمكننا القول إن النص الصوفي نصًا إبداعيًا جسورًا خلاقًا عماده التأويل والرؤى لا التفسير والتعليل، ظاهره الجمال وباطنه، نص يتسم بالجسارة التي تفتح له بابًا للخوض في تأمل المقدسات، من خلال النظر في مسائل الألوهية والكون والوجود، والاتحاد والحلول والفيض والعشق والمرأة، حيث ينتقل النص الصوفي بالقارئ من الحس الدنيوي إلى الروحي والوجودي والرباني، إلى جانب ما يستتبع ذلك من إبداع النص ورموزه الخاصة ومصطلحاته السرية التي تهيم بالمتلقي في عوالم الظاهر والباطن، والأحوال والمقامات والمكاشفات، والشريعة والطريقة والحقيقة، والذوق والوجد إلى آخره. مع ملاحظة أن أدباء التصوف قديمًا كانوا أبناء طريق لم يتح للكثيرين من أدباء اليوم، لذلك نجد أن الأدب الصوفي بعامة، وفي الواقع العربي بخاصة قد فتح التجربة الإبداعية على أفق السؤال والقلق والاغتراب والمواجهة والثورة والتمرد، كل هذه الدلالات التي ابتكرتها الروح الصوفية قد أثرت الفنون المعاصرة من شعر ومسرح وفنون درامية وتشكيلية على اختلاف مدارسها ومقاصدها من خلال الرمز والتناص والمنولوج الداخلي وخلافه من تقنيات الكتابة الإبداعية في العصر الحديث، وإن كان المبدع ليس ابن الطريق الصوفي.
وقد كان لزامًا أن أكتب هذه المقدمة وأنا أطالع كتاب "تأملات في الصوفية الجمالية" للكاتب الفلسطيني جواد العقاد، وهو أحد شعراء فلسطين المحتلة، وعضو الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين، حصل على بكالوريوس الأدب العربي من جامعة الأزهر بغزة، وباحث ماجستير في جامعة القدس المفتوحة، يعمل محررًا أدبيًا، صدر له ديوان شعر بعنوان "على ذمةِ عشتار" وكتاب بعنوان "تأملات في الصوفية الجمالية" وهو الذي نطالعه الآن.
للوهلة الأولى يتبادر إلى ذهن القارئ تساؤل عن عتبة النص، ألا وهو لماذا خص شاعرنا التصوف دون غيره بتأملاته الجمالية تلك؟ رغم أن أوجه الجمال عديدة، ومتسعة البراح، في الفن بعامة والأدب بخاصة، فنجد شاعرنا يجيب، في مقدمة الكتاب، على ذلك بقوله: "إن الكتابة نقاش مع الذات، وتعبير دقيق عن الفكر، ولأني أريدها كتابة تبحث عن الجمال أكثر من الفكر، رصدت العلاقة الوطيدة بين التصوف والفن، وكيفية تأثير كلاهما في الآخر، فقمت بالكتابة في الموضوع باحثًا عن بقعة الضوء الصغيرة الممثلة بالفكر الصوفي الحق، وسط ظلام الادعاء والخرافة" فجاءت محصلة ذلك الجهد كتاب "تأملات في الصوفية الجمالية". فمنذ البداية نجد أن شاعرنا في دراسته يُعنى بالتصوف، لبيان أهمية النزعة الصوفية في الفنون المعاصرة بشكل عام، والشعر العربي بشكل خاص، وبيان أهمية الروحانية في صقل الإبداع، وبيان أهمية النزعة الصوفية في إثراء العملية الإبداعية، ونجده قد اعتمد المنهج الوصفي في رصد تأملاته الصوفية الجمالية؛ ولهذا كان من الضروري أن يفتح الكاتب كوة للقارئ في البداية ليتعرف من خلالها على التصوف، فجاء المبحث الأول ليحدثنا من خلاله عن مفهومه ونشأته، ولأن الدراسة في الأصل ليست دراسة صوفية فكرية، جاء التعريف به وبنشأته على مستوى القارئ العادي ليمسك بعلائق الجمال الصوفي لكي يطمئن إلى ذائقة الكاتب من ناحية، ويشاركه في عملية التذوق من ناحية أخرى، فقام بتعريفه لغة، واصطلاحًا ليصل بنا إلى حقيقة مؤداها "أن التصوف تزكية للنفوس، وتطهير للقلوب، وعبادة الله محبة خالصة لذاته، لا رغبة ولا رهبة"، ثم يشير الكاتب إلى نشأة التصوف، فيتعرض لنشأته عند اليونان، وفترة ما قبل الإسلام، ثم يتحدث عن التصوف الإسلامي وكيف كان معاصرًا للرسالة المحمدية دون أي تسمية حيث عرفه العباد الأوائل، الذين أخلصوا لله تعالى، خلال القرون الثلاثة الأولى من الهجرة تحت ما يُسمى بعلم الكلام إلى أن ظهرت الطرق الصوفية، التي كانت تُعنى بالتربية الروحية والسلوكيات وترقي المريد في طريق الوصول إلى الله. ثم يتعرض الكاتب للحديث عن الزهد موضحا لنا، كيف خلط الناس بينه وبين التصوف، فعرَّفَ الزهد على أساس أنه التقشف وذم الدنيا والعمل للأخرة والتفرغ لعبادة الله، وأوضح أن عبادة الزهاد تلك كما أوضحها ابن تيمية تكون خشية من الله، أو رغبة في نعيمه، ويرى أن التصوف فقد شكل تيارًا فكريًا له نظرة خاصة تُجاه الخالق والوجود والإنسان وعلاقته بربه، فهو اتجاه ديني فلسفي، ثم يتعرض للحديث عن مقامات الصوفية وأحوالها، فيعرض لنا معنى كل من المقام والحال في اللغة، ومعناهما عند المتصوفة، وكذلك تعرَّضَ إلى الشطحات الصوفية حيث أوضح أنها لا علاقة بينها وبين الكفر، وأنها منحة من الله تعالى للسائر تعينه على الترقي في الطريق، وبما أن التصوف تيارًا فكريًا تعرض الكاتب إلى مضامين هذا الفكر في ختام المبحث، واقتصر في الحديث على ثلاث مضامين نظرًا لطبيعة الدراسة وهي: وحدة الوجود، الحلول والاتحاد، والحب الإلهي.
أما في المبحث الثاني فيتحدث عن الفن والتصوف، وعلاقة التصوف بالفنون، يقول:" يُعتبر التصوف في الأساس، تجربة روحية وجدانية، يقيمها العبد مع خالقه، وبما أنها متعلقة بالروح والوجدان كان بديهيًا التعبير عنها بالفن، والغناء الصوفي، والرقص الصوفي، وألوان من شتى الفنون. وكأي قوم تجمعهم ثقافة واحدة، أصبح للصوفية آدابهم وفنونهم المتفردة، نظرا لأن لغتهم لغة شعرية عالية، ونظرتهم للحياة نظرة صفاء، ولكون فنونهم من طراز خاص". فقد أثرت في غير المتصوفة الذين اقتبسوا منها، فأثرى الفكر الصوفي أعمالهم، وأضاف إليها أبعادا جمالية.
حيث نجد الكاتب يتعرض بالحديث عن نماذج لتلك الفنون كالرقص الصوفي كما في حلقات الذكر، ويسمى برقص السماع، حيث الدوران حول النفس والتأمل كما يفعل الدراويش، والذي يظهر واضحًا عند أتباع الطريقة المولوية، وكذلك الغناء كما في مواجيدهم وقصائدهم، وأخيرًا تعرض للحديث عن الفن التشكيلي، حيث يوضح لنا كيف تتوغل التجربة الصوفية في الذات البشرية للتعبير عن جوهر حالات الإنسان بغية التطهر، حيث أشار إلى الفنان العراقي "شاكر حسين آل سعيد" نموذجا، والذي تحولت أعماله التشكيلية إلى بحث في المجال الروحي، من خلال التجريد في الفن التشكيلي.
وتناول في المبحث الثالث النزعة الصوفية في الأدب، تحدث عن علاقة التصوف والأدب، وتعرض لبعض هذه النماذج كالحلاج، حيث ذكر الكاتب أنه لم يمر بشاعر متصوف خاض تجربة التصوف وعبر عنها في شعره، وإن كنت أخالفه في ذلك ففي مصر كان هناك الشاعر "علي عقل" صاحب ديوان الإلهام، والشاعر "محمد أبو دومة" وكلاهما أبناء طريق وعبروا عنه في شعرهم، ولكنه اكتفى بعرض نماذج شعرية لشعراء معاصرين اتخذوا من الفكر الصوفي وسيلة للتعبير عن عواطفهم ونظرتهم إلى الحياة، حيث قاموا بتوظيف معتقدات الصوفية دون اعتقاد بها في الغالب مثال: الشاعر المصري صلاح عبد الصبور، والشاعر السوري أدونيس، والشاعر السوداني التيجاني يوسف بشير، ثم يقدم للقارئ عدة قراءات نقدية تطبيقية للمنحى الصوفي، وهي: قراءة في مسرحية: "مأساة الحلاج" لصلاح عبد الصبور، والنزعة الصوفية في ديوان "مُرِي كالغريبة بي "للشاعر أنور الخطيب، ثم الأنثى والتصوف في ديوان: "في المرآة أشبهنِي" للشاعر سليمان دغش، وبعد ذلك تحدث في نصوص شعرية أخرى مثل: "المناجاة في نص عزم" للشاعرة باسمة غنيم، وصراع المثقف والشاعر في نص "وإن اختلفت الأسماء" للشاعر أحمد زكارنة، فكانت تلك النماذج الشعرية محطات رصد المؤلف من تناولها استخدام الشاعر لتقنيات فنية كالتناص والمنولوج الداخلي وغيرها، والتي وظف من خلالها الفكر الصوفي بشكل يلائم العصر الذي نحياه، بحيث أصبح الموروث الصوفي إضافة تغني النص بمدلولاتها وآفاقها الرحبة، حقيقة لا أستطيع إلا أن أقول إنني بالفعل قد استمتعت كثيرا بهذا الكتاب الذي يعد إضافة حقيقية للمكتبة العربية، وإن كنت أرى أن المؤلف كان عليه أن يبحث في هذه المنطقة الثرية عن نماذج لشعراء معاصرين تحققت تجربتهم الشعرية في بوتقة النص الصوفي المعاصر كما سبق أن أشرت، أرجو من الباحث أن يبحث عنهم ويكتب بحيث يمكن إضافة ذلك للكتاب في طبعته الثانية لتعم الفائدة.