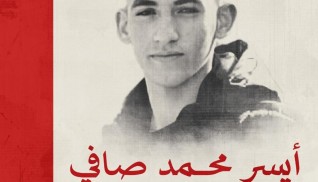مع نهاية عام 2020 ومطلع السنة الجديدة تكون قد مرت أكثر من عشر سنواتٍ على انطلاق الحراكات الشعبية في العديد من الأقطار العربية، والتي شكلت أهم ما ميز بداية القرن الواحد والعشرين، وهي مدة زمنية لم تكن كافية ولا يمكن أن تكون كذلك للحكم النهائي على هذه المسارات "الثورية" المعقدة وتقييم نتائجها بطريقةٍ قريبةٍ من الحسم والجزم، لكن هذا لا يمنع من الإقرار أن السياق الراهن الذي أعقب تلك الحراكات أصبح يعج بجملةٍ من مظاهر الارتداد السياسي والحقوقي،والانقسامات الحادة التي تتداخل فيها الأبعاد السياسية والطائفية والدينية والعرقية، فأصبحنا أمام مشهدٍ غير مكتمل الولادة، أو بعبارةٍأصح أمام مشهدٍ مشوه تكالبت في تشويهه وتحريف "الحالة الثورية" عن مراميها وأهدافها التحررية، القوى الامبريالية لاغتيال التطلعات الديمقراطية للشعوب العربية ومصادرة حقها في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، في مقابل الاستمرار في تركيع الأنظمة العربية الرجعية والدعم الاستراتيجي للكيان الصهيوني العنصري.
ومن منطلق الإيمان بأن القضيةَ الأساسية لا تكمن في تشخيص المنبت التاريخي للحراك الشعبي في العالم العربي، بل فهم دينامياته انطلاقاً من مساءلة نتائجه ومآلاته وآفاقه، نعتقد أن الإشكالات التي ينبغي مواجهتها هي من قبيل: ماهي مآلات الربيع "الديمقراطي" العربي؟ ولماذا وصل الى ما وصل إليه؟ وكيف يمكن تفسير انتصار قوى الثورة المضاد، وانتكاسة القوى التقدمية، التي طالما حملت شعار التغيير الجذري والثورة؟
المخاض المفتوح
منذ جلاء الاستعمار عن أقطار العالم العربي الإسلامي، وترسيخ هياكل الاستقلال غير المكتمل على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ظلت معركة التحرر الوطني وبناء الديمقراطية مستمرة،وتراوح مكانها بين المد والجزر في ظل متغيراتٍ دوليةٍ وإقليميةٍمن أهم ما ميزها انهيار المعسكر الاشتراكي، وانتقال العالم من الثنائية القطبية نحو الأحادية القطبية، في ظل صراعٍ محمومٍ بين القوى الرأسمالية التقليدية وقوى صاعدة، ليتحولَ الصراعُإلى سباقٍ محموم لاستثمارٍ أقصىلتداعيات جائحة كورونا على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية والطبية، ولا شك أن التنافس الجاري حول إنتاج اللقاح وتسويقه من الواجهات الأساسية للتموقع بشكلٍ أقوى في الخريطة العالمية، وخلق أحلافٍ تتحكم فيها بالدرجة الأولى المصالح الاستراتيجية بأبعادها الاقتصادية والتكنولوجية والعسكري، وقد تؤدي هذه التراكماتإلى عالمٍ متعددٍ القطبية تعاد فيه صياغةُ العلاقات والتحالفات الجيوسياسية!
لكن الثابتَ لحدود الآن على المستوى الدولي، هو التعميم المتواصل لبرامج العولمة الليبرالية المتوحشة، من خلال استمرار تحكم الشركات العابرة للقارات في الاقتصاد العالمي، وضمنها الاقتصادات الوطنية لبلدان الجنوب واستنزاف ثرواتها المادية والبشرية، مما أدى إلى تعميق التطور غير المتكافئ،وتوسيع دوائر الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعي ومصادرة الحريات وحقوق الإنسان، وفي أحسن الحالات التسويق لديمقراطية على المقاس تشجيعاً من القوى الإمبريالية الكبرى، من خلال انتقال استراتيجية هاته الأخيرة من شعار "المهمة التحضيرية" خلال مرحلة الاستعمار المباشر لتبرير الاستعمار، بدعوى مساعدة البلدان المستعمرة للخروج من براثين التأخر الاقتصادي والتخلف الاجتماعي والثقافي، إلى شعار "المهمة الحقوقية والإنسانية" للتغطية على الاستعمار الجديد من خلال التدخل العسكري والسياسي بدعوى حماية المدنيين، ومن الواضح أن كلتا الخطتين تصبان في سياسة تنمية التخلف باسم التحديث المفترى عليه، أو كما يقول عالم الاجتماع البريطاني"أنتوني جيدنز" "إن نظرية التحديث تنهض على مقدمات خاطئة، كما أنها قد لعبت دورا أيديولوجيا مبرراً لهيمنة الرأسمالية الغربية على بقية العالم" (كتاب: مقدمة نقدية في علم الاجتماع. الصفحة 172)، وقد أطلق "سمير أمين" على هذا النمط من التنمية توصيف التنمية المعاقة أو التنمية الرثة التي من نتائجها تفاوتات طبقية صارخة، واحتداد جيوب الفقر واللامساواة والاقتصاد غير المهيكل والبطالة، في مقابل مراكمة الطبقات الحاكمة وزبنائها للثروات، سيما أن الأنظمة السائدة في العالم العربي هي من طبيعةٍ ريعيةٍميراثية تحتكر ما تحت الأرض وما فوقها كما يؤكد "جلبير الأشقر"،وذلك في ظل رأسماليةٍ محددةٍ سياسياً بالمحسوبية والمضاربة.
كل هذا يجري في إطار مشروع الشرق الأوسط الجديد، الذي من أهم حلقاته إجهاض المد التحرري والثوري في بلدان الجنوب على قاعدة دعم الثورات المضادة وإعادة هيكلة أنظمة الفساد والاستبداد وتطويعها أكثر في اتجاه التطبيع الصريح مع الكيان الصهيوني، والانخراط غير المشروط في صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية حفاظاً على الكيان الصهيوني، من حيث الأمن الاستراتيجي والوجود كقوةٍ إقليميةٍ وازنةٍ وراعية لمصالح الرأسمالية العالمية في الشرق الأوسط، وفي هذا السياق يتأطر المخطط التدميري للتحالف الامبريالي الصهيوني الرجعي في ليبيا وسوريا واليمن، في تغذية الانقسامات والدفع نحو عسكرة الانتفاضات وتعميق طابعها الطائفي والمذهبي، للبحث عن التغطية السياسية والأيديولوجية للتدخل العسكري وتقويض الأنظمة غير الموالية للحلف الإمبريالي الصهيوني الرجعي.
لا شك أن هذا الجرد التاريخي المركز يفسر إلى حدودٍ معينة بعض شروط الانتفاضات العربية التي شهدها العالم العربي،والتي اندلعت منذ أكثر من عقد من الزمن، والتي اصطلح عليها بالربيع العربي، في تونس، مصر، البحرين، اليمن وسوريا،وحراكاتٍسياسيةٍ واجتماعيةٍ في المغرب، الجزائر، لبنان...وهي شروط جدلية جمعت بين سياقٍ دولي يؤطره النموذج الليبرالي المتوحش، الذي عاشأزمةًخانقةً عام 2008،وانعكاساتها الوخيمة على المراكز والأطراف، حيث شهد المركز الرأسمالي انتعاش التيارات اليمينة المتطرفة والشعبوية والنزعات الهوياتيةوالديني،ة ومعاداة المهاجرين والأقلياتوالتي عرفت صعوداً انتخابياً ملحوظاً في العديد من الدول الغربية من جهة، ومن جهة ثانية بقاء الأطراف رهينة الواقع التاريخي للتبعية، وفقدان السيادة الوطنية والشعبية وتراجع قوى التحرر والتقدم والحداثة، في ظل صحوة "قوى الإسلام السياسي"،واتساع أفق انتظاراتها وتطلعاتها نحو السلطة والحكم.
المآل بين الثورة المضادة واليسار الموجود بالقوة
إن الذي ينبغي التأكيد عليه هو أن الربيع "الديمقراطي" العربي لم يكن وليد الصدفة، ولم يتحكم فيه منطق المؤامرة، أو نظرية "الفوضى الخلاقة"، كما يحاول أن يروج لهذه الأطروحة غير العلمية وغير التاريخية المحافظون الجدد،و"مثقفو" مراكز التمويل الرأسمالي، بل إنه تتويجٌموضوعيٌ ونوعيٌ لمسلسلٍ تراكمي من المقاومات الاجتماعية والسياسية ضد القمع السياسي والقهر الاجتماعي، حيث اتساع خريطة الاحتجاجات في العديد من البلدان العربية سواء على المستوى الفئوي (عمال، طلبة، مهمشين، نساء، ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، الصحفيين..) أو مجالياًفي المدن والبوادي والمراكز الحضرية، وهي احتجاجات كلها تعكس حجم المآسي الاجتماعية للنموذج الليبرالي المتوحش، وتطبيق توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على الأوضاع المعيشية للطبقات الاجتماعية المقهورة من حيث هدر كرامتها في العيش اللائق وحرمانها من الحقوق السياسية كالحق في حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية.
إذا كان الربيع الديمقراطي العربي لحظةً فارقةً في تاريخ العالم العربي، فإنه عكس في نفس الوقتالعديد من المفارقات التي ينبغي تأملهاوقراءتها بشكلٍ جيد لاستشراف آفاق التغيير السياسي والتنمية الاقتصاديةوالاجتماعية، بشكل يتيح شروط التحقق الممكن لمشروع الدولة الوطنية الديمقراطية القائمة على السيادة الوطنية والشعبية وحقوق المواطنة، ومن أهم هذه المفارقات:
- إن الشعارات التي حملتها أكتاف المتظاهرين والمتظاهرات في ميادين الاحتجاج الواقعي والرقمي، عبرت عن تجدد الحاجة التاريخية للديمقراطية، والقطع مع عقود من الاستبداد والفساد، لكنها بقيت شعارات، ولم تتحول إلى برنامجٍ سياسيٍ قابلٍ للتحقق، تحمله قوى سياسية تمتلك مقومات التأثير والتأطير والتوجيه.
- لقد تحققت نتائجُ سياسيةٌ هامة على طريق إسقاط رؤوس الأنظمة الاستبدادية وخلق حالة ثورية كامنة، لكن ظلت هذه الأخيرة عاجزةً عن استكمال حلقاتها، وبالتالي القطع مع بنيات الفساد والاستبداد كبنياتسوسيوتاريخية.
- ضعف وارتباك قوى اليسار والديمقراطية أمام قوة وتمدد الانتفاضات، حيث كانت هذه القوى منشغلة بلملمة جراحاتها، ومحاولة استعادة الوجود والتأثير، بعد التداعيات السلبية الملحوظة لسقوط جدار برلين،حيث دخلت في مراجعاتٍ تنظيميةٍوأيديولوجيةٍ وسياسيةٍ لم تساعدها للأسف على التقدم والزحف الفكري والسياسي باستثناء حالاتٍ قليلة، وهكذا ظلت هذه القوى حاضرةً بشعاراتها ومطالبها التاريخية وسط ميادين الحراك، يرددها شبابٌ متعطشٌإلى الديمقراطية كشعارت الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، في غياب السند الاجتماعي والسياسي، بمعنى أن المطالب والشعارات يسارية وتقدمية بالفعل، لكن في غياب المشروع السياسي التقدمي الوازن، الذي ظل موجوداً بالقوة وشبه غائب بالفعل.
- دخول قوى الإسلام السياسي بمختلف مشتقاتها المعتدلة والسلفية والجهادية على خط الحراك "الديمقراطي" في معظم الأقطار العربية (تونس، مصر، اليمن، سوريا، اليمن، ليبيا..)، حيث بعد أن ترعرعت هذه القوى في شروطٍ تاريخيةٍ تميزت من جهةٍ أولى بنكسة المشروع القومي العربي بعد هزيمة ،1967 وأزمة المشروع الديمقراطي الثوري بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، ومن جهةٍ ثانية بدعم الإمبريالية الأمريكية في سياق محاربة المد الشيوعي والاشتراكي، وكذلك بعد أحداث 11 سبتمبر2001لتتحول هذه القوى مع مرور الوقت إلى رهينة حساباتٍ ومعادلاتٍ إقليمية تقودها الإمبريالية العالمية وأنظمةٌ إقليميةٌ تابعةٌ في كل من قطر والسعودية، مما جعل منها جزءًا لا يتجزأ من معسكر الثورة المضادة،حيث تغيرت نظرة الإدارة الأمريكية إزاء موقع "الإسلام السياسي" في معادلة التحول السياسي بالمنطقة، وهكذا اصطفت إلى جانب بقايا الأنظمة المهددة بالزوال،ودخلت في صفقاتٍ سياسيةٍ مكشوفةٍ لإضعاف الحراكات السياسية ( مصر، تونس، سوريا، المغرب...)، وقد ساهمت هاته القوى "الدينية" في إضفاء الطابع المذهبي والطائفي على الانتفاضات، وبالتالي الالتقاء الموضوعي مع استراتيجية القوى الامبريالية في عسكرة الحراكات الشعبية وتحريفها عن مسارها الأصلي الذي انطلقت منه، والمتمثل في إسقاط أنظمة الفساد والاستبداد، والتطلع إلى ديمقراطيةٍ حقيقيةٍ تضمن المشاركة السياسية والحقوق المدنيةوالاقتصادية والاجتماعية.
- لكن الأخطر في هذه الصيرورة،وعلى الرغم من اندلاع بعض الحراكات الشعبية المطالبة بالديمقراطية والكرامة كما حصل في لبنان، وحاصل قبل فترةٍ قصيرةٍ بالجزائر، والذي خفت حراكهما متأثرا بظروف جائحة كورونا، وكذا استمرار مخاض الانتقال نحو الديمقراطية في تونس، والتي شكلت محط أملٍ نتيجة التوافق الحاصل على المستويات الدستورية والسياسية، لكنها تعيش تقاطباً حاداً، يعكسه التغييرُ المتسارع على مستوى الحكومة، هو عودة رموز الأنظمة العاتية من بواباتٍ عديدةٍ منها المجالس الانتقالية، ومنها بوابة الانتخابات، ومنها دعم مؤسسة العسكر التي ظلت في العالم العربي جزءًا لا يتجزأُ من بنى النظام السياسي السائد.
وهكذا تسارعت وتيرةُ تنزيل حلقات الصفقة المشؤومة، صفقة القرن عبر توسيع خريطة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبالتالي وأمام ضعف وانقسامية قوى الممانعة والديمقراطية، استمر مخططُ زرع الحياة في شرايين أنظمةٍ هجينةٍ "ديمقراطياً"، تتعامل بسخاءٍ مع اشتراطات القوى والمراكز الرأسمالية العالمية، وبشحٍ سياسيٍ تحكمه جدليةُ القمع، ولعبة الديمقراطية الشكلية أو ديمقراطية الجرعات، في التعاطي مع انتظارات جماهيرَ مسحوقةٍ عريضةٍ بالداخل، والتي يزداد طلبها الاجتماعي على الحرية والعدالة الاجتماعية،وأصبحت تعبر عنها من خلال حراكاتٍسوسيومجاليةٍ محلية كما حصل بحراك الريف بالمغرب.
في الحاجة إلى النقد المزدوج
مجمل القول، ورغم قتامة اللوحة والمشهد السياسي العام، الناتج عن منعرجات وتداعيات ومخاض "الربيع الديمقراطي العربي"،فإن سيرورة الموجات الثورية لن تتوقفَ أمام هول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها سواء المراكز الرأسمالية الغربية ذاتها نتيجة أزمة 2008 وانعكاسات المرحلة الوبائية، أو الأطراف في بلدان الجنوب بفعل واقع المديونية والارتماء غير المشروط في أحضان العولمة الليبرالية المتوحشة، وتنامي الحركات الاجتماعية المناهضة للرأسمالية،وتصاعد الحركات التحررية في آسيا وأمريكا اللاتينية،وصمود المقاومة الوطنية الفلسطينية في وجه أخطبوط الاجتثاث والتصفية، في ظل انقسامية قوى الصف الوطني الفلسطيني، التي تقف جميعها شاهدةًإلى جانب الشعب الفلسطيني البطل على مؤامرةٍ دوليةٍ كبرى ومنقطعة النظير، من حيث اتساع نطاق التآمر وفاعليه في بنية المجتمعات العربية عمودياً وأفقياً، لتحويل التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى محط مصالحةٍ اجتماعيةٍ وثقافيةٍ تتجاوز طابعه السياسي الناعم الذي مارسته الأنظمة العربية في السر والعلن.
إن المطروح على قوى التحرر والتقدم في العالم العربي بشكلٍ خاص، تأمل ما وقع وقراءته قراءةً علمية، وبالتالي معاودة التفكير في تصوراتها وبرامحها، وتقوية تحالفاتها الإقليمية والدولية، والانخراط في صيرورة عولمة المقاومة ضد الرأسمالية وأذنابها المحليين، لكن قبل ذاك لا بد من أن تنظرَإلى نفسها في المرآة وتقوم بنقدٍ ذاتيٍ مزدوج، على مستويين:
المستوى الأول: نقد التصورات النظرية وأدوات التحليل والفهم المستمدة من الفكر الماركسي، على اعتبار أن ما وقع من "موجاتٍ ثوريةٍ" في العالم العربي لحدود الآن لا يرقى إلى مستوى الثورة الاجتماعية كما أصلها نظريا كارل ماركس، من خلال حديثه عن التناقض بين القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج كمحددٍ أساسيٍ لقيام الثورة الاجتماعية، مع العلم أن تحولاتٍ هائلةً ومتسارعةً شهدتها المجتمعاتُ البشرية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةوالبيئية، وبروز حركاتٍ اجتماعيةٍ عابرةٍ للطبقات الاجتماعية،وإعادة الاعتبار للفرد كذاتٍ فاعلةٍعلى حد تعبير السوسيولوجي الفرنسي "ألن تورين"،في ظل أزمة السرديات الكبرى و"نهاية فكرة التقدم،وبمستقبلٍ أفضلٍ للعلم والعقل كما يقول "فرنسوا ليوتار".
المستوى الثاني: تفكيكٌ مجهريٌ لعوامل الضعف من منطلق أن قوة "التسونامي الإسلامي" خلال الانتفاضات العربية كما يقول "جلبير الأشقر"، هي إلى حدٍ بعيد الصورة المعكوسة لضعف اليسار المنظم، ومحدودية تجدره الاجتماعي،وكذلك لأنالواقع التنظيمي المشتت والمنقسم بشكلٍ حادقد لا تكون له في العديد من الأحيان مبرراتٌ موضوعيةٌ ومعقولة، اللهم بعض حسابات التاريخ والمواقع والتقدير الظرفي والحنين إلى الزمن المفقود،أو كمال تساءل "سامر فرنجية" في مقالٍ له حول "عن اليسار كماضٍ لمن ليس له مستقبل": " هل لم يعد الصراع على اليسار إلا صراعاً تاريخياً، أو خلافاً حول إدارة وحصر إرثه، أو تنافساً حول أنسب طريقةٍ للتعايش مع عالم ما بعد القطيعة؟"، ليجيبَ قائلاً: "سؤال اليسار كمقدمةٍ لسؤال السياسة، إجابته قد لا تكون يساراً بديلاً، بل مجرد سياسة ممكنة، لا أكثر ولا أقل".