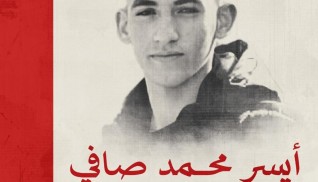بعد مضيّ ثمانيةِ أشهرٍ على اندلاعِ الحربِ العراقيّةِ الإيرانيّة، تم الإعلانُ في العاصمةِ الإماراتيّة أبو ظبي عن تأسيسِ مجلسِ التّعاونِ لدولِ الخليج العربيّة، وذلك في الخامس والعشرين من مايو/ أيار1981، كردِ فعلٍ أمنيّ وسياسيّ على ما كانت المنطقةُ تمور به من عدمِ استقرارٍ واحتمالاتِ امتدادِ شظايا الحربِ إلى العواصمِ الخليجيّة، وقد حدث ذلك فعلًا بعدَ سنواتٍ عدّةٍ من نشوبِ الحربِ التي دامت ثماني سنواتٍ عجاف، أكلت الأخضرَ واليابسَ وكلّفت الدولتينِ المتحاربتينِ مئاتِ ملياراتِ الدولاراتِ ومئاتِ آلافِ الضحايا. امتدّت شظايا الحربِ الى أكثرَ من عاصمةٍ خليجيّةٍ بما فيها محاولةُ اغتيالِ أمير الكويت الأسبق المرحوم الشيخ جابر الأحمد الصباح. في البيانِ الختامي للقمّةِ التأسيسيّةِ لمجلسِ التعاونِ الخليجي تمّ التأكيدُ فيه على أنّ "أمنَ المنطقةِ واستقرارَها إنّما هو مسؤوليةُ شعوبِها ودولِها، وأنّ هذا المجلسَ إنّما يعبّر عن إرادةِ هذه الدولِ وحقِّها في الدفاعِ عن أمنِها وصيانةِ استقلالِها". لكنّ المواطنَ الخليجي لم يُسمح له بممارسةِ مسؤوليّةٍ سياسيّة، ولم يشارك في صناعةِ قراراتِ الحربِ والسلمِ والتوجّهاتِ الاقتصاديّة، واقتصر الأمرُ على صدورِ قراراتٍ فوقيّةٍ من قبل حكوماتِ الدول. التمثيلُ المتمثّلُ في وجودِ السلطاتِ التشريعيّةِ (البرلمانات) التي تشرّع القوانين، وتقرُّ السياساتِ العامةَ الداخليّةَ والخارجيّة، وتراقب أداءَ الحكوماتِ على مختلِفِ الأصعدة، بما فيها كيفيّةُ معالجةِ الخلافاتِ البينيّةِ التي تعصف بهذا الصرحِ منذ اللحظةِ الأولى لتشكيلِه.
تعود الخلافاتُ الخليجيّةُ إلى عقودٍ طويلة، وسببُ غالبِها يكمنُ في النّزاعِ على الحدود، خصوصًا تلك التي تمّ اكتشافُ النّفطِ في محيطِها، وكذلك النّزاعُ على السيادةِ على بعضِ المناطقِ التي تعود تاريخيًّا لسيطرةِ هذه الأسرةِ الحاكمةِ أو تلك، مما تسبّب في نشوبِ اشتباكاتٍ محدودةٍ بين بعضِ دولِ مجلسِ التعاونِ الخليجي، حيث تتباين الرؤى إزاءَ مسألةِ التشاركيّةِ في إنتاجِ حقولِ النّفطِ المشتركة، وقد أدى في العديدِ من الحالاتِ إلى إغلاقِ تلك الحقولِ لمُدَدٍ ليست قصيرة.
في ظلّ هذه الإشكالاتِ، ونظرًا لعدمِ قدرةِ دولِ الخليجِ على معالجةِ خلافاتِها الحدوديّةِ داخلَ الأسرةِ الخليجيّةِ الواحدة (كما يحلو لحكومات ترديد هذه المقولة) وذهابِ البعضِ إلى المحاكم الدوليّة؛ زاد الشرخُ وبدأت الخلافاتُ في التفاقم، حتى جاء الاجتياحُ العراقيّ لدولةِ الكويت صيف 1990، الذي لم يكن الإنتاجُ النفطيّ المشترك (حقل الرميلة) بعيدًا عن أسبابهِ، وقد كلّف البلدين، العراقِ والكويت، ومعها دولُ مجلسِ التعاون الخليجي مئاتِ الملياراتِ من الدولارات، وتسبب في انتشارِ الحضورِ العسكريّ الأمريكيّ وتوسّعِه على وجهِ الخصوص في كلِّ دولِ مجلسِ التعاون. كما زادت موازناتُ التسلّحِ والأمنِ على حسابِ القطاعاتِ الحيويّةِ والخدماتِ الرئيسيّة، مثل: التّعليمِ، والصحّة، والمرافقِ العامّة، والاقتصادِ الذي لم يخرجْ من دائرةِ الاعتمادِ شبه الكلي على عائداتِ النفط، ففي حالةِ التيهِ التي سبّبها الاجتياحُ العراقي للكويت، وجد المواطنُ الخليجيُّ نفسَهُ أمامَ تحوّلٍ جديدٍ بنقلِ الخلافِ البحرينيّ ال قطر يّ على مجموعةِ جزر حوار و"فشت الديبل" إلى محكمةِ العدل الدوليّة في لاهاي، بعد أن أصرّت الدوحةُ في قمّةِ مجلسِ التعاون على هذا الأمر، بينما كانت الجيوشُ الأجنبيّةُ بقيادةِ الولاياتِ المتّحدة تعدّ العدّةَ للحربِ لطردِ العراقِ من الكويت في أواخر العام 1990 ومطلع العام التالي.
كانت الخلافاتُ البينيّةُ تختمر؛ لأنّها لم تجد طريقًا صحيحًا للمعالجة، فبدأت دماملُ التبايناتِ تكبرُ شيئًا فشيئًا، حتى تفجّرَ قيحُها في وجوهِ الجميع، وأصيب الخليجيون بحالةٍ من الذهولِ من عجزِ أنظمتِهم السياسيّةِ عن وضعِ حدٍّ لتدهورِ العلاقات، وتفاقمِ الخلافات، وتعطّلِ المشاريعِ المشتركة، التي كانت تبشّر بالوحدةِ الخليجيّة، مثل: الجواز الموحّد، وفتح الحدود أمامَ أبناء دول المجلس على طريقة الاتّحاد الأوروبيّ، وتطبيق الاتفاقيّة المشتركة، التي تمّ التوقيع عليها في العام 1983، لكنها تعثّرت في الكثير من بنودها مثل العملة النقديّة الموحّدة، حيث الخلافُ الأبرزُ على مقرّ البنكِ المركزيّ الخليجيّ، وعدم التطبيق التام لعمليّة انتقال السّلع والبضائع الوطنيّة المنشأ بين الحدود، فضلا عن عدمِ تشكيلِ صندوقٍ ماليٍّ لدعمِ الاقتصادات الأضعف، ورفع مستوى دخل مواطني هذه الدول؛ لتتقاربَ مع الدول الأكثرِ رخاء، ولم يطبّق بدقةٍ قرارُ قمّةِ المنامة منتصف تسعينات القرن الماضي بمعاملةِ المواطن الخليجيّ معاملةَ المواطن في أيّ بلدٍ عضوٍ في المجلس، وربّما البحرين هي الدولةُ الوحيدة التي طبّقت هذا القرار. لم تُستكملْ مقوماتُ الاتّحادِ الجمركيّ والسوقِ الخليجيّةِ المشتركة ومتطلباتهما، ولم تتحقّق المواطنةُ الاقتصاديّة الكاملة، ولا تزال عمليّةُ بناءِ خطِّ سكّةِ الحديد الخليجيّة التي تربط بين الدولِ الست تواجه عثرات، فضلًا عن عدمِ وضوحِ الرؤيا في حقولِ منظومةِ الأمن الغذائي والمائي، وتشجيعِ المشاريعِ المشتركة، وتوطينِ الاستثمار الخليجيّ الذي يعاني من حالةِ استنزافٍ منذ عقود.
انفجارُ الدمامل
لا يمكن للمواطن الخليجيّ أنْ يفهمَ هذهِ العثراتِ المتكرّرةَ في عمليّةِ التكامل نحو الوحدةِ الخليجيّة، وابتعادِ أهدافِ المجلسِ المعلنة عن التطبيق رغمَ إمكانيّةِ القيام بذلك، بل وبدلًا منها تتفجّر دماملُ الخلافاتِ البينيّة التي بانت صورتُها الفاقعة في يونيو 2017، عندما أعلنت ثلاثُ دولٍ خليجيّةٍ، وهي، السعودية والإمارات والبحرين، ومعها أكبرُ دولةٍ عربيّةٍ هي مصر، عن مقاطعتِها لدولةِ قطر وإغلاقِ الحدود البريّة والبحريّة والجويّة معها، وسحبِ سفرائِها من الدوحة، مطالبةً بتلبيةِ الشروط التي وضعتها الدولُ الأربع بما فيها، أنْ تتوقّفَ الدوحةُ عن دعم الجماعاتِ الاسلاميّة المتطرفة ووقفِ التقرّب من إيران، وإغلاقِ قناة الجزيرة. هذا التطوّرُ أدخل المواطنَ الخليجي في "حيص بيص" ولم يعد قادرًا على فهمِ ما يجري في الوقت الذي كان يطالب بإلغاءِ الحدود، وتوحيدِ السياسات الخارجيّة، وإشراكِ المواطن في القرار الاقتصاديّ والسياسيّ والاجتماعيّ، وعدمِ الاكتفاءِ بمجلسٍ استشاريٍّ صوريٍّ لاحول له ولا قوة، حيث تأكّد ذلك في الأزمةِ الخليجيّة الأخيرة، التي تفجّرت قبل أكثرَ من أربعِ سنوات، وما تزال مستمرّةً في غالبِ فصولِها. فخلال السنواتِ الماضيّة لم يسمع أحدٌ عن تحرّكٍ قام به المجلسُ الاستشاريّ الخليجيّ المعيّن من حكوماتِ المجلس، وكيف له التحرّكُ وهو يأتمر بأمر الحكوماتِ التي عيّنته، وكأنه وُجد ليزيدَ فتح صنبورِ استنزافِ الثروات دون فائدة؟
وبالرّغم من كلّ ذلك تمكّنت الكويت، بحكمِ خبرتِها وحنكةِ قيادتِها السياسيّة، من ممارسةِ الصبرِ الطويل الأمد على عمليات الصدّ التي واجهتها من أطراف الأزمةِ طوالَ السنواتِ الماضية، وفي نهاية المطاف وبعد أن رحل حلّاب المنطقة دونالد ترامب عن إدارة البيت الابيض، تحلحلت الأمور وتمّت عمليّةُ تدوير بعض زوايا الأزمة، وتمكّنت الكويتُ، وبمساهمةٍ حثيثةٍ، من سلطنة عمان من إحداث الاختراقِ المطلوب؛ لتكونَ المصالحةُ الخليجيّةُ العنوانَ الأبرزَ للقمّة الواحدةِ والأربعين لمجلسِ التعاون الخليجي، التي انتظمت في 5 يناير/كانون الثاني 2021 بمدينة العلا السعودية، وذلك بعد أن أعلنت الكويت عن تطوّرٍ حصل في قضية الخلاف، وأعلنت بعدها السعوديّة عن فتح الحدود البريّة والبحريّة والجويّة أمام قطر، فسارع أميرُها للإعلانِ عن مشاركتهِ في القمّة، التي أصدرت بيانًا تصالحيًّا أُعيدت من خلاله العلاقاتُ مباشرةً بين السعوديّة ومصر، من جهة، وقطر من جهةٍ أخرى، بينما ما تزال العلاقاتُ مع الإمارات والبحرين في إطارِ الهواجس والمخاوف، وتحتاج إلى رافعةٍ عملاقةٍ تزيل الجليدَ المتراكمَ طوال السنوات، وتحقّق شروط المصالحة لإعادةِ الاعتبار إلى منظومةِ مجلسِ التعاون المتصدّعة والمتعثّرة في مسيرتها.
وحيث لم تتمكّن دولُ المجلس من تحويلِ التحدّياتِ إلى فرصٍ يمكن استثمارُها بطريقةٍ صحيحة، فقد تفاجأ الخليجيون خلالَ الأسابيعِ القليلةِ الماضية بوجودِ تبايناتٍ بين السعوديّة والإمارات، تمثّلت قمّة جبل جليدها في رفض الإمارات اتّفاق "اوبك بلاس" الذي بموجبهِ تمّ التّفاهمُ مع روسيا بإبقاءِ سقف الإنتاج، بينما تجد الإماراتُ أنّها ظلمت في هذا الاتّفاق، وطالبت بزيادةِ إنتاجها بمقدار 600 ألف برميل يوميًّا، الأمرُ الذي رفضته الرياضُ؛ لتحدثَ الإشكاليةُ من جديدٍ بين دولتين خليجيتين رئيسيتين لهما مكانتهما وقدراتهما الماليّةُ والاقتصاديّة. هذا التطوّرُ قاد إلى تدحرّجِ العلاقاتِ البينيّة ففُرضت إجراءاتٌ تتعلّق بانتقالِ السلع، وفرضِ الضرائب على المناطق الحرّة، التي تشترك فيها دولٌ أخرى، خصوصًا الكيان الصهيوني؛ لتبدأَ دماملُ جديدةٌ في التشكّل قبل أن تُعالجَ الدماملُ القديمة، رغمَ أنّ هذا التباينَ بين أبو ظبي والرياض قد تم تطويقُهُ بزيارةٍ خاطفةٍ لوليّ عهدِ أبو ظبي إلى الرياض تم فيها التوافُقُ على بعض الملفاتِ محلّ الخلاف. لا يعني ذلك تراجع الرياض عن قرارٍ صدر في فبراير/شباط 2021 يُنذر فيه الشركاتِ الأجنبيّة التي تسعى للحصول على عقودٍ حكوميّةٍ بضرورة نقلِ مقرها الإقليميّ الرئيسي إلى السعودية بحلول عام 2024، علمًا أنّ غالبَ هذه الشركاتِ تتّخذ من الإمارات مقرًّا لأعمالها.
إنّ منظومةَ مجلسِ التعاون الخليجي التي تعدّ أغنى منطقةً في الشرق الأوسط وأكثرَها قدرةً على الصمود أمامَ الكوارثِ الاقتصاديّة والماليّة، ما تزال غيرَ مستفيدةٍ من الثرواتِ الفلكيّة التي جلبها النفط، وتتمتّع باقتصادٍ يبلغ حجمُه 1.64 تريليون دولار ويتبوأ المرتبة الـ13 عالميًّا، وبإنتاجٍ نفطيٍّ يبلغ أكثرَ من 18 مليون برميل يوميًّا، وتجارةٍ بينيّةٍ تزيد بقليلٍ عن 91 مليار دولار واحتياطياتٍ أجنبيّةٍ تصل إلى 620 مليار دولار، فضلًا عن الغاز الطبيعي الذي تنتجه قطر، وتتمتّع بوجودِ الاحتياطيّات الهائلة المتاحة بحقلِ الشمال الذي يحتوي على 1760 تريليون قدم مكعب، و أكثرَ من 70 مليار برميل من المكثّفات، وكميّات من الغازِ البترولي المسال والإيثيلين، علمًا أن قطر تزوّد الإماراتِ والكويت وسلطنةَ عُمان بكميّاتٍ كبيرةٍ من الغاز، تحرّك عجلةَ التنمية في هذه البلدان، وتقلّل من تكاليفِها نظرًا لقربِها من المصدر. لكن، ومع الأسفِ الشديد، فإن هذه الثرواتِ الفلكيّة – وبدلًا من استثمارِها في عجلةِ التنميةِ الحقيقيّة – تُستثمر سلبًا في تغذيةِ الخلافاتِ من جهة، وفي قطاعي الأمنِ والدفاعِ على حسابِ التعليم والصحّةِ والعملِ والمساهمةِ في دعمِ الاقتصاديّاتِ العربيّةِ من جهةٍ أخرى، التي هي بحاجةٍ ماسّةٍ إلى الدعمِ بعد أنْ فعلت التّدخُّلاتُ الخارجيّةُ فعلتَها في تلك المجتمعات.