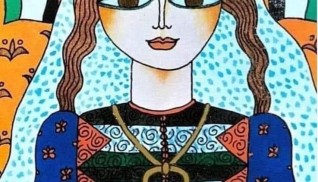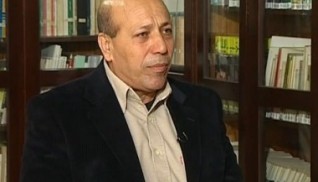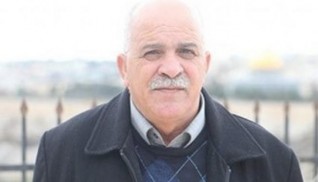تمهيد:
يحكي المؤرّخُ الشهيرُ عبد الرحمن الرافعي عن قصّةِ تأليفِهِ لسفرِهِ الضخم في التاريخ المصري فيقول: إنه بدأ عندما قرّر أن يكتب كتابًا عن مصطفى كامل بعد وفاته، وهو ما تم بعد ذلك تحت اسم "مصطفى كامل باعث الحركة الوطنيّة"، فتوصل إلى أنّ الحركة القوميّة والوطنيّة لم تبدأ بمصطفى كامل، ولا حتّى بمحمد فريد قبله، ولكنّها، تعود في جذورها إلى ردّ الفعل على قدوم الحملة الفرنسيّة في مصر (1798- 1801)، ليس فقط من زاوية المقاومة الباسلة للحملة، ولكن مع الدور الخطير الذي لعبه محمد على، بعد أن تولى والولاية لمصر من قبل العثمانيين بتدخل قوي من الزعماء الشعبيين في مصر. وكان هذا بداية الجهد الكبير في تأليف "تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر" الذي استغرقت كتابته نحو ثلاثة عقود، وخرج في ستة عشر مجلدًا يمثل كتاب مصطفى كامل المشار إليه الجزء التاسع منها؛ وسنرى لاحقا مغزى تجربة الرافعي تلك.
مقدمة
تنتشر الكتابات التي تبدأ تأريخ القومية في منطقتنا العربية بالحديث عن نشأة الفكر القومي، ودور المفكرين مثل ساطع الحصري وقسطنطين زريق وغيرهم، ويعرفون القومية العربية (أو العروبة) بأن هناك شعب واحد تجمعه اللغة والثقافة والتاريخ والجغرافيا والمصالح، وبأن دولة عربية واحدة كانت متواجدة منذ أزمنة بعيدة، وستقوم في المستقبل بتجمع العرب ضمن حدودها من المحيط إلى الخليج. وصل ممثلو تلك الحركات إلى الحكم ممثلا بالناصرية والتيار البعثي، وتميزت بقيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا عام 1958، كما شهدت محاولات وحدوية أخرى عديدة لم تستمر.
ولكن ألا يمثل هذا الطرح تصورا مثاليا يتضمن أسبقية الفكر على الواقع، حيث إن الواقع في نظر هؤلاء ليس إلا "انعكاسا للفكر"؟ بالطبع الفكر يساهم في صنع الواقع. ولكن لا يمكننا حتى الاكتفاء بجدلية العلاقة بين الفكر والواقع، مادام كلاهما يؤثر في الآخر. ما الأساس في نشوء وتطور الحركة القومية، وبالأحرى، في تحول القومية إلى أمة؟
تمثلت النشأة القديمة للقوميات منذ الانتقال من رابطة الدم التي تسود في الأوضاع القبلية، إلى الدولة التي تقوم على أساس وحدة الأرض، ووحدة السكان القائمين عليها في اللغة والتاريخ والسمات النفسية والفكرية. لهذا فإن دول العالم القديم والوسيط تتمثل في دول قومية على أساس الوحدة التي تتشكل في التاريخ بين البشر على أساس هذه الروابط. وقد عرف التاريخ، بجانب الدول القومية عرف أيضا الإمبراطوريات متعددة القوميات.
ولكن تلك الرابطة، رابطة القومية، تتطور إلى أمة تحت تأثير عامل مهم هو تطور الرأسمالية، فالانتقال من الإقطاع السابق على الرأسمالية إلى النظام الرأسمالي هو الانتقال من الاقتصاد الطبيعي إلى الاقتصاد السلعي، والتطور التدريجي للأمة هو تطور السوق الداخلية على النطاق القومي. بدأ العصر الرأسمالي عالميا منذ خمسة قرون، بينما نشأ متأخرا عنها بثلاثة قرون في منطقتنا العربية ليبدأ منذ القرن التاسع عشر.
والانتقال إلى الرأسمالية ليس مجرد إضافة تطور السوق الداخلية إلى عناصر اللغة والتاريخ.. الخ، لأن تطور السوق الداخلي يضيف ويغير من عناصر اللغة، فيطور اللهجات المحلية إلى لهجات أكثر تجانسا، كما يطور من مستوى الترابط الفكري والوجداني. كل هذا يبدأ من تطور وسائل الإنتاج، فينشأ الإنتاج السلعي، الذي ساد العالم تدريجيا واستغرق ثلاثة قرون (من القرن 15 إلى القرن 18) خلال ما عرف بمرحلة الرأسمالية الميركانتيلية أو التجارية عندما تغير الإنتاج من الإنتاج الطبيعي للإنتاج السلعي للسوق التي تزداد اتساعا، وكان هذا نتيجة لتطور الورشة الحرفية أو المانيوفاكتشر. ترابطت تلك المرحلة كما هو معروف مع حركة الكشوف الجغرافية ونشوء ظاهرة الاستعمار على نطاق أوسع كثيرا مما سبق.
ثم جاء التطور الكيفي الثاني في نهاية القرن الثامن عشر، عصر الثورة الصناعية، باختراع الآلة البخارية، لكي تسود مرحلة الرأسمالية الصناعية. كان هذا حديث تطور القومية إلى أمة في الدول المتقدمة، أما في دولنا فقد بدأ هذا التطور في مصر منذ أوائل القرن التاسع عشر، وارتبط في بدايته بحملة نابوليون، ثم في باقي مناطق الدولة العثمانية، وحفزه الاستعمار الغربي لأجزائها، لهذا ارتبط تطور القومية إلى الأمة بالتحرر الوطني من الاحتلال، ولكن أيضا بالتحديث والتطور الإنتاجي والفكري والمؤسسي على غرار الغرب الأوروبي.
التجربة المصرية
والتحول إلى الرأسمالية يتم كما هو معروف بإحدى طريقتين: الطريق الثوري الأمريكي والفرنسي من أسفل بثورة شعبية تقودها البرجوازية، والطريق البروسي الفوقي التدريجي، كما حدث في بروسيا وتوحيدها لألمانيا من أعلى، أو كما حدث في اليابان عهد ميجي. ومثال الطريق الفوقي أيضا هو دور بطرس الأكبر في روسيا، ودور محمد علي في مصر. وللتحول للرأسمالية دلالاته المتعددة سواء في مجال التصنيع أو نمط تكوين الجيوش، أو تطور التعليم وطرق إدارة الدولة.
ويلقب محمد علي (1805-1849) عن حق ب "مؤسس مصر الحديثة"؛ وهو كما قال عنه ماركس "الرأس الوحيدة تحت العمامة العثمانية". بدأ محمد علي بإصلاح الزراعة، عماد ثروة المصريين، فاعتنى بالريّ وتطهير وشق الترع وتشيّيد الجسور والقناطر. كما وسّع الزراعة السلعية التجارية والمرتبطة بالصناعات التي أنشأها، فزرع التوت لتصنيع الحرير الطبيعي، والزيتون لإنتاج الزيوت، كما غرس الأشجار لتلبية احتياجات بناء السفن وأعمال العمران. كما أدخل زراعة سلالة قطن يصلح لصناعة الملابس، بعد أن كان الصنف الشائع لا يصلح إلا للاستخدام في التنجيد. واستعان في مشروعاته الاقتصادية والعلمية بخبراء أوروبيين ومنهم السان سيمونيون الفرنسيون الذين كانوا يدعون إلى إقامة مجتمع نموذجي على أساس الصناعة المعتمدة على العلم الحديث.
ونلاحظ الترابط في مشروع محمد علي بين تطوير الزراعة والصناعة، وبين تطوير الجيش، وتطور التعليم العسكري والمدني لبناء كل ذلك على نمط الحضارة الأوروبية، فاستعان بالخبراء الأجانب، كما أرسل البعثات الأوروبية بدءا من 1813، ثم بعثة فرنسا الشهيرة عام 1826 لدراسة العلوم العسكرية والإدارية والطب والزراعة والتاريخ الطبيعي والمعادن والكيمياء والهيدروليكا وصب المعادن وصناعة الأسلحة والطباعة والعمارة والترجمة، وتبعها بعثات أخرى إلى إنجلترا والنمسا بجانب فرنسا.
وعمل محمد علي على بناء جيش حديث على الأسس العلمية فأنشأ -تدريجيا- مدرسة للبيادة (المشاه)، ومدرسة للسواري (سلاح الفرسان) وأخرى للمدفعية. كما أسس مدرسة لأركان الحرب، ومدرسة للموسيقى العسكرية، ومدرسة بحرية عملية على ظهر إحدى السفن الحربية. ووصل عدد الجيش المصري إلى 236 ألفا عام 1839، وهو عدد ضخم بالقياس لذلك العصر، وبالقياس كذلك بعدد سكان مصر الذين زاد عددهم من 2.5 مليون عند توليه إلى 4.5 مليون أواخر عهده. كان هذا الجيش أداة توسيع حكمه وتقديم المساعدة للدولة العثمانية في مواجهة أعدائها. شملت دولته في أقصى اتساعها مصر و السودان وشرق ليبيا وفلسطين ولبنان ومعظم سوريا وجزءا من تركيا، وهدد في وقت ما بدخول العاصمة العثمانية الأستانة، وهو ما دفع الدول الأوروبية (انجلترا والنمسا وروسيا وفرنسا) للتدخل العسكري لرفضهم إحلال دولة قوية محل الإمبراطورية العثمانية أو رجل أوروبا المريض، والتي يتوقون لوراثتها. انتهيت الحرب إلى هزيمة مشروعه وإجباره على الاكتفاء بمصر والسودان مع إعطائه حق توريث خلفائه فيهما.
اعتمد هذا الجيش على تأسيس الصناعات العسكرية فأنشئت المصانع لصنع الأسلحة مثل البنادق والمدافع الكبيرة والبارود. كما أنشأ ترسانة لصنع سفن الأسطول على الأنماط الأوروبية الحديثة، وقد بلغ عدد السفن الحربية التي صنعت في تلك الترسانة حتى عام 1837، 28 سفينة حربية من بينها 10 سفن كبيرة كل منها مسلح بمائة مدفع، فاستغنت مصر عن شراء السفن من الخارج.
وفي مجال التعليم أنشأ «المدارس العليا» أي الكليات بالاستعانة بالأوروبيين بدءا من عام 1816، فأسس مدرسة الهندسة (المهندسخانة)، ومدرسة المعادن، ومدرسة الطب وألحق بها مدرسة للصيدلة، وأخرى للقابلات للولادة، ومدرسة الألسن، ومدرسة الزراعة ومدرسة المحاسبة، ومدرسة الطب البيطري ومدرسة الفنون والصنائع. وبينما كان عدد من يتقنون القراءة والكتابة عندما أتى نابوليون إلى مصر لا يتجاوز 200، فقد بلغ مجموع طلاب المدارس العليا زمن محمد علي نحو 4,500 طالب.
وشملت الصناعات المدنية مصانع للغزل والنسيج، والجوخ، والكتان والحرير، والصوف، والحبال المطلوبة للسفن، وترسانة بحرية لبناء السفن (المدنية والعسكرية)، ومعمل لسبك الحديد، ومصنع لألواح النحاس اللازمة لتدريع السفن، ومعامل للسكر، ومصانع للنيلة والصابون ودباغة الجلود، وللشمع والعصر الزيوت. لهذا نمت التجارة الخارجية وازدادت حاصلات مصر الزراعية وخاصة القطن. كما لعب إنشاء الأسطول التجاري وإصلاح ميناء الإسكندرية وتعبيد طريق السويس-القاهرة وتأمينه لتسيير القوافل، دورًا في إعادة حركة التجارة بين الهند وأوروبا عن طريق مصر، فنشطت حركة التجارة الخارجية نشاطًا عظيمًا، حتى بلغت قيمة الصادرات 2,196,000 جنيه والواردات 2,679,000 جنيه عام 1836.
وطور محمد علي إدارة الدولة فأسس مجلسًا وزاريا حكوميًا عرف باسم «الديوان العالي» مقره القلعة يترأسه نائب الوالي، ويخضع لسلطة هذا الديوان دواوين تختص بشؤون الحربية والبحرية والتجارة والشؤون الخارجية والمدارس والأبنية والأشغال. كما أنه قسم مصر إداريا إلى سبع مديريات وخمس محافظات مدنية بالقاهرة والإسكندرية والسويس وغيرها. كان نظام حكم محمد علي بالطبع نظاما أوتوقراطيا، ولكنه أنشأ مجلسًا للمشورة يضم كبار رجال الدولة وعدد من الأعيان والعلماء، ينعقد كل عام ويختص بمناقشة مسائل الإدارة والتعليم والأشغال العمومية. وفي عام 1837، وضع محمد علي قانونًا أساسيًا عرف بقانون «السياستنامة»، جنينا لدستور ولكن يخلو من سلطة الشعب (!) ويحدد فيه سلطات كل ديوان من الدواوين الحكومية.
ولعب دورا بارزا في تلك النشأة أول مفكر قومي، رفاعة رافع الطهطاوي، الذي كان في بعثة 1826 إلى فرنسا، وهو الذي أنشأ مدرسة الألسن عام 1835 وأنشأ أقساماً متخصِّصة للترجمة (الرياضيات - الطبيعيات - الإنسانيات) وأنشأ مدرسة المحاسبة لدراسة الاقتصاد ومدرسة الإدارة لدراسة العلوم السياسية. وتولى رفاعة الطهطاوي نظارتها، وكانت تضم في أول أمرها فصولاً لتدريس اللغة الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والتركية والفارسية، إلى جانب الهندسة والجبر والتاريخ والجغرافيا والشريعة الإسلامية، فكانت في جوهرها بمثابة جامعة شاملة.
كما استصدر الطهطاوي قرار تدريس العلوم والمعارف باللغة العربية، وأصدر جريدة الوقائع المصرية بالعربية بدلا من التركية. وفي العقد الأخير من حياته (توفي عام 1873) أشرف على مكاتب التعليم، ورأس إدارة الترجمة، وأصدر أول مجلة ثقافية في تاريخنا، روضة المدارس، وكتب في التاريخ (أَنْوارُ تَوْفِيقِ الجَلِيل فِي أَخْبَارِ مِصْرَ وتَوْثِيقِ بَنىِ إِسْمَاعِيل)، وفي التربية والتعليم والتنشئة (مَبَاهِجُ الأَلْبَابِ المِصْرِيَّةِ فِى مَنَاهِج الآدَابِ العَصْرِيَّةِ)، (المُرْشِدُ الأَمِينِ للبَنَاتِ والبنَينِ)، وفي السيرة النبوية (نِهَايَةُ الإِيجَازِ فِي تَارِيخِ سَاكِنِ الحِجَازِ) ومن مؤلفاته أيضاً (القول السديد في الاجتهاد والتجديد) و (تعريب القانون المدني الفرنساوي). كما وأشرف على قيام تلاميذه تحت إشرافه بترجمة نحو ألفي كتاب للعربية.
وبرز موقفه من الديمقراطية والدولة الحديثة، وتبع ميراث جان جاك روسو في العقد الاجتماعي. كما استند إلى مبدأ المواطنة والذي عبر عنه الطهطاوي بصيغة «المنافع العمومية» التي تقوم على الحرية والإخاء والمساواة بين أبناء الوطن الواحد. ومن الآثار الاجتماعية للطهطاوي: تعهده لزوجته في وثيقة زواجهما بألا يتزوج عليها ولا يتسرى بجواري ولا يطلقها.
واستهدفنا من عرض تفاصيل تجربة محمد علي توضيح عدة دروس منها أسبقية التطور الاقتصادي في هذه الحالة على نشوء فكر قومي، هو ما جاء حصادا للمفكرين الذين تعلموا في أوروبا من بعثاته، وأبرزهم رفاعة الطهطاوي كما أسلفنا. كما استهدفنا رؤية دلائل الرسملة، ليس فقط في تطور الاقتصاد السلعي والسوق الداخلية ونمو التجارة الخارجية، وتطور الفنون الإنتاجية، ولكن أيضا في تطوير الإدارة ونمو الجيش وتطور التعليم.
تمدد التيار القومي جغرافيا، وتواصل تقدمه
ونلاحظ أن التطور الرأسمالي الفوقي في سوريا بدأ بإصلاحات إبراهيم باشا عندما كانت سوريا تحت سيطرته بين عاميّ 1831 و1839، وشملت التعليم والإدارة وغيرها، وهو ما تواصل بعد عام 1840، وتبدت دلائله في نشاط التجارة والتعليم وغيره. وفي فترة حكم المماليك للعراق (1747- 1831) قاموا بحركة إصلاح في الاقتصاد والنظام العسكري باتجاه الرأسمالية الفوقية أيضا. كما كان نشوء وتطور النزوع القومي العربي رد فعل على تطور النزعة القومية في تركيا على يد تركيا الفتاه وجمعية الاتحاد والترقي، حيث تم طرح مشروع التتريك، وهو ما أثار نزوعا قوميا عربيا دفاعيا ترافق مع روح العصر في التحديث والتطور الرأسمالي كما أسلفنا. ولعب المفكرون القوميون مثل ساطع الحصري وقسطنطين زريق والعديد منهم دورا هاما في تبلور وتطور الفكر القومي في المشرق العربي.
ونلاحظ أن السمة الغالبة على الفكر القومي العربي في القرن التاسع عشر هو اتخاذه طابع الإصلاح الديني، وذلك بدءا من رفاعة الطهطاوي مرورا بالكواكبي؛ ولكن يظل أكبر ممثل سياسي وفكري معا على ذلك المسرح هو جمال الدين الأفغاني الذي قاد، فكرا وحركة، تيار الاستقلال القومي والتحديث على النمط الأوروبي من ناحية الديمقراطية ونظم الحكم، وأهمية التعليم الحديث وتطوير الإنتاج. ونلاحظ التشابه مع الوضع الأوروبي حيث كانت بدايات البرجزة متمثلة في الإصلاح الديني على يد مارتن لوثر وكالفن وغيرهم. وربما جاز أن نعتبر جمال الدين الأفغاني "لوثر العرب".
في أوروبا، كانت آخر دولة قامت فيها الثورة البرجوازية، فرنسا عام 1789، تمثل الفكر الرأسمالي الأكثر نضجا بخلعه عباءة الإصلاح الديني ليصبح فكرا علمانيا على يد المفكرين أمثال ديدرو وفولتير وروسّو. وربما نجد شبيها لهذا في عالمنا العربي، فبينما تغلب تجسيد النهوض القومي في القرن التاسع عشر بالغلاف الديني، فإن انتهاء التجربة المصرية بالذات بهزيمة الثورة العرابية واحتلال إنجلترا مصر دفع لتغير مشابه. حاول محمد عبده لعب دور في تطوير التعليم الأزهري ليضم علوما دنيوية مثل الجغرافيا والرياضة، ولكن هزيمة تلك التجربة بالذات في حياته وعلى يد خلفائه، أدى إلى نشوء مشروع بديل للتعليم المدني.
نشأت فكرة إنشاء جامعة مدنية، أهلية، (التي تأسست عام 1908) على يد مصطفى كامل وأحمد لطفي السيد وقاسم أمين وغيرهم. ثم جاءت ثورة 1919 في مصر لترفع شعار الدين لله والوطن للجميع، واستندت على وحدة الهلال والصليب، لتنتج دستورا علمانيا في جوهره هو دستور عام 1923، وتبنت تحويل الجامعة الأهلية إلى أول جامعة حكومية تحت اسم جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا). ساهم التمويل الحكومي في توسعها، كما ضم الكليات العملية مثل الهندسة والطب وغيرها إلى قوام الجامعة التي كانت تقتصر قبلها على 4 كليات نظرية. وكان إصلاح التعليم على يد ساطع الحصري مماثلا في جوهره، من حيث ربط التعليم بالفكر القومي. وما أن اكتملت ملامح هذا الفكر العلماني التحديثي حتى أصبح المفكرون الدينيون ممثلين لأشد النزعات الرجعية في المجتمع. كانت حلقة الوصل بين التيارين، التقدمي والرجعي، في مصر، هي رشيد الرضا، وكان فكره أساسا لنهوض فكر الإخوان المسلمين.
ومنذ تأسيس تلك الجمعية السياسية تحت الستار الدعوي عام 1928، وهي تلعب دورا رجعيا، ممالئا للاحتلال الإنجليزي وفي مواجهة ممثل الفكر القومي والإصلاح الرأسمالي في تلك الفترة، أي حزب الوفد. واستمر الدور الرجعي بين صعود وهبوط في المراحل المختلفة بناء على قوة الاتجاه القومي أو ضعفه، ثم في مواجهة التيارات التقدمية والديمقراطية الشعبية حتى الآن. كان تأسيس الجمعية عام 28 ردا ورفضا لإلغاء الخلافة في تركيا ومطالبة بإعادة دولة الخلافة الإسلامية في بلادنا في مواجهة التيار القومي، واستمر على علاقة بالفكر الوهابي و السعودية وولّد جمعيات شقيقة في الكثير من الدول العربية، وانتهى بدور التنظيم الدولي للإخوان (نشأ عام 1982) في مواجهة ثورات الربيع العربي في القرن الحادي والعشرين.
التطور بسبب الحربين العالميتين
أدت الحرب العالمية الأولى إلى انهيار الإمبراطورية العثمانية، بجانب إمبراطوريات النمسا- المجر والنظام الملكي في ألمانيا، واختفت روسيا القيصرية ليحل محلها نظام ثوري يطمح لبناء الاشتراكية. وانعكست هزيمة الإمبراطورية العثمانية على تطلع شعوب المنطقة العربية للاستقلال، لتواجه مؤامرة سايكس بيكو والتقسيم بين فرنسا وانجلترا، ولكي تنهض الحركة القومية ضدهما مطالبة بالاستقلال. لم يتحقق الاستقلال إلا أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية، واستفاد من بزوغ تناقض بين زعيمة المعسكر الإمبريالي الجديدة أمريكا والمستعمرين الكولونياليين القدامى، إنجلترا وفرنسا.
في أعقاب الحرب العالمية الثانية لم تكن الطبقات البرجوازية العربية قد استكملت بعد تحولها الرأسمالي بالكامل، فقد استغرق هذا التحول نحو قرن ونصف، ولم يتم إلا في خمسينيات وستينيات القرن العشرين. ولكن الحركة الشعبية والديمقراطية واليسارية قد تطورت بشدة في مواجهة الاحتلال والتخلف والاستبداد بأنواعه. وكانت حركة البرجوازيات القومية، هي والحركة الشعبية، هما فرسا رهان مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وكان مستوى قوة الحركات الشعبية وتهديدها للرأسمالية كافيا لكي يلعب دوره في نشأة الاستبداد القومي. انتصر الاتجاه القومي الناصري ببرنامجه الوطني الطامح للاستقلال السياسي، والحريص على حل المشاكل أمام المزيد من تطور الرأسمالية سواء بتوسيع السوق عن طريق تحديد الملكية الزراعية، أو بتدخل الدولة في التصنيع بدءا بالحديد والصلب لمد رأس المال الخاص بما عجز عن صنعه. ولكن هذا البرنامج أيضا تضمن، تحت عنوان إقامة حياة ديمقراطية "سليمة" اجتثاث الحزبية ومعها درجة حريات التعبير والصحافة الموجودة، والهجوم على اليسار والحركة النقابية.
لجأ حزب البعث في سوريا للوحدة مع مصر بسبب عجزه في مواجهة تنامي اليسار، ونجحت "الوحدة" في تحقيق هذا الهدف، فكان الانفصال! وفي العراق كان الانقلاب على عبد الكريم قاسم ممثل التيار القومي بعد 1958، بسبب رفضه تقييد الحزب الشيوعي وإتاحته مساحة للحريات الديمقراطية. ومثل انقلاب 1963 حلقة هامة في تمكين الرأسمالية القومية (مثل مصر وسوريا، سواء بشكلها الحر أو كرأسمالية دولة) من إتمام التحول الرأسمالي، وكذلك من القضاء على الحركة الجماهيرية ومنظماتها الحزبية والنقابية، مع الإطاحة بكافة حريات الصحافة والتعبير. وهكذا تحقق البرنامج القومي بالاستقلال السياسي، والاستقلال الاقتصادي النسبي مع درجات من تحديث الهيكل الإنتاجي واستئصال العلاقات السابقة على الرأسمالية. كما نجحت في خطتها ل "تأميم الصراع الطبقي" بإقامة مجزرة واسعة للحركة الديمقراطية والشعبية. وتحققت تلك النتائج في دول مستقلة، مصر وسوريا والعراق، بجانب الجزائر المستقلة، ومع امتدادات التيار القومي في اليمن وليبيا والسودان، بالطبع مع تفاوتات بينها.
ولهذا لم يتحقق وجود طبقة رأسمالية موحدة، وبالتالي لا وجود لطبقة عاملة عربية موحدة. ولكن تلك الأنظمة لم تستطع طويلا الحفاظ على هذا الاستقلال، لأن معاداة الاستعمار بأسلحة من نوع اللعب على تناقضات المعسكرين الاشتراكي والإمبريالي، في ظل تصفية حركة وتنظيم الجماهير، وهي العدو الحقيقي للإمبريالية، ليس لها مستقبل. ومثلت الهزيمة في حرب 1967 مأساة كاملة، ليس فقط لتلك الأنظمة، ولكن أيضا للجماهير. لقد عجزت البرجوازية عن استمرارها في العداء للاستعمار، لتعود تحت ضغوط أزمتها الاقتصادية والهزيمة العسكرية، إلى التبعية الجديدة للمستعمرين القدامى. وانعكس إفلاس الإيديولوجية البرجوازية زمن خضوعها للاستعمار، مع غياب بديل ديمقراطي وثوري بحكم تصفية تلك القوى، انعكس على مرحلة من الردة سيطر فيها الفكر الوهابي الرجعي، متزامنا مع الفورة البترولية عام 1973 وهجرة العمالة إلى الخليج. كما ظهرت آثار الهزيمة على تغول القوى الإقليمية المعادية، إسرائيل وتركيا وإثيوبيا، والهوان القومي بالذات متجسدا في أزمات المياه في مصر وسوريا والعراق.
الفصل الراهن واستنتاجات ضرورية
لم تكن هناك أمة عربية منذ فجر التاريخ. كانت هناك قومية عربية، وارتبط تطور القومية إلى أمة بتطور الرأسمالية (مع ملاحظة أننا نستعمل هنا مصطلح القومية بمعنى الأمة لأن هذا هو الشائع، ولأن نسبة الموضوع إلى الأمة "باسم أممي" سيخلطه بالمعنى العالمي). ولكن عجز البرجوازيات القومية عن تحقيق وحدة قومية عربية لا يعني سوى أنه كانت هناك أمة عربية في طور التكوين، ولكنها، في ظل سيطرة الطبقات البورجوازية، قد فشلت. ولكن هذا لم يلغِ الرابطة القومية بين الدول العربية (اللغة الجغرافيا، التاريخ، والسمات الثقافية والنفسية)، ولكنه نقلها من المحور البرجوازي المعادي للاستعمار كما كان الحلم وقتها، إلى المحور الشعبي المناهض لكليهما. أصبحت أمة في طور التكوين على يد الطبقات الشعبية. يربط تلك الشعوب، فضلا عن العناصر السابقة، برنامجها المشترك ضد أعدائها من الإمبريالية والتخلف والفساد والاستبداد، وأيضا نضالها من أجل تغيير ذلك الواقع.
ولعل أبرز دليل على حقيقة الترابط بين الشعوب العربية هو ما حدث فيما عرف بثورات الربيع العربي أعوام 2011-2013. لقد أوضح تسلسل الثورات من بلد لبلد مدى الترابط والتأثير المتبادل، ولم يقتصر هذا على الثورات التي أطاحت بالحكام الموجودين في تونس ومصر واليمن وليبيا، ولكنه امتد أيضا ممثلا في انتفاضات قوية في المغرب و الأردن والعراق، بل وحتى أصداء في السعودية والخليج، والتي حققت مكاسب ديمقراطية و/أو حياتية هامة في مواجهة حكامها. كما جاءت الموجة الثانية من الثورات والانتفاضات في الجزائر والسودان ولبنان والعراق أيضا لكي تؤكد على نفس حقيقة الترابط الكفاحي للعرب في مواجهة أعدائهم المشتركين والمتشابهين. لقد مثلت تلك الثورات والانتفاضات في حلقتيها أول وأضخم رجوع جماهيري لساحة النضال منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
ونلاحظ أن تطور ثقة الجماهير بنفسها وبقوتها بعد نجاحاتها في الإطاحة بأنظمة وتغيير سلوكيات هامة لأنظمة أخرى. كما نلاحظ انعكاس هذا على هزيمة تيار الإسلام السياسي بفصائله المختلفة، وهذا بالطبع في مجال السياسة، ولكن في مجال الإيديولوجيا لا زال هناك الكثير مما ينتظر النضال من أجله. كما نلاحظ أن الفكر القومي الموجود حاليا بقوة على الساحة السياسية ليس فكرا برجوازيا، فلا يوجد فكر لطبقة انتهى عهدها؛ ولكنه فكر جديد، وسابق طبعا للربيع العربي، فمنذ انتهاء مرحلة عداء الأنظمة للاستعمار وبيع أممها للهوان، تغير الفكر القومي. لقد أصبح فكرا ديمقراطيا يتحالف مع كل التقدميين، ويشترك معهم بالكامل في البرنامج المعادي للاستبداد والفساد والتبعية الاستعمارية. لهذا فبالنسبة للبرنامج يشملهم البرنامج التقدمي مع كل التقدميين، وتبقى خلافات إيديولوجية مثل تعلق بعضهم بحلم إمكانية تحقيق اتحاد عربي عن طريق الأنظمة ولو على غرار السوق الأوروبية، وهو ما يحل فقط في إطار الحركة التقدمية الفعلية في الشارع.
وبالطبع فقوانين الثورات لا تتضمن حلقة واحدة ولا تسير في مسار واحد صعودي حتى تحقيق أهدافها، ولكنها تمر بمراحل تقدم وتراجع، ولكم ما حدث لا ينقضي نتيجة هذا التناقض. وأخيرا لم استهدف هنا تأريخ الحركة القومية العربية، ولكنه، كما ينص العنوان، مجرد لمحات متفرقة، نهدف منها إلى حوار واسع مع جميع السياسيين والمفكرين التقدميين في سياق تنمية حركة فكرية- جماهيرية تقدمية في منطقتنا العربية تهدف للمساهمة في صنع مستقبلها.