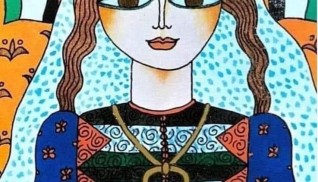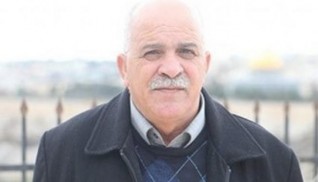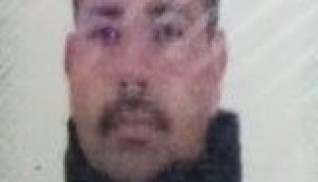إن تقويض قدرة المنظومة السياسية الفلسطينية، بالإنهاك والتضييق والانقسام وتجفيف مصادر "الشرعية"، قد يشكل مدخلًا لتقويض المشروع الوطني، خصوصًا إذا ما رافقه محاولات تقويض ركائز مجتمع "الصمود" ومقوماته.
ففي ظل التسوية انتهى جدل وحدة النظام وانقسامه إلى نظامين للسيطرة "دون سيادة" أحدهما في الضفة الغربية والثاني في غزة. هذا ويكاد ينتهي جدل بناء وتفكك "الشعب، المجتمع، الإجماع" إلى تكريس التجزئة الناشئة عن فعل الاقتلاع والتشريد.
لا أحد يدري إلى أين يمكن أن تصل الإدارة الأمريكية في خطتها المعنونة بصفقة القرن وقد أصاب أولى مراحلها (ورشة البحرين ) بعض الفشل، حيث يمكن النظر إلى الورشة بوصفها حدثًا كاشفًا، يبرز أهم الديناميات السياسية المصاحبة للحدث أو المؤسسة له أو الناجمة عنه، وما اعتراها من وهن أو قوة، وما أصابها من تبدل أو تحول في مجرى الأحداث العاصفة التي يشهدها الإقليم على الأقل منذ 2011.
من بين هذه الديناميات/الظواهر، الاتجاه المتزايد في تفكك المنظومة الخليجية بالرغم من انتقال مركز الثقل إليها في أعقاب أحداث "الربيع العربي"، أيضًا وصول الاستراتيجية الأمريكية إلى مرحلة جديدة بعد أن طرأ عليها تعديلات جوهرية. الدينامية الثالثة، موضوع هذه المقالة، صيرورة النظام السياسي الفلسطيني بعد 25 عامًا على أوسلو، وعلى وجه التحديد قدرته على القيام بوظائفه في السياق الفلسطيني ومواجهة التحديات وتلبية المطاليب المستجدة.
قبل الولوج في شرح كيف وصل النظام إلى ما وصل إليه من ضعف وهوان وانعدام قدرة، سوف أعرض أبرز مظاهر هذا الضعف والهوان وانعدام القدرة وتداعيات ذلك:
- لعل أخطر التمظهرات ما يمكن أن أطلق عليه "انكشاف النظام" بسبب انقسامه، أمام المؤثرات الخارجية بينما تتراجع/أو حتى تغيب في حسبان القائمين على شقيه اهتمامات ومصالح وهموم الناس الذين يمثلهم ويدير شؤونهم ويقود معركة التحرر والبناء باسمهم.
- مراوحة المواقف المعلنة بين الرفض الذي يصل أحيانًا حد الإفراط، وبين التجريب الذي يوغل حد التفريط، وهي آفة لطالما صاحبت العقل السياسي الفلسطيني الذي يبدو أنه لم يتعلم من التجربة المديدة.
- التردد غير المفهوم في القيام بخطوات عملية وجادة، على الأقل طبقًا لمقررات هيئات النظام ومؤسساته، المجلسين الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية والرئاسة وحكومة السلطة، أو دعوات ومطالب الجمهور الفلسطيني ونخبه، أو التوافقات والاتفاقيات التي تبرم برعاية إقليمية أو محلية.
- في سياق توقف العملية الديموقراطية، وخصوصًا المساءلة والمحاسبة، تستشري مظاهر الفساد والتقويض الذاتي؛ ويزداد التغول على مساحة الحريات والحقوق، وتتفاقم عمليات الاستئثار بالموارد والتفرد بالقرارات، وأيضًا التوزيع غير العادل للخيرات العامة وللأعباء.
- تراجع الآمال التي انعقدت على بلورة تجاه ثالث يشكل توازنًا داخل النظام ويحول دون الاستقطاب الثنائي الذي يورث السياسة الزائفة أو السياسية القمعية. اندراج التنظيمات السياسية الأخرى ضمن منطق الانقسام واقتصاده السياسي "إنتاج وتبادل وتوزيع الأدوار والمنافع، وخلق التبريرات والمسوغات"، وأيضًا ضعف المجتمع المدني واندراج أغلب تنظيماته في نسقي السلطة المشطورة أو المعونة الخارجية الملغومة.
ولكن كيف وصلنا إلى هنا؟
(1) جدل الوحدة والانقسام في إطار الاحتلال وممارساته: مع أوسلو وبسببه، تقلصت "فلسطين" الحلم والهوية والكيان والمشروع، جغرافيًا ومؤسسيًا وسياسيًا. والسلطة الناشئة سرعان ما تحولت إلى شبه دولة يخترقها الفساد وغير قابلة للمساءلة، والسمة الغالبة للحقل المتشكل في إطارها الانفتاح على مؤثرات خارجية مقررة وشديدة الوطأة والأثر على الفاعلين وعلى عمليات الإنتاج والتبادل، بهدف تحقيق الهيمنة على الحقل والسيطرة على النظام وخصوصًا المؤثر الإسرائيلي، وقد ارتبط بذلك دخول هؤلاء الفاعلين في صراع فيما بينهم وصل حد العداء، قبل أن ينجز الحقل السياسي وظيفته الأساسية وهي حسم الصراع مع "الآخر" أي المحتل الإسرائيلي.
غلب على سلوك الفلسطينيين صراعهم حول القيادة والتمثيل والمنافع أكثر من التركيز على مواجهة المخطط الإسرائيلي، حتى بدا وكأنهم "يتكيفون" مع الواقع والوقائع. وساد في أوساطهم "منطق الانقسام" المتمثل في "التعزيز المتبادل" بين المتخاصمين، الذين "نجحوا" في حرف الاهتمام عن الأجندة الفعلية للفلسطينيين.
وعليه، يمكن قراءة التاريخ الفلسطيني بوصفه جدلية التفكك والبناء على المستوى المجتمعي، الوحدة والانقسام على مستوى النظام السياسي، وهي جدليات أضمرت السعي نحو هوية وطنية مشتركة وكيانية سياسية تمثلهم وتعبر عن طموحاتهم. وفي سعيهم هذا تعرضوا تحت تأثير عوامل طاردة إلى انقسامات عديدة، تارة بسبب اختلاف مشاريعهم واختياراتهم السياسية والأيديولوجية، وتارة أخرى بسبب الطبيعة التقليدية والانتقالية لمجتمعاتهم، ودائمًا بسبب الاحتلال الإسرائيلي الإحلالي والاستيطاني.
اعتمدت الاستراتيجيات الإسرائيلية في مواجهة هذا السعي علاوة على استخدام العنف بأشكاله، على فكرة "تأجيج الصراع داخل الحقل السياسي الفلسطيني"، وتقويض نظامهم وتفتيت هويتهم وضرب كيانيتهم الناشئة، وبالتالي مفاقمة التجزئة الذاتية، مع تعزيز "صناعة الوهم" داخل الحقل السياسي حتى أورثتهم، مع الفصل والتحكم عن كثب، ظاهرة استلاب القدرة. عملت هذه الظاهرة في سياقين؛ مجتمعي، متعين بحقيقة الطابع الانتقالي للمجتمع، بين التقليد والحداثة، وبين البناء والتفكك. والثاني، إقليمي دينامي ومعقد في ظل محاولات تطبيق إستراتيجية التجزئة والتفكيك وإعادة تركيب الإقليم بما يحقق المصالح الأمريكية.
(2) استمرار العملية المتناقضة والجارية منذ 2011 والمتمثلة في انتقال مركز الثقل في الشرق العربي من محور بلدان المركز (مصر، سوريا، العراق) إلى بلدان الطرف (دول الخليج العربي)، ووصولها إلى نقطة حاسمة: تجاوز المسألة الفلسطينية وربما المساومة عليها، وفي ذات الوقت تفاقم عمليات تفكك المنظومة الخليجية وتعارض مكوناتها! في غضون ذلك لعب هذا المركز ومكوناته دورًا في تعزيز أزمة النظام الفلسطيني وتغذية أسباب الفرقة، واستخدام الورقة الفلسطينية في الصراعات الإقليمية، وفيما بين دول الخليج ذاتها.
استخدمت دول الخليج وخصوصًا السعودية و قطر الدعم المالي، التحالف مع الإسلام السياسي، الإعلام إلى جانب وسائل عديدة أخرى للتأثير في مجرى الحدث الفلسطيني. ومن الأشياء التي سهلت التأثير ضعف المركز القديم (العراق، مصر، سوريا). بالمناسبة ترافق تراجع مركز الثقل القديم مع بزوغ استراتيجية أمريكية جديدة في المنطقة (1991)؛ فمنذ ذلك التاريخ تراجعت النزعة الجمهورية، وأيديولوجيا العداء للإمبريالية، وبهت حضور القضايا القومية وخصوصًا القضية الفلسطينية. فالمركز الجديد يخضع بالكامل للهيمنة الأمريكية، وهو جزء من استراتيجيتها، حيث ترافق مع هذا الأمر اندفاعة خليجية نحو إسرائيل: (انتقال من الصدام إلى التعايش إلى التحالف).
(3) التأثير الأمريكي (راعي غير عادل، ضغوط مالية وسياسية ودبلوماسية) من حيث العمل على تفكيك المنطقة وإضعاف قواها الفاعلة! أطلق بوش الابن المارد الديني، قوض بنيان العراق، أعطى وعدًا مشؤومًا مشفوعًا بهياكل دعم وإسناد لإستراتيجية الفصل وخلق الوقائع على الأرض. وأطلق أوباما المارد الطائفي، وساهم في تقويض فرص التحول الديمقراطي ومعه بنيان مجموعة أخرى من الدول، ومهد الطريق للتدخل الخارجي، أطلق يد إسرائيل وقدم لها دعمًا غير مسبوق.
إدارة ترامب/ انطلاقًا من شعبوية طاغية، وانحياز غير مسبوق وتبني شعار "أمريكا أولا"، تواصل تطبيق الإستراتيجية الأمريكية في شقها الفلسطيني تحت مسمى "صفقة القرن" انطلاقًا من ثلاثة محددات: تأثير اليمين الإسرائيلي الديني-القومي، عقلية تاجر العقارات، إعادة هيكلة الشرق الأوسط في إطار مواجهة الصين الصاعدة.
في الختام،،
ومع ذلك، فالهيمنة الأمريكية في طريقها للتراجع والانحسار، وإسرائيل "القوية" اليمينية والتي لا تخلو سياستها الخارجية من صلف وغطرسة، تواجه معضلة شبه وجودية تتعلق بإعادة التموضع ضمن جغرافيا سياسية جديدة، وبالعلاقة مع ذاتها "طبيعتها"، ومع جوارها (مع الفلسطينيين والعرب)، ومع العالم الذي يشهد أزمة بنيوية مرتبطة بفكرة الديمقراطية والسوق في إطار الليبرالية الجديدة المعولمة.
وعلى ذلك، صحيح أن الفلسطينيين ربما يتكبدون الخسارة الأكبر، لكن لا يوجد أحد غيرهم قادر على عرقلة المخطط الأمريكي. ما يعيق ذلك (1) تحول "السلطة" إلى أداة للخضوع وموضوع للابتزاز (2) الانقسام في سياق الفصل والانفصال (3) عزوف أو عزل المجتمع عن السياسة (4) ويبقى النظام السياسي نقطة الضعف الأساسية. هذا النظام غير قادر على الجمع بين مهمتي البناء والتحرر، إلا في إطار حقل سياسي يقوم على ركيزتي الانفتاح (الانفكاك عن الاستراتيجية الأمريكية وليس فقط وقف الاتصالات مع الإدارة) والتعددية.
بالتأكيد، إن أي شيء يتعلق بعملية "البناء" في ظل الاحتلال وقيوده، لا يمكن أن يتم إلا ضمن "مشروع" ترضى عنه إسرائيل أو حتى تكون طرفًا فيه، وأن عملية التحول الديمقراطي والتنمية سوف تفشل بالضرورة نظرًا لانتفاء شرطها الموضوعي، السيادة والاستقرار والاتفاق العام على قواعد العملية السياسية.
أخيرًا، المنظومة السياسية الفلسطينية في حاجة إلى إعادة موضعة ذاتها في إطار الجغرافيا السياسية المنبثقة ما بعد 2011، وتحديد الجانب المناسب لها من المتراس، ارتباطًا بخطوط الصدع والتحالف الناشئة.