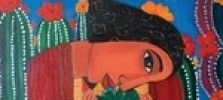مقدمة:
طالما اُعتبرت القضية الفلسطينية القضية المركزية للدول العربية، وعُبر عن ذلك من خلال تبنيها لها رسميًا، سواء على مستوى كل دولة على حدة أو مجتمعة، من خلال جامعة الدول العربية التي عبرت عن ذلك من خلال قممها المتتالية والقرارات التي صدرت عنها صعودًا وهبوطًا. ولقد أولت القيادة الفلسطينية تاريخيًا أهمية كبيرة لجامعة الدول العربية ودورها إزاء القضية الفلسطينية، وحاولت دائمًا أن تحتمي في ظلال قراراتها في دعم القضية الفلسطينية من جهة، وخيارات تلك القيادة حربًا أو سلمًا.
بعد ما يزيد عن سبعين عامًا من الصراع الإسرائيلي العربي، لا يزال هذا الصراع مفتوحًا على مصراعيه، ويتخذ أشكالًا وأبعادًا ومستويات متعددة، في ظل تغييرات جوهرية في بيئة جامعة الدول العربية، سواء على صعيد النظام الدولي، الذي لا يزال خاضعًا بشكل كبير لاستراتيجيات وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية، أو على صعيد النظام الإقليمي الذي يعيش حالة من الاستقطاب والتجاذب والصراع مع العديد من الدول العربية، مرورًا بالصراعات العربية البينية، وحروب الوكالة، والحروب الأهلية، وبروز النعرات الطائفية، وصولًا إلى التغيّرات التي طالت بنية جامعة الدول العربية نتيجة ذلك، وما ألحقته من ضرر بالغ أدى إلى تآكل وتفكك وانهيار ما تعارف على تسميته بالنظام السياسي العربي؛ دورًا وهيبةً وتمثيلًا.
إن هذا الواقع يفرض تحديات متعددة ومتنوعة أمام جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية، وخاصة لجهة إمكانية وكفاءة واقتدار أن تقوم بالأدوار والمسؤوليات المناطة بها، مقارنة بأدوار المنافسين الإقليميين وخاصة: إيران، و تركيا ، وإسرائيل، والتدخل الدولي غير المسبوق في شؤون المنطقة، وخاصة من قبل الولايات المتحدة.
تأسيساً على ما تقدم، وفي إطار تأكيدنا أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية بامتياز، انطلاقًا من أن جوهر الصراع هو صراع بين الأمة العربية من جهة، والمشروع الصهيوني من جهة أخرى، يقف الشعب الفلسطيني رأس حربة فيه. وعليه؛ فإن مستقبل القضية الفلسطينية رهن صلاح بيئة وبنية الوضع العربي ومؤسساته ومنها على نحو أخص، جامعة الدول العربية، وقدرة مواجهة التحديات بفاعلية النظام العربي المتكامل في مسؤولياته وأدواره؛ إلا أن جامعة الدول العربية في سيرورتها التاريخية منذ نشأتها وإلى الواقع القائم اليوم، تعرضت إلى تغييرات طالت البيئة التي تعمل وسطها، عكست نفسها على بنيتها وعلاقاتها الداخلية واتجاهاتها السياسية، لجهة التعاطي مع القضية الفلسطينية، خاصة لجهة إمكانية حمايتها وتحقيق الحقوق الفلسطينية، في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، وهذا ما حاولت الدراسة تناوله بالبحث.
أولًا: تحولات البيئة السياسية العربية وأثرها على القضية الفلسطينية
تعرضت البيئة التي تعمل وسطها جامعة الدول العربية إلى تغيّرات عديدة منذ نشأتها في عام 1945، وكان أول تلك التغيّرات الكبيرة هي الغزو الصهيوني لفلسطين، حيث اضطلعت الجامعة بدور التصدي له، من خلال تشكيل جيش الإنقاذ والمساهمة في "حرب تحرير فلسطين"، من خلال مشاركة العديد من الدول العربية فيها ودخولها إلى أرض فلسطين.
كان من النتائج المباشرة لتلك الحرب التي احتُل فيها 78% من مساحة فلسطين الانتدابية، سقوط النظام الملكي في مصر بعد نجاح الانقلاب الذي قاده الضباط الأحرار، واشتهر فيما بعد بثورة 23 يوليو 1952، حيث شكلت تلك الفترة حالة من النهوض للعمل القومي العربي، كانت القضية الفلسطينية ومواجهة الأطماع الاستعمارية تمثل الحلقة المركزية فيها. ووسط هذه البيئة، واجهت مصر ومعها الجامعة العربية العدوان الثلاثي (البريطاني، الفرنسي، الإسرائيلي)، واستطاعت أن تصمد في وجه هذا العدوان وأهدافه. وكذلك، ساهمت الجامعة العربية في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية؛ لتتحمل مسألة النضال على الجبهة الفلسطينية. ورغم الآثار الكارثية التي خلّفتها هزيمة عام 1967، إلا أن الجامعة العربية أعلنت لاءاتها المشهورة: لا صلح، لا تفاوض، لا اعتراف، لكن ذلك لم يستمر طويلًا؛ فمنذ أواسط السبعينيات من القرن الماضي وصولًا لتوقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، وما ترتب عليها من مقاطعة مصر ونقل مقر جامعة الدول العربية إلى تونس، كان قد تغير الكثير في التفكير السياسي العربي تجاه القضية الفلسطينية، التي كانت أكثر المتأثرين بتلك التغيّرات التي يعمل وسطها النظام السياسي العربي، والتي ازدادت تأثيراتها السلبية، في ضوء التغيرات الإقليمية والدولية منذ أواخر ثمانينيات القرن المنصرم والتي سنتناولها من خلال ثلاثة بيئات رئيسية.
1. بيئة اللا توازن
يمكن أن نطلق عليها أيضًا بيئة "انكشاف النظام"، حيث تولّدت تلك البيئة أثر انهيار الاتحاد السوفييتي أواخر ثمانينيات القرن المنصرم، وفقدان توازن القوة على الصعيد الدولي، من خلال تسيّد الولايات المتحدة الأمريكية كقطب أوحد على رأس النظام الدولي، وكانت المنطقة العربية الأكثر تأثرًا واستهدافًا من غيرها بتغييرات تلك البيئة، والتي تمثل بشن الحرب على العراق تحت مبرر تحرير الكويت عامي 1990-1991، وهي حرب شنتها وقادتها الولايات المتحدة بمشاركة 34 دولة، كانت المشاركة الأبرز في ذلك التحالف، هي المشاركة والتمويل العربي دون الوقوف مليًا أمام الدور المناط بجامعة الدول العربية إزاء الخلافات العربية - العربية، وفق مواثيقها ومقرراتها، والأخطر دون التدقيق في الأهداف والمرامي التي تعمل بموجبها استراتيجية الولايات المتحدة، في تحالفها العضوي مع إسرائيل.
ومن الجدير ذكره هنا، بأنه في ثمانينيات القرن الماضي، وضع عوديد بينون وثيقة بعنوان: (استراتيجية إسرائيل في الثمانينيات)، ونشرها في مجلة "كيوفونيم" (اتجاهات) الإسرائيلية، وهي تظهر بوضوح وبشكل تفصيلي المشروع الإسرائيلي، القاضي بتقسيم المنطقة العربية إلى دويلات صغيرة وطائفية ومتناحرة، وكانت العراق أكثر الدول العربية مرشحة للاستهداف من قبل هذا المشروع، ارتباطًا بقوة العراق وثروته النفطية. فالعراق الغني بالنفط من ناحية، والممزق داخليًا بالتركيبة الطائفية من ناحية أخرى، اعتبر مرشحًا مضمونًا للأهداف الإسرائيلية، وعليه؛ فإن تمزيق العراق يعد أكثر أهمية بالنسبة إلى غيرها من الدول العربية، حيث شكلت قوة العراق في حينه أكبر تهديد لإسرائيل[1]، بعد خروج مصر من هذه المعادلة بتوقيعها اتفاقية كامب ديفيد.
ولعل أبرز ما أكدته تلك البيئة، هو عدم قدرة النظام الرسمي العربي ممثلًا في الجامعة العربية، على حل الخلافات العربية بأدوات ووسائل وأهداف عربية، ترتكز إلى ميثاق الجامعة الذي أكد في بنوده على إقامة وطن عربي مع احترام سيادة الدول الأعضاء، وأن الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المُشتركة فيها، وتنسيق خططها السياسية، تحقيقًا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها، والنظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها؛ حيث برز تأثير بيئة اللا توازن أو الانكشاف تلك على القضية الفلسطينية، بعد انتهاء الحرب على العراق بأسبوع لا أكثر، من خلال إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب، عن ضرورة تسوية مشكلة "الصراع" الفلسطيني الإسرائيلي، حيث انعقد مؤتمر مدريد للسلام في أكتوبر 1991، وصولاً لاتفاق أوسلو وما ترتب عليه من نتائج لم تراعِ الحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية.
إن ما كان يحرك الولايات المتحدة إدراكها لأهمية منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لها، وفي تحقيق أهدافها الاستراتيجية في السيطرة على ثروات المنطقة وبخاصة النفط، وأن مدخل وقف حالة التوتر الدائمة في المنطقة بعد أن أنجزت مهمتها في العراق، هو إيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي، باعتباره محرك الغضب لدى الشعوب العربية، كما أن النظام الرسمي العربي كان يأمل بضغط أمريكي –دون غيرها -على إسرائيل في إيجاد حل للقضية الفلسطينية[2]. هذا من جانب، لكن من جانب آخر أيضًا، كان هذا النظام قد فقد أحد مرتكزات قدرته على مواجهة الواقع الجديد، من خلال فقدان وحدة موقفه وتماسكه الداخلي الذي توضح أكثر في الانقسام الذي حدث بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.
2. بيئة التفكك
يمكن أن نطلق عليها أيضًا بيئة "الانفراط" التي ترافقت مع إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن الحرب على ما سُمي بالإرهاب، وما ترتب على ذلك من غزو أمريكي واحتلال للعراق في عام 2003، بمساعدة دول أخرى مثل: بريطانيا وأستراليا وبعض الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة، وإقامة حكومة موالية للولايات المتحدة، دون قدرة جامعة الدول العربية على الحيلولة دون ذلك، بل هناك من الدول العربية من لعب دور المحرض على الحرب والممول لها.
كان من أبرز ما ترتب على تلك البيئة، هو ما عرف "بوعد بوش" الذي كشف عنه خلال مؤتمر عُقد في واشنطن في 14 أبريل 2004، من خلال الرسائل المتبادلة بين بوش ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرئيل شارون، وتضمنت تقديم وعود وضمانات أمريكية لتنفيذ خطة شارون بالانسحاب من قطاع غزة. وقد خلصت تصريحات جورج بوش إلى صياغة رؤية جديدة إلى الإدارة الأمريكية تتجاوز كل "الخطوط الحمراء" التي وضعتها لنفسها الإدارات الأمريكية السابقة، كما تتجاوز قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبذلك وضع أسسًا جديدة للإدارة الأمريكية تتعامل من خلالها مع الصراع الإسرائيلي العربي، ويمكن تلخيص تلك الأسس فيما يلي[3]:
- ضرورة تخلي اللاجئين الفلسطينيين عن حق العودة إلى أراضي عام 1948 التي أُقيمت عليها دولة إسرائيل، ويمكن توطينهم في دولة فلسطين (أي الضفة الغربية وقطاع غزة) وليس داخل إسرائيل.
- لإسرائيل الحق في الاحتفاظ ببعض "المستوطنات" (المستعمرات) في الضفة الغربية، حفاظًا على أمنها واستقرارها وحلًا لإشكاليات ديموغرافية في إسرائيل.
- من غير الواقعي توقيع اتفاق سلام نهائي بانسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل 5 يونيو 1967، على اعتبار أن هذه الحدود ليست مقدسة ومن ثم يمكن تجاوزها.
- المنطقة التي منحها بوش للاستيطان الإسرائيلي، تشمل القدس الكبرى وتحيط بالمدينة المقدسة من كل جانب.
- الالتزام الأمريكي بسلامة الدولة اليهودية وبقائها واستمرارها، أي أن بوش أكد يهودية الدولة الصهيونية وأن شرعيتها تستند إلى يهوديتها، مما يعني قبول الفكرة الصهيونية القائلة: بأن حقوق اليهود المطلقة في فلسطين تحجب وتهمش حقوق الفلسطينيين.
ترتب على ذلك الوعد، انطلاق الدعوة للاعتراف بيهودية دولة إسرائيل التي باتت ملازمة للسياسة الأمريكية والإسرائيلية منذ عام 2003، عندما عُقدت القمة الثلاثية التي جمعت كل من أرئيل شارون وجورج بوش (الابن) ورئيس الوزراء الفلسطيني محمود عباس في يونيو 2003، أي بعد شهر من احتلال العراق، وأكد خلالها شارون على مطلب الاعتراف العربي والفلسطيني بيهودية الدولة، حيث لم يسبق أن طُرح هذا المطلب في أيّ من جولات المفاوضات التي جرت فيما قبل، أو حتى اللقاءات الثنائية بين الطرفين الفلسطيني الإسرائيلي، بهذا الوضوح والشرط المسبق لأي عودة للمفاوضات الثنائية بينهما. وهذا المطلب عني في حينه، إدراك شارون أنه من المستحيل التحكم بشعب آخر بالقوة، وبدأ يقرأ البعد السكاني والديمغرافي في الصراع، وسار على دربه أيهود أولمرت الذي حاول فك الارتباط مع بعض المناطق ذات الكثافة السكانية في الضفة الغربية[4].
لم تتوانَ الإدارة الأمريكية راعي عملية التسوية عن تأييدها للمطلب الإسرائيلي "الاعتراف بيهودية الدولة" من خلال ضمانات مكتوبة[5]، وتصريحات علنية وضغوطات لرؤساء أمريكيين ومسؤولين كبار في تلك الإدارة، مقابل ممارسة الضغط على الفلسطينيين للقبول بالمطلب الإسرائيلي الذي يرفضه الفلسطينيون حتى اللحظة، وكان جورج بوش الابن أكد على "أن الولايات المتحدة ملتزمة بقوة بأمن إسرائيل كدولة يهودية مفعمة بالحيوية"[6]. ولم يفوّت الرئيس الأمريكي باراك أوباما الفرصة، حيث تبناها هو الآخر وأيد الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وكرّر ذلك أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك) في عام 2008، وكذلك في سبتمبر 2010 في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حين أكّد التزام الولايات المتحدة بالاعتراف بإسرائيل بصفتها دولة يهودية، والذي يفهم منه وكأنها محاولة إلى تدويل هذا المصطلح[7].
ولا نبالغ لو قلنا: إن مسألة تكريس الدولة اليهودية تقدم بشكل سريع خلال السنوات القليلة الماضية، واتخذ إجراءات سياسية وقانونية داخل المؤسسات الإسرائيلية، بحيث أضحى ثابتًا كمفهوم سياسي في السياسة الإسرائيلية، في محاولة منها لإلصاقه بالمفاهيم السياسية الدولية، جنبًا إلى جنب مع فرض وقائع جديدة تعطي إسرائيل مجالًا أوسع للمناورة وكسب الوقت في المستقبل.
ما يلاحظ وسط هذه البيئة "بيئة التفكك أو الانفراط"، هو خروج أصوات عربية رسمية وغير رسمية (صحفيين وأكاديميين ومثقفين)، تشكك في الرواية التاريخية الفلسطينية لحساب الرواية اليهودية التوراتية المختلقة، وتحاول ترويج ذلك داخل الأوساط الشعبية العربية التي لا يمكن إخفاء قبول، بل رعاية العديد من الأنظمة العربية لهذا الترويج والأنشطة المرافقة له.
3. بيئة الانهيار
يمكن أن نطلق عليها أيضًا بيئة الاستسلام، وتولّدت تلك البيئة من خلال التغييرات التي شهدتها المنطقة العربية في أواسط شهر ديسمبر 2010، المتمثلة في الانتفاضات الشعبية التي بدأت شرارتها في تونس، وسرعان ما تفجرَّت في كل من مصر و ليبيا واليمن والبحرين وسوريا، وأدت إلى تغيّرات سياسية واجتماعية واقتصادية نوعية، من حيث سقوط نظم الحكم في بعضها، تحت ضغط المطلب الشعبي، في حين تحولت في بعضها لما يشبه الحرب الأهلية والمواجهة المفتوحة وحروب الوكالة مثال: ليبيا وسوريا واليمن.
ففي حين أن هذه الانتفاضات لم تستطع النجاح في تحقيق الأهداف التي رفعتها (عيش، حرية، عدالة اجتماعية)، ونجاح الثورات المضادة، سواء من خلال تحالف بعض أطرافها مع الولايات المتحدة أو البيروقراطية العسكرية في بلدانها، حيث أعادت تلك الانتفاضات إلى الأذهان مشهد الاستقطاب الحاد الذي شهدته المنطقة إبان مراحل سابقة، آخذين بعين الاعتبار الاختلاف الجوهري بين المرحلتين، من حيث من أيد وعارض ودعم وجيّش ووظف إمكانات وقدرات في تلك الانتفاضات، جعلت العلاقات العربية عُرضة للأزمات والاصطفافات والتوتر المستمر، حيث إن التأثير والتأثر بين الداخل والخارج متبادلان، ويصعب تمييز أيهما أسبق أو أكثر تأثيرًا. فالاستقطاب الإقليمي الحاصل منذ عدة سنوات، ترك بصمته على التفاعلات الداخلية[8]، ليس ذلك فحسب؛ بل زاد من حدة الانقسامات الاجتماعية والسياسية، وعدم قدرة حماية السيادة والاستقرار الداخلي وغزو الفوضى متعددة الأوجه، سواء على صعيد كل دولة على حدة أو على صعيد النظام السياسي العربي مجتمعًا.
تأسيساً على ما سبق، انقسمت وجهات النظر حول تأثير الانتفاضات الشعبية العربية على القضية الفلسطينية، إلى وجهتي نظر؛ الأولى: رأت أنها ستدفع بالقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية إلى الواجهة، والثانية: ذهبت إلى أن القضية الفلسطينية لن تكون أولوية انطلاقًا من الحقوق والأهداف التي يسعى الفلسطينيون لتحقيقها، وذلك للأسباب التالية[9]:
- خلو تلك الانتفاضات من الإشارة إلى أي عدو خارجي، لأنها كانت في صراع مع عدو داخلي ليس من السهل التغلّب عليه، ولهذا لم تكن في وارد البحث عن أعداء إضافيين.
- لم يكن في خطابات هذه الانتفاضات نفسًا قوميًا، يضع القضية الفلسطينية أولوية، حيث كان البديل "خطابًا ثوريًا" جديدًا يستند على مرجعيات قطرية وطنية.
- إن الانتفاضات العربية قامت بشكل عفوي ودون قيادة، ولم يكن لها برنامج سياسي، ولا أحزاب سياسية تقود وتوجه أهدافها، أو تُبرز شعاراتها تجاه قضية فلسطين والقضايا العربية الأخرى ومنها الوحدة العربية.
إن صمت خطاب الانتفاضات العربية عن القضية الفلسطينية؛ بسبب الصراع مع الأنظمة، لم يكن هو السبب الوحيد لغياب هذه القضية عن الأجندة المعلنة لهذه الانتفاضات، بل هناك أسباب تمثلت في الأوضاع التي سادت بعد إسقاط الأنظمة، والتي أهمها: إشكالية الهدم والبناء والانتقال من إرث الأنظمة القديمة إلى الجديد، والصراع الداخلي بين قوى هذه الانتفاضات التي لم يكن بين معظمها مشتركات في القيم والمبادئ والمفاهيم، وتفجُر المكبوتات الاجتماعية من عرقية ومذهبية وجهوية، وفي ظل ظروف كهذه ليس من المتصور أن يستطيع الغارقون في هذا المشهد أن يمدوا أبصارهم خارجه، إلا إذا كانوا باحثين عن عون وليس عن التزامات[10].
في حين يرى البعض، بأن الانتفاضات كانت قد أتاحت فرصة لإنعاش الوحدة العربية، وإحياء ما يسمى بروح "التضامن" العربي، لكن لم يتم استثمار هذه الفرصة بما فيه الكفاية، خاصة مع استمرار النظرة ال قطر ية التي سادت العلاقات العربية – العربية في عهد ما قبل الانتفاضات، كما لوحظ في الممارسات العربية الرسمية والشعبية، قدر من ازدواجية الأحكام والتصرفات عند التعامل مع أحداث الانتفاضات في كل من سوريا واليمن، مقارنة بمنطق التعامل مع الانتفاضة في ليبيا. ومن الملاحظ أيضًا أن قوى التغيير والثورة في الشارع العربي لم تنتبه إلى أهمية مساندة أفكار "التثوير" والتطوير، والمطلوب إدخالها إلى هياكل وأدوات وطرق عمل الجامعة العربية[11].
من الواضح، أن القضية الفلسطينية وإلى أمد ليس قصيرٍ، ستبقى بعيدة عن دائرة اهتمام النظام الرسمي والشعبي العربي بالمعنى الجدي، خاصة وأنها مثلت ومنذ مطلع خمسينيات القرن المنصرم على الأقل القضية المركزية للأمة العربية، وباسمها حكمت نظم وزالت أخرى، وشكلت على مدى عقود طويلة من الزمن محور تفاعل النظام الرسمي العربي في سنوات الحرب والسلم معًا، لكن على ما يبدو أن انشغال البلدان العربية بالوقائع التي أنتجتها الانتفاضات الشعبية وآثارها على أوضاعها الداخلية، سيُبقي القضية الفلسطينية، خارج دائرة اهتمامها، في الوقت الذي لن تخرج من دائرة اهتمامات الولايات المتحدة، التي ستبقى معنية برعايتها الحصرية لأبعاد ومآلات الصراع.
في ضوء بيئة الانهيار أو الاستسلام تلك، جاء إعلان ما يسمى بوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أو ما تعارف عليه إعلاميًا "بصفقة القرن"، متمثلًا بالتمسك بشرط الاعتراف بالدولة اليهودية التي ضمنها قانون "قومية الدولة" المقر من الكنيست الإسرائيلي، إلى جانب الاعتراف فعليًا ب القدس عاصمة لإسرائيل، وإسقاط صفة "لاجئ" عن ملايين اللاجئين الفلسطينيين، ووقف تمويل وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين "الأونروا"، والعمل على تصفيتها، والاعتراف بشرعية المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، وتغييب ما يسمى بحل الدولتين لحساب الرؤية الأمريكية الإسرائيلية. وتتأكد تلك البيئة أكثر عندما تصبح إسرائيل (أي العدو) ملاذًا آمنًا لبعض الدول العربية، أكثر من الدول العربية ذاتها، من خلال التسابق لتطبيع العلاقات معها، وصولًا للتحالف فيما سُمىَّ مواجهة الخطر الإيراني الذي بات أولوية وأهمية على "الأجندة" العربية أكثر من القضية الفلسطينية.
النتيجة الرئيسية التي نصل إليها في ضوء تناول البيئة التي عملت ولا تزال تعمل وسطها جامعة الدول العربية، بأن آثارها السلبية ترتد مباشرة على القضية الفلسطينية، إن لم تكن هي إحدى أكثر المقصودين من تلك البيئة وارتداداتها السلبية؛ مسار وتفاعلات ونتائج، منذ أواخر سبعينيات القرن العشرين على الأقل.
ثانيًا: تفاعلات وتأثيرات البيئة على بنية النظام السياسي العربي
وسط البيئة السابقة كانت تتحرك بنية جامعة الدول العربية التي لم تعد قادرة على الوفاء بالالتزامات التي تعلنها كما القرارات التي تتخذها، بل باتت مرتعًا للتعبير عن مستوى حدة الانحدار في النظام الرسمي العربي، مرورًا بالتفكك، وصولًا للانهيار المتمثل في الوحدة الشكلية للجامعة بمؤتمراتها التي باتت إعلامية لا أكثر، إلا فيما يتعلق بتأكيد استمرار ذات البيئة التي تعمل وسطها، ووفق أجندات لم تعد عربية في المقاصد والأهداف، بالتزامن مع تراجع دور الدول الكبرى (مصر وسوريا والعراق تحديدًا)، لحساب الممالك والإمارات: السعودية والإمارات العربية وقطر ما قبل حصار الأخيرة من أخواتها الخليجيات، أي ما يمكن أن نسميه تراجع دور المدينة لحساب "الصحراء" التي تعني الجهل والتخلف والتبعية، وإذا أردنا التحديد أكثر، سنجد أنه كلما تغيّرت بيئة وبنية النظام الرسمي العربي، كلما تصاعد حدة الخطر على القضية والحقوق العربية، ومنها القضية والحقوق الفلسطينية على نحو أخص.
إن تراجع دور ونفوذ دول القلب في النظام الرسمي العربي مقابل صعود الدور الذي تلعبه بعض الدول الهامشية فيه، لا يعني سوى انكماش الدور الإقليمي للدول العربية الرئيسية مقابل تزايد الدور الإقليمي لدول الجوار الجغرافي، خصوصًا إسرائيل و إيران وتركيا وحتى أثيوبيا[12].
لا يمكن فصل بنية النظام السياسي العربي عن بنية النظام الدولي والتداخل والتفاعل الكبير بينهما، حيث تسعى الدول القوية والفاعلة في النظام الدولي، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة إلى ضبط إيقاع التحولات التي يشهدها بنية النظام السياسي العربي، حيث يفرض هذا النظام الدولي، تبعًا لدرجة القوة التي تتمتع بها دوله المهيمنة والباحثة إلى استمرار الصعود في بنية النظام الدولي، والتحكم به والهيمنة عليه، بما يحافظ على مكانتها المتقدمة، حيث تعمل على تشجيع الحروب الصغيرة والنزاعات الأهلية بين وكلائها المحليين، في الدول القابلة والمرشحة لمثل تلك النزاعات في المنطقة العربية على وجه الخصوص، تبعًا لزيادة حدة التنافس الدولي فيها، واستمرار هذا الوضع بكل تأكيد سيزيد من تعميق أزمة بنية النظام السياسي العربي، والإزاحات التدريجية فيها، بحيث يفقد قدرته وقوته وشرعيته أكثر، مما سيُبقي حالة التوتر والصراع والانقسام، وبالتالي التفكك أكثر بين وحداته وأطرافه الرئيسية؛ قائمة ومستمرة[13].
في الوقت ذاته، لا يمكن أن نحيل التحولات التي شهدتها بنية النظام السياسي العربي في الحقبة الأخيرة إلى الأطماع أو العوامل الخارجية فقط، ولكنها كانت أيضًا نتاج معطيات وعوامل داخلية تتعلق ببنية الأنظمة والنخب الحاكمة؛ ولأنها أنظمة ونخب تتسم إجمالًا بتفشي الفساد والاستبداد، رغم تباين كبير في الدرجة وليس في النوع، فغالبًا ما يكون وقوع أي حدث في دولة عربية ما مؤثِّرًا على النظام العربي ككل، وهذا ما تزكيه تدهور العلاقات البينية؛ فالحرب التي يقودها "تحالف عربي" في اليمن لا تلوح لها نهاية في الأفق، وتنذر بكوارث إنسانية رهيبة، والانقسامات بين دول مجلس التعاون الخليجي تزداد عمقًا وتهدد بانهياره، وليبيا لا تزال أقرب ما تكون إلى "دولة فاشلة" منها إلى دولة على وشك الدخول في مرحلة النقاهة، والإرهاب يضرب بعنف في دول عربية عدة، وسوريا أضحت عنوانًا للصراع الدولي فوق أراضيها وعلى حسابها، ومصر تُحكَم بقبضة من حديد لا تلوح معها انفراجة في الأفق، وفي السعودية نظام يهتز بشدة تحت وقع تغييرات كبرى قد لا يستطيع السيطرة على تفاعلاتها المتعاكسة، الأمر الذي يعرضها لمخاطر كبيرة[14].
في سياق كهذا، تبدو قدرة الدول العربية منفردة أو مجتمعة على معالجة تحدياتها الداخلية والخارجية محدودة، خصوصًا في غياب مؤسسات محلية وإقليمية فاعلة، خاصة جامعة الدول العربية؛ لذا يبدو مستقبل العالم العربي محكومًا على المديين القصير والمتوسط، بالاستمرار في التآكل التدريجي للدور والقدرة في التأثير على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ثالثًا: التحديات الإقليمية والدولية للدولة العربية وأثرها على القضية الفلسطينية
يحيط بالدول العربية ثلاث قوى مركزية، لكل من هذه الدول مشروعها الإقليمي الخاص الساعي إلى التمدد والنفوذ في قلب المنطقة العربية والسيطرة عليها، وإن كان اثنتين منهما إسلاميتان، لكن علاقاتهما في المنطقة العربية عاشت وتعيش مراحل عديدة من التواصل والصراع، وإن غلب عليها الصراع في الوقت الحالي وهما إيران وتركيا. في حين أن الدولة الثالثة؛ إسرائيل، تشكل حالة الصراع الرئيسية في المنطقة، ليس كونها مشروع لاحتلال الجغرافية الفلسطينية، بل لأن أطماعها أكبر وأوسع من ذلك وهي معلنة، وليست مخفية.
الواضح على الصعيد هذا أنه منذ عام 2017، هناك تصعيد في الصراع مع إيران، يتخذ أشكالًا سياسية وعقائدية مذهبية مختلفة، وضبط له مع تركيا باعتبارها ليس الخطر المباشر الآن، في حين أن العلاقة مع إسرائيل تعيش في أفضل حالاتها في ظل تصاعد وتيرة تطبيع العلاقات معها، وخاصة من دول الخليج وفي مقدمتها السعودية، لهذا هناك تحديات إقليمية كبيرة وعميقة لا يمكن أخذها في الحسبان دون أخذ التحديات الداخلية، والتي سيتم تناولها ومآلاتها الممكنة لاحقًا.
1. تحديات الحفاظ على الدولة "الوطنية" القطرية
هناك الكثير من المشكلات والتحديات التي تعاني منها الدولة الوطنية، لعل أبرزها: مشكلة الانتماء والهوية، ومشكلة تحقيق الاندماج السياسي والاجتماعي، ومشكلة شرعية الدولة والسلطة، ومشكلة العجز عن تحقيق التنمية الاقتصادية المستقلة، ومشكلة العجز عن إقرار العدالة الاجتماعية، ومشكلة المأزق الأمني وحماية الاستقلال الوطني، ومشكلة العجز عن توسيع دائرة المشاركة السياسية الشعبية. وبذلك؛ فإن البنى السياسية والهياكل الاقتصادية للدولة يجري اليوم تقويضها وتفكيكها، ومحاولة إعادة تركيبها بما يوائم نزعة قطرية مقيتة، ويجري ذلك بسرعة كبيرة حتى فقدت كل دولة على حدة قدرتها على إثبات ذاتها، والمحافظة على هويتها.
ما سبق، يأتي مع تعدد أنماط تدويل القضايا المحلية ومسمياتها ومستوى تأثيرها (حماية الأقليات، وحقوق الإنسان، والتعددية الحزبية، واقتصاد السوق، والإرهاب الإسلامي) في شكل الدولة السياسي، والنمط القانوني، وفي التفكير الفلسفي للعقل العربي. وبدأنا نلاحظ تبلور شكل فسيفساء في الفكر السياسي العربي ككل، نتيجة لتعدد النماذج السياسية في العالم العربي التي في معظمها تميل للتجزئة[15]. ومن العوامل المساعدة على تراجع بنية الدولة العربية، الضعف المؤسسي للدولة، وفقدانها نفوذها على صعيد السياسة الدولية. بمعنى آخر، عدم التطابق بين الدولة والسلطة، ولا سيما بعد تباطؤ وتآكل متضمنات "مؤتمر باندونغ"، فقد أوجز ذلك حوافز فاعلة باتجاه الاقتصادات الرأسمالية وأطرافها المباشرة نحو قوى السوق، وأدى تدويل الأسواق وعالميتها من الناحية الاقتصادية إلى تواضع دور الدولة الوطنية، أو إعادة توجيه هذا الدور نحو المساهمة في تراكم المال في الاقتصادات المتقدمة[16].
كان أولى الانعكاسات السلبية لتدويل الأسواق قد طالت بتأثيراتها الاقتصادات "الأسواق" الهشة التي منها اقتصادات الدول العربية النامية، مما ضاعف من تراجع مكونات الدولة، وسيادتها على أرضها ومقدراتها وثرواتها وحدودها، وبالتالي انتقال الدولة العربية إلى مرحلة المؤسسية، بحيث بقيت في إطار الدولة الريعية؛ من حيث البعد والتكوين التاريخي.
إن إضعاف سلطة الدولة وتآكل مبدأ السيادة الوطنية، في الدول النامية ومنها العربية على وجه الخصوص، يدفع بالدولة إلى ذوبانها في كيانات أكبر منها (فوق قومية)، وإما إلى تفتيتها إلى كيانات عصبوية أصغر منها (تحت قومية)[17]، وهذا بدوره ما يذكي المتضمنات التفكيكية الاجتماعية والجغرافية، أي على صعيد تماسك التركيبة الاجتماعية الداخلية، وعلى صعيد وحدة أراضي الدولة، وبالتالي يُعظّم من الصراعات الإثنية، مما يساعد على تعميق وتسريع حالة التفكك، ولا سيما أثناء مرحلة التحول إلى حالة الاندماج المستهدفة، مثال حالة العديد من البلدان وفي مقدمتها يوغسلافيا وأفغانستان والعراق[18]، وأيضًا سوريا واليمن وليبيا.
الملفت للانتباه في الفكر السياسي العربي مؤخرًا الذي اتسم في مساره التاريخي إجمالًا بالفكرة القومية الوحدوية، من خلال مواجهته "لسايكس بيكو" التقسيمي والدول التي أنتجها في خريطة العالم العربي، أن هذا الفكر بات مدافعًا عن وجود الدول التي أنتجتها تلك الاتفاقية التقسيمية، في وجه محاولات تفكيك الدولة "الوطنية" والتحديات الكبيرة المنتصبة أمام وحدتها وتماسكها وسيادتها، والمحافظة على ثرواتها ومقدراتها، في الوقت الذي بات الخطر يعصف بهذه الدولة ووجودها أصلًا.
2. إيران
برز الدور الإيراني بشكل كبير وفارق على صعيد العالم العربي منذ اندلاع الانتفاضات العربية، وخاصة في كل من سوريا والبحرين واليمن، ناهيك عن دعمها المستمر والسابق لكل من حزب الله والمقاومة الفلسطينية، حيث إن كل المؤشرات القائمة تدلل على تمدد النفوذ الإيراني، وهذا الأمر يتعلق أولًا بمشروع إيراني إقليمي للتوسع فيما تعتبره مجالها الحيوي، أي العالم العربي، وفي الوقت ذاته، كان نتاج التعاطي الخاطئ من قبل النظام السياسي العربي مع إيران، من خلال تصعيد حالة العداء معها، منذ انتصار الثورة فيها عام 1979، والتي كانت تعبيراته الأوضح الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات، وجدت العراق خلالها كل أشكال الدعم من الدول العربية، والخليجية منها بالذات، حيث اعتبرت حرب بالوكالة في حينه، في الوقت الذي كانت علاقتها مع إيران فترة حكم الشاه "شرطي الولايات المتحدة وحليف إسرائيل في المنطقة"، والذي في عصره جرى احتلال الجزر الإماراتية الثلاث؛ تسير بشكل هادئ.
لقد ازداد تسعير التناقضات مع إيران بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة التي بدأ مع إلغاء الاتفاق النووي الذي وقعته معها إدارة الرئيس باراك أوباما، بالتزامن مع تأجيج الصراع المذهبي السني الشيعي، حيث "راحت إيران تتابع بقلق طوال عام 2017 ما طرأ من تغير على السياسة الخارجية الأمريكية، مدركة أن ترامب سيسعى لتعميق واستغلال التناقضات القائمة بينها وبين العالم العربي، وهي تناقضات ليست وليدة اليوم، وإنما تعود إلى الأيام الأولى لانطلاق الثورة الإيرانية التي شكَّلت منذ اندلاعها في نهاية عام 1978، قطيعة شبه تامة مع النظام الإيراني القديم، وسلَّحت النظام الجديد بآليات وأدوات أكثر فاعلية لمد وتوسيع نفوذه على الصعيدين الإقليمي والدولي. فقد تبنى النظام الإيراني الجديد منذ اللحظة الأولى، توجهات راديكالية مناوئة للسياسات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة"[19]. وعليه، يمكن الذهاب إلى أن كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، لا يريدان لإيران أن تطور أسلحة نووية، انطلاقًا من كون امتلاك إيران لتلك الأسلحة لا يعني سوى إنها تسعى لردع الأعمال الإسرائيلية الأمريكية الهادفة إلى توسيع هيمنتها على المنطقة، وعليه فإن الأسلحة النووية الإيرانية لا تشكل مصدر قلق، إلا من بوابة عدائها الواضح لكل من إسرائيل والولايات المتحدة[20].
إن مجمل مجريات الأحداث، وطبيعة العلاقات السياسية السائدة، تؤكد بأن حدة الصراع مع إيران يأخذ أولوية على أجندة النظام السياسي العربي ممثلًا بجامعة الدول العربية، وهذا ما تأكد في مقررات اجتماعاتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة على الأقل، مع استبعاد إخضاع العلاقة مع إيران لما يمكن أن نسميه قانون التحدي والاستجابة، أي "التصدي" لمشروع إيران للتمدد في المنطقة وعلى حسابها؛ من خلال التواصل في المشتركات السياسية التي تجمع الدول العربية مع إيران، سواء الجغرافية، أو الدينية، أو السياسية التي أبرزها تحدي السطوة والأطماع الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة، لكن بات واضحًا أن المسعى السياسي الذي تسير وفقه مجريات ومحددات العلاقة مع إيران، يضعها "كعدو" رئيسي للدول العربية، على حساب التناقض الرئيسي مع إسرائيل، حيث بات يلوح في الأفق بناء تحالف عربي إسرائيلي ضد إيران، يتأكد بتسارع وتائر التطبيع بين العديد من الدول العربية وإسرائيل، من غير تلك الدول التي تدخل معها في معاهدات "سلام"، ومنها السعودية والإمارات وعُمان والمغرب وغيرها.
3. تركيا
لقد تركت النزعة (العثمانية الجديدة) لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرغبة في لعب تركيا دورًا محوريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وارتبط ذلك بمسعى حكومة أردوغان نحو إعادة السيطرة على المناطق التي كانت خضعت منذ قرون للدولة العثمانية، والسيطرة هنا لا تعني المادية على الأرض فقط، بل تتمثل في الهيمنة الاقتصادية والسياسية من البوابة الدينية، وبالتحالف مع بعض الأنظمة من جهة، وجماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى.
إن العمق الاستراتيجي في موقع تركيا ودورها على الساحة الدولية، اعتمد على مقاربة جيوبوليتيكية ترى أن السياسة الخارجية للدولة هي محصلة لتفاعل ثلاثة أبعاد هي: التاريخ السياسي، والهوية الثقافية، والجغرافيا السياسية، والاستراتيجية للدولة والإقليم المجاور. فرغم الشراكة الاستراتيجية الوثيقة لتركيا مع الغرب باعتبارها ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلنطي بعد جيش الولايات المتحدة، إلا أن السياسة الخارجية التركية غدت تشهد تحولات هيكلية عميقة تتمثل في محاولة جادة من جانب تركيا للتوجه شرقًا باتجاه الدول والشعوب التي تدين بالإسلام في المنطقة العربية وآسيا الوسطى والقوقاز والبلقان"[21]، بمعنى أن تركيا أعادت اكتشاف الشرق الأوسط، بعد أن تجاهلته المؤسسة التركية العلمانية الموالية للغرب لعقود. وخلال مرحلة الحرب الباردة، بل وعقبها كان النشاط التركي في المنطقة محدودًا، إلى أن جرى التحول في تلك السياسة منذ عام 2002، وكانت سوريا في قلب هذا التحوّل؛ إذ ازداد حضورها وأهميتها، وبخاصة بعد عام 2006، ما أعطى دفعة قوية للمشروع التركي على الصعيد الإقليمي.
جاءت الوقائع التي فرضتها الانتفاضات العربية لتفصح عن حقيقة السياسة والدور التركي، وحقيقة استراتيجيتها تجاه العالم العربي ودوله، فلقد تخلت عن سياسة "صفر مشاكل" التي شكلت منطلقًا لتقوية العلاقات التركية مع الأنظمة العربية القائمة، وتجسد ذلك في موقفها وتدخلها العسكري في الأزمة السورية، وصراعها مع إيران، والموقف من تطورات الوضع في مصر بعد الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي هناك، وكذلك تدخلها في العراق، مما يؤكد الأطماع التوسعية التركية في المنطقة العربية وعلى حسابها، من بوابة استثمارها للتناقضات والتحولات التي شهدتها المنطقة لتكون فاعلًا إقليميًا لا يمكن تجاهله، وأن تكون جزءًا من أية ترتيبات مستقبلية في منطقة الشرق الأوسط عمومًا[22].
إن استمرارية الدور الإقليمي التركي وقدرته على التطور تظل مرتهنة بالعوامل الحاكمة له والضغوط التي يواجهها وكيفية معالجته لها، لا سيما في الترويج لهذا الدور الإقليمي المنشود، وعليه فإن هذا الدور يبقى محكومًا بالتطورات الداخلية والخارجية معًا، وفي الوقت ذاته مدى استجابة أو ممانعة النظام الرسمي العربي؛ سواء من خلال جامعة الدول العربية أو خارجها لذلك الدور وأهدافه، حيث أعتقد أن هذا الأمر يتجاوز ذلك في ضوء قدرة تركيا في توظيف التناقضات العربية القائمة في خدمة أهدافها في المنطقة، كما استفادتها من بعض علاقاتها الدولية واستثمارها على حساب الجغرافيا والثروات العربية
4. إسرائيل
سيبقى مفهوم الأمن بالنسبة لإسرائيل هاجسًا دائمًا ومستمرًا وسط بيئة معادية بالمجمل، وسيظل هذا رهن حقائق وتاريخ جغرافيا الصراع، وبمقدار شهية إسرائيل للهيمنة والنفوذ والتوسع؛ اتسعت دائرة التحديات والأخطار التي تستشعرها. فبرغم الإنجازات التي حققتها في مجال احتلال الأراضي الفلسطينية وبعض العربية وتوسع رقعتها، وفى مجال القدرات العسكرية التي تملكها، خاصة في المجال النووي وقوة الردع التي تتحلى بها وقوة جيشها، إلا أنها لم تستطع توفير أمنه المرجو. فمهما غلب الحديث فى الوقت الراهن عن السلام بين العرب وإسرائيل أو تسارع خطى التطبيع، أو التحالف حتى، سيبقى الأمن كما الحرب هاجسًا لإسرائيل. وعليه، يمكن الاستنتاج بأن الحيازة الإسرائيلية لمزيد من القوة العسكرية تغزى إلى الاندفاع نحو إيجاد بيئة أكثر ملائمة لها فى المنطقة. الشيء الرئيسي هنا هو أن الأمن الإسرائيلي غير خاضع لتقديم تنازلات فى الإقليم ذات الأهمية الاستراتيجية لها، فالتفكير الأمني الإسرائيلي يعمل باستمرار على تعزيز قدراته الدفاعية من الأسلحة التقليدية إلى أسلحة الدمار الشامل التي ستكون بكل تأكيد على حساب المنطقة ومرتكزات وحدتها[23].
إن الخطط التي تنفذ الآن مخصصة لإبقاء إسرائيل مسيطرة على معظم الأراضي الباهظة الثمن في الضفة الغربية، وزج الفلسطينيين في معازل غير قابلة للحياة، مفصولة جميعًا عن القدس التي غدت عاصمة موحدة لإسرائيل بقرار الإدارة الأمريكية الحالية، إلى جانب جدار الفصل العنصري، واستمرار سرقة المياه الجوفية الفلسطينية، في حين إبقاء قطاع غزة مفصولًا عن الضفة الغربية، وخاضعًا للحصار والعدوان المستمر بما يجعل إسرائيل في وضع أفضل في المستقبل القريب والمتوسط على الأقل. وعليه، فإن الخطر الإسرائيلي وإن كان هناك محاولات للتعاطي معه من بوابة المساومات السياسية، أو المخاطر الإقليمية، أو الخضوع للاستراتيجية الأمريكية، سيظل هو الخطر الأساسي الذي يتهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.
5. العالم العربي ومخاطر مشروع الشرق الأوسط الجديد
إن الاستراتيجية الأمريكية في العالم العربي تقوم بالأساس، على تحقيق مصلحة الولايات المتحدة وحلفائها دون النظر؛ إن كانت تلك السياسات سوف تضر دول المنطقة أم لا، فكان التدخل الأمريكي في العراق عام 2003 من أبرز الأحداث في المنطقة العربية، وأوضح مدى رغبة الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها في المنطقة، حتى لو يقتضي الأمر استخدام الأداة العسكرية، وهو بالفعل ما حصل ويحصل.
فمنذ أواسط تسعينيات القرن المنصرم، انبنت الاستراتيجية الأمريكية على مشروع الشرق الأوسط الكبير (الجديد)، والذي يستهدف الهيمنة بالكامل على المنطقة العربية، وإعادة النظر في اتفاقية سايكس – بيكو، وفي الحدود التي رسمتها، ولا شك أن الولايات المتحدة استطاعت تحقيق بعض النجاحات في مشروعها؛ من خلال نشر الفوضي والاقتتال الداخلي والصراعات المذهبية والطائفية، وصولًا إلى تقسيم بعض الدول العربية ( السودان )، أو توفير البيئة الملائمة لذلك (العراق، ليبيا، اليمن، سوريا)، وعززت كل ذلك؛ من خلال نشر قواعدها العسكرية على امتداد منطقة الخليج والقرن الأفريقي.
فلقد عملت الولايات المتحدة على أن تبقى دينامية استراتيجيتها تسير بخطى واثقة بنجاحها، لهذا عملت إدارة ترامب إلى إبقاء علاقات الصداقة والتحالف مع بعض الأنظمة العربية خاصة دول الخليج، أي الدول العربية الغنية، لتسهيل مهمة هذه الاستراتيجية، وتحمل التكلفة المالية المتعلقة بقضايا المنطقة، خاصة وباعترافات البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة على مدى ثمانية عشر عامًا أنفقت 7 تريليون دولار في الشرق الأوسط، حيث حان وقت أن تدفع دوله مقابل أمنها[24].
ففي الوقت الذي تدعي الولايات المتحدة في استراتيجيتها، أن المقصود هو أمن المنطقة ككل، تعمل بكل جهدها لضمان أمن واستقرار إسرائيل، إذا ما اعتبرناها شرطيّها أو حليفها الاستراتيجي والموثوق في المنطقة.
رابعًا: مستقبل القضية الفلسطينية
في ظل البيئة والبنية التي تعمل وسطها جامعة الدول العربية، وفي ظل غياب حركة التحرر العربية التي شكلت رافدًا لحركة التحرر الفلسطينية، لنا أن نتخيل شكل المستقبل الذي ينتظر القضية الفلسطينية، خاصة وأن الحديث عن المستقبل ليس خبط عشواء أو ضرب بالمندل، بل هو تأسيس في الحاضر والذي سيكون المستقبل على شاكلته. فليس من باب التشاؤم، لكن في ظل تصاعد اليمين القومي والديني الإسرائيلي المتحالف مع اليمين الشعبوي الأمريكي ممثلًا بإدارة ترامب، ووصول عملية التسوية السياسية إلى نهاياتها بعد أن قررت هذه الإدارة تحديد إطار حل القضية الفلسطينية؛ من خلال فرض وقائع عملية على الأرض تراعي الرؤية الإسرائيلية تمامًا، ولا تعطي بالًا للشعب الفلسطيني وحقوقه، فضلًا عن مرجعياته التمثيلية سواء كانت منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية، أي أن المشروع الذي تسير وفقه الإدارة الأمريكية الحالية ليس مقطوع عن سياقاته التاريخية، وخاصة ما وفرته له اتفاقيات أوسلو من أرضية، للوصول إلى خطر التصفية الجدي الذي يتهدد القضية الفلسطينية، بعد أن تهيأت بيئة النظام الرسمي العربي له.
* بحث قدم في مؤتمر جامعة الإسراء بغزة، والمنعقد تحت عنوان: جامعة الدول العربية والقضية الفلسطينية، وذلك يومي الخامس والسادس من فبراير/ شباط (2019).
[1]. ساسين عساف: الوحدة العربية في مواجهة المشروع الصهيوني، مجلة المستقبل العربي، العدد 372، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، شباط/فبراير 2010.
[2]. محمد حسنين هيكل: الإمبراطورية الأمريكية والإغارة على العراق، القاهرة، دار الشروق، ط.9، 2009.
[3]. عبد الوهاب المسيري: وعد بوش الجديد، صحيفة الاتحاد، 18 ديسمبر 2004:
https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/8731
[4]. مسعود اغبارية: الانتخابات الإسرائيلية العامة: آذار 2006، مجلة قضايا إسرائيلية، العدد 22، رام الله، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، 2006.
[5]. في نيسان 2004م سلَّم الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن نظيره الإسرائيلي أرئيل شارون "رسالة ضمانات" أكد فيها حرص أمريكا على أمن إسرائيل والاعتراف بها دولة يهودية.
[6]. عزمي بشارة: أن تكون عربيًا في أيامنا، ط.1، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2009.
[7]. محمود جميل الجندي وخالد شنيكات: إعلان يهودية الدولة وتداعيات المصطلح، مجلة المستقبل العربي، العدد 428، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 2014.
[8]. سامح راشد: هل الانقسام الذي تشهده بعض المجتمعات العربية يعكس استقطابًا سياسيًا أم دينيًا مدنيًا؟، مجلة شؤون عربية، العدد 153، القاهرة، جامعة الدول العربية، 2013.
[9]. عماد البشتاوي: الربيع العربي وفلسطين، مجلة شؤون فلسطينية، العدد 255، رام الله، مركز الأبحاث، منظمة التحرير الفلسطينية، 2014
[10]. صلاح الدين الجورشي: الثورات العربية.. مشروع ناقص من داخله، مجلة شؤون عربية، العدد 156، القاهرة، جامعة الدول العربية، 2013.
[11]. عبد العزيز مهلية: مرتكزات واتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية إزاء المنطقة المغاربية بعد أحداث 11 سبتمبر 2010: دراسة حالة الجزائر، مجلة اتجاهات نظرية، العدد الخامس، ألمانيا، المركز الديمقراطي العربي، أغسطس، 2018.
[12]. حسن نافعة: تحولات عميقة في بنية النظام العربي، موقع عرب 48:
https://www.arab48.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-
[13]. نيروز غانم ساتيك وأحمد قاسم حسين: التغيرات في بنية النظام الدولي وانعكاساتها على الثورات العربية، مجلة سياسات عربية، العدد 3، تموز/يوليو 2013.
[14]. حسن نافعة: التحولات السياسية في المشرق العربي في 2018، موقع الجزيرة للدراسات، 11 فبراير 2018:
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/02/2018-
[15]. ميشيل شيحة: إشكالية الدولة القطرية العربية المعاصرة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 22، العدد الأول، 2006.
[16]. أحمد عوض الرحمون وآخرون: الدولة الوطنية المعاصرة أزمة الاندماج والتفكيك، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط.1، 2008.
[17]. ميشيل شيحة: إشكالية الدولة القطرية العربية المعاصرة، مرجع سابق.
[18]. أحمد عوض الرحمون وآخرون: الدولة الوطنية المعاصرة، مرجع سابق.
[19]. حسن نافعة: التحولات السياسية في المشرق العربي، مرجع سابق.
[20]. سليم كاطع علي: البعد الإيراني في السياسة الخارجية الأمريكية، مجلة دراسات دولية، العدد 60، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، جامعة بغداد، 2015.
[21]. خالد عبد العظيم: العثمانية الجديدة: تحولات السياسة الخارجية التركية في الشرق الأوسط، مجلة السياسة الدولية، العدد 187 (عدد خاص)، القاهرة، مؤسسة الأهرام، يناير 2012.
[22]. مي سامي المرشد: الدور الإقليمي لتركيا تجاه الشرق الأوسط (2002-2016)، برلين، إصدارات المركز الديمقراطي العربي، 2018.
[23]. أحمد عواد الفاعوري: التحولات الإقليمية العربية وأثرها على نظرية الأمن الإسرائيلي في الفترة (2006-2012)، رسالة ماجستير منشورة، جامعة الشرق الأوسط، 2011.
[24]. Eliot A. Cohen, The Big Stick: The Limits of Soft Power and the Necessity of Military Force, New York: Basic Books, 2018.