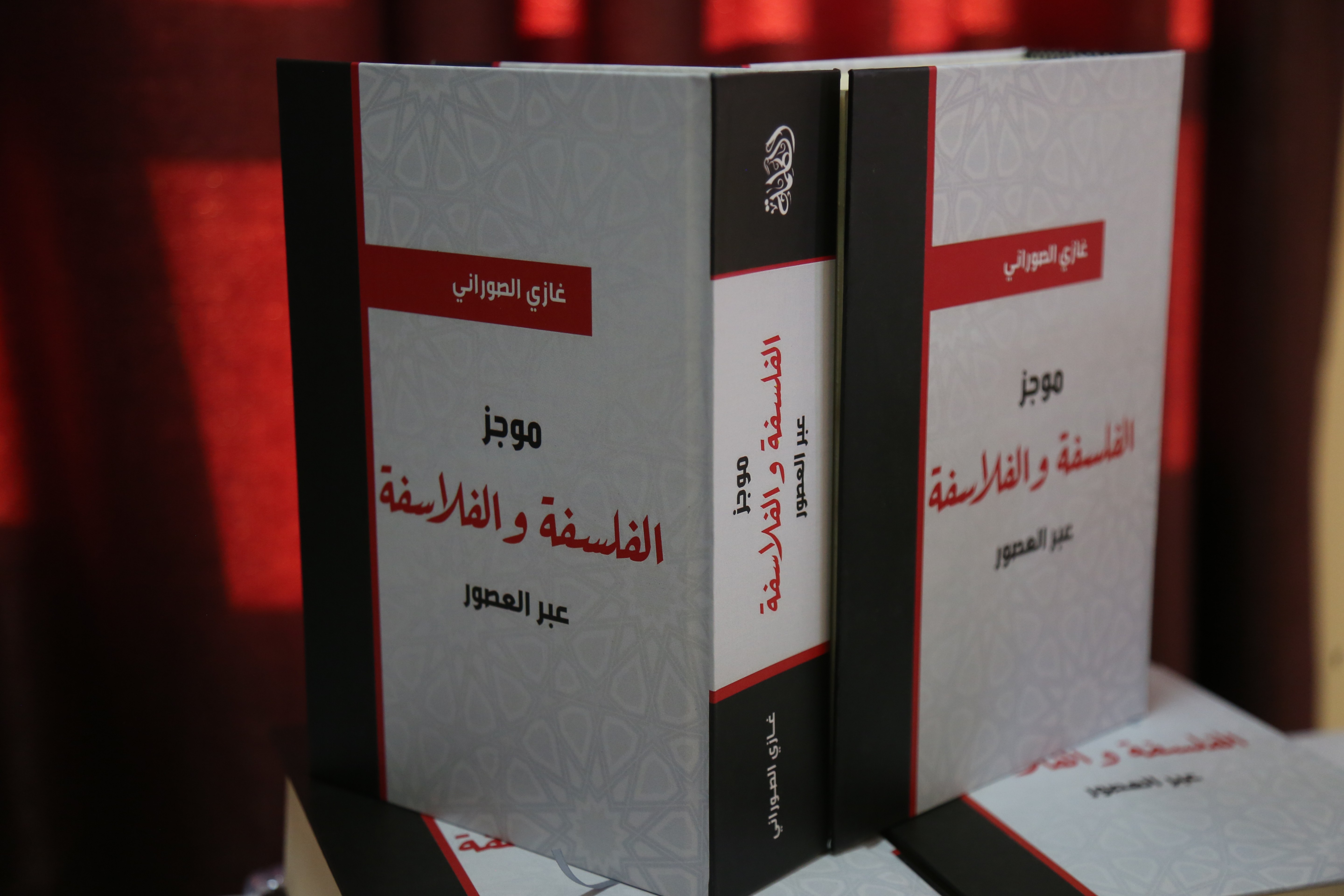(تنفرد بوابة الهدف، بنشر كتاب المفكر غازي الصوراني، المعنون: موجز الفلسفة والفلاسفة عبر العصور، الصادر عن دار الكلمة للنشر والتوزيع، في يونيو/ حزيران 2020، على حلقات متتابعة.. قراءة مثمرة ومفيدة نتمناها لكم).
الباب الرابع
الفصل الحادي عشر
الفلسفة في القرن العشرين
أبرز فلاسفة القرن العشرين
برتراند راسل (1872 – 1970):
فيلسوف وعالِم منطق ورياضي ومؤرخ وناقد اجتماعي بريطاني، وُلد في ويلز، وكان أول ما نَشَرَ من أعمال كتاب "الديمقراطية الاجتماعية"، ثم نشر عام 1903 أولى كتبه المهمة عن المنطق الرياضي "مبادئ الرياضيات" مبيناً فيه كيفية استنباط الرياضيات من مجموعة صغيرة من المبادئ ومسهماً في قضية الفكر المنطقي.
أصبح راسل عام 1910 محاضراً في جامعة كامبردج، حيث قابل طالب الهندسة النمساوي لودفيج فيتغنشتاين والذي اعتبره، عبقرياً، وخليفاً له، يستطيع استكمال عمله حول المنطق.
وبعد الحرب العالمية الأولى، اعتنق راسل الشيوعية، لكنه سرعان ما تراجع عنها بسبب نقده للتجربة السوفيتية، وأكد التزامه بالاشتراكية في خدمة الفئات الفقيرة، وتعرض بسبب مواقفه وافكاره للاعتقال والاضطهاد من القوى الارستقراطية والبورجوازية في انجلترا، لكنه أصر على مواقفه وافكاره رافضاً انتماؤه للطبقة الارستقراطية، مؤكداً، أن على كل مفكر عقلاني عدم التفريط فيما يعتقد بجديته ومصداقيته، وان الحياة –كما يقول- تتمثل في صفات ثلاث: هي الحب والمعرفة والشفقه، وهي صفات يجب أن يتحلى بها كل عاقل ليشار اليه بالفعل على أنه إنسان، ولذلك إعتُبِرَ راسل مفكراً موسوعياً تميز بوعيه وآراه التقدمية الديمقراطية والإنسانية، لذلك استحق بالفعل لقب رسول العلم والسلام.
في وصفه لحياته وممارساته ومواقفه، يقول راسل في رسالته التي عنوانها "ما الذي عشت لأجله"؟: "ثلاثة مشاعر بسيطة، لكنها غامرة على نحو قوي شَكَّلَتْ وتحكمت في حياتي: التوق إلى الحب، السعي إلى المعرفة، وشفقة لا تُحتَمل لمعاناة البشر، هذه المشاعر مثل العواطف الكبيرة والعظيمة، عصفت بي وبعثرتني ورمتني في مسار متقلب في خضم من المعاناة، وصولاً إلى الحافة الأخيره لليأس، فَسَعَيتُ للحب أولاً، لأنه يبعث على النشوة العظيمة، لدرجة انني أرغب احياناً بالتضحية ببقية حياتي من أجل ساعات قليلة منها، ثم بحثت عنه ثانياً، لأنه يخفف ويهون الوحدة الرهيبة التي تجعل الوعي المرتجف للمرء، ينظر من أعلى حافة في العالم إلى تلك الهوة البارده المبهمة الخالية من الحياة إلى العدم، وبشغفٍ مساوٍ سعيت إلى المعرفة، وتمنيت أن أفهم قلوب البشر، فالحب والمعرفة بقدر ما كانا ممكنين رَفَعَاني عالياً نحو السماء، لكن الشفقه دائماً ما عادت بي إلى الأرض، ليعود ويتردد في قلبي صدى بكاء المتألمين أطفال المجاعات، ضحايا تعذيب الطغاة، كبار السن العاجزين، الذين يعتبرهم أبنائهم عبئاً عليهم، وكل هذا العالم الملئ بالوحدة والفقر والحروب والألم الذي يسخر مما يجب أن تكون عليه حياة الانسان، أنا أتوق إلى رفع هذا الشر، لكنني لم أقدر فأنا أيضاً أعاني ، هذه كانت حياتي، ولست نادماً عليها ووجدتها جديرة "بأن تعاش وبكل سعادة ورضا سأعيشها مجدداً إذا اتيحت لي فرصة أخرى"([1]).
في أغسطس 1920، سافر راسل إلى روسيا، ضمن وفد رسمي بريطاني، لبحث آثار الثورة الروسية، والتقى لينين ">فلاديمير لينين وكان له معه حديث ساعة، لكن راسل في سيرته الذاتية، يذكر أنه وَجَدَ لينين مخيباً للآمال ملتمساً فيه "قسوة شقية" ومقارناً إياه بـ"بروفسور متشبث بآراءه".
قضى راسل خمسينيات وستينيات القرن العشرين في خدمة قضايا سياسية متنوعة وتحديداً نزع الأسلحة النووية ومعارضة الحرب في فيتنام، وينسب اليه الفضل عموماً كأحد مؤسسي الفلسفة التحليلية، حيث كان من أشد المعجبين بغوتفريد لايبنتز (1646-1716) .
قاد راسل الثورة البريطانية "ضد المثالية" في أوائل القرن العشرين، ويعتبر أحد مؤسسي الفلسفة التحليلية إلى جانب سلفه "كوتلب فريج" وتلميذه "لودفيج فيتغنشتاين"، كما يعتبر من أهم علماء المنطق في القرن العشرين.
كان راسل ناشطاً بارزاً في مناهضة الحرب، وأحد أنصار التجارة الحرة ومناهضة الإمبريالية، سُجِنَ بسبب نشاطه الداعي للسلام خلال الحرب العالمية الأولى، قام بحملات ضد أدولف هتلر وانتقد الشمولية الستالينية وهاجم تورط الولايات المتحدة في حرب فيتنام، حاز عام 1950 على جائزة نوبل للأدب "تقديراً لكتاباته المتنوعة والمهمة والتي يدافع فيها عن المُثُلْ الإنسانية وحرية الفكر."
المنطقي:
" عندما كان "برتراند راسل" يحاضر في عام 1914 في جامعة كولومبيا في موضوع فلسفة المعرفة والمنطق، كان يبدو نحيلاً شاحباً كموضوعه الذي يحاضر فيه، وعندما اشتعلت الحرب العالمية الأولى، تألم هذا الفيلسوف المحب للسلام والرقيق المزاج أشد الالم، لدى رؤية أعظم القارات مدنية تهبط إلى حالة من البربرية الهمجية، وعندما يراه الإنسان ثانية بعد عشر سنوات، لا يسعه إلا أن يشعر بالسعادة، عندما يجده على الرغم من أنه كان في الثانية والخمسين من عمره، قد انقلب قوياً طروباً يفيض بحيوية ثائرة، على الرغم من ان السنوات الأخيرة قد حطمت آماله، وأبعدت عنه اصدقاءه، وقطعت جميع خيوط حياته الارستقراطية التي كان يجد فيها مأوى يحميه من نوائب الزمن، لأنه سليل أسرة "رسل" وهي من أقدم الأسر في انجلترا، وأعرقها حسباً وأبعدها صيتاً، بل من أشهر الأُسَر في العالم"([2]).
لقد طالب راسل بجلاء الفكر ووضوحه، وقد دفعت به هذه النزعة إلى دراسة الرياضيات، لما رأى من دقة في هذا العلم الهادي فيقول: "إننا إذا استعرضنا الرياضيات استعراضاً صحيحاً لما وجدنا فيها الحقيقة فحسب، بل وجدنا فيها جمالاً سامياً، جمال البرود والقسوة والصرامة، كالجمال الموجود في صناعة نحت التماثيل، الذي لا يتجه إلى جوانب الضعف في طبيعتنا، ولا ينصب لنا من الحبائل ما تنصبه لنا الموسيقى أو التصوير".
" إن ما يستهوي "رسل" في الرياضيات ويجذبه نحوها هو ما تتصف به من موضوعية صارمة لا دخل للشخصية فيها، هنا وهنا فقط تكمن الحقيقة الخالدة والمعرفة المطلقة، لذا ينبغي ان يكون هدف الفلسفة بلوغ ما في الرياضيات من كمال، بأن تقيد نفسها باقوال لها من الصحة والضبط ما للرياضيات، ولها من الحق الثابت قبل كل أنواع التجربة، إذ ينبغي أن تكون فروض الفلسفة قضايا مسلماً بها، هذا هو ما يريده "رسل"، ومن أول مؤلفاته كتابه "التصوف والمنطق" الذي مجد فيه الطريقة العلمية وهاجم التصوف.
من المثير للدهشة –يقول ديورانت- "ان يهبط "رسل" إلى سطح هذه الأرض بعد أن حَلَّقَ بعيداً في سماء الرياضيات والمنطق، وكتب عدة مجلدات فيها، وأخذ يبحث بعاطفة قوية مواضيع الحرب والحكومة والاشتراكية والثورة، من غير ان يلجأ إلى استخدام منطقه الرياضي، وقد أدت بداية راسل في الرياضيات إلى مصير محتوم من اللاادرية والشك فقد وجد في المسيحية كثيراً من الاشياء التي لا تتفق مع ما في الرياضيات من قواعد ونظريات ثابتة فتخلى عنها باستثناء قانونها الاخلاقي، وأخذ يتحدث في ازدراء واحتقار عن مدنية تضطهد أناساً ينكرون المسيحية، ولم يستطع ان يجد الهاً في مثل هذا العالم المتناقض الذي لا يمكن أن يكون إلا من صنع شيطان ساخر هازل"([3]).
المُصلح:
حينما اشتعلت الحرب العالمية الأولى، انفجر برتراند راسل الذي بقي مدفوناً مدة طويلة تحت اثقال المنطق والرياضيات وفلسفة المعرفة، واضطرم كاللهب المشتعل، وأَدهش العالم بشجاعته الفائقة ومحبته، وعطفه على الإنسانية، فقد كان برتراند راسل –كما يقول ديورانت- "مجموعة حساسة من المشاعر على الرغم من محاولته أن يكون عقلاً مجرداً، وبدت له مصالح الامبراطورية البريطانية لا تستحق حياة الشباب الذين شهدهم يسيرون في زهو إلى ميدان القتال ليقتلوا ويموتوا، وراح يعمل للوصول إلى أسباب هذه المجازر البشرية، واعتَقَدَ أنه وجد في الاشتراكية من التحليلات الاقتصادية والسياسية ما يكشف عن أسباب المرض والعلاج، واعتَقَدَ أيضاً، ان الداء هو الملكية الخاصة والدواء هو الشيوعية، ذلك إن الكراهية والحروب ترجع إلى مدى كبير إلى الآراء الثابتة والعقائد الجامدة، وان حرية الفكر والقول بمثابة الجرعة المطهرة التي تطهر العقل الحديث من الخرافات والأوهام والأمراض العصبية، لاننا لم نبلغ من التعليم درجة كبيرة كما نظن"([4]).
إننا نظن في التعليم –يقول راسل- "وسيلة لتحويل مقدار معين من معرفة مُسَلَّم بصحتها إلى اذهان التلاميذ، في حين إنها يجب أن تكون تطوراً وتقدماً لعادة العقل العلمية، وبالتالي فإن التوسع في استخدام العلم، والطريقة العلمية في التعليم في المدارس، سيقدم لنا مقياساً لذلك الضمير العقلي الذي لا يؤمن إلا بما في يديه من شواهد وأدلة، ويكون دائماً على استعداد لأن يقبل إمكانية الخطأ في الرأي، فالتعليم – حسب راسل- قادر على تشكيل الآراء والميل بها إلى تقدير الفن أكثر من تقدير المال والثروة، وترقية ملكات الإبداع والخلق في الناشئة، وتقليل دوافع رغبة الامتلاك والثروة في النفوس، هذا هو مبدأ النمو الذي يؤدي إلى قاعدتين عظيمتين من الاخلاق الجديدة الأولى، مبدأ الاحترام "وهو ترقية نشاط الافراد والجماعات كلما امكن إلى ذلك سبيلاً" والثانية مبدأ التسامح وهو "ألا يكون نمو الفرد أو الجماعة على حساب فرد آخر أو جماعة أخرى ما أمكن إلى ذلك سبيلاً"، ويضيف برتراند راسل قائلاً "لن يقف امام الإنسان شيء لا يستطيع فعله أو القيام به لو تطورت برامج التعليم في مدارسنا وجامعاتنا، وأُديرت إدارةً حسنة امينة، وَوُجِّهتْ توجيهاًعاقلاً حكيماً إلى إعادة بناء الاخلاق الانسانية، هذا هو السبيل للتخلص مما ينتاب العالم من جشعٍ إقتصادي ووحشية دولية، ان مدارسنا مفتاح المدينة الفاضلة"([5]).
أخيراً، يقول ديورانت: "لقد اسرف برتراند راسل في التفاؤل؛ مع اننا نؤثر الخطأ في جانب الأمل على الخطأ في تفضيل اليأس، لقد صب راسل في فلسفته الآجتماعية تصوفاً، وغموضاً وعاطفة تجنبها في آرائه الدينية والميتافيزيقية، فهو لم يطبق على نظرياته الاقتصادية والسياسية نفس التدقيق وامعان النظر في الفروض ونفس الشك في البديهيات التي جعلته يرضى عن الرياضيات والمنطق، فقد ساقه حبه للكمال "اكثر من الحياة" إلى صور رائعة فاخرة تصلح لأن تكون قصائد شعرية للتخفيف من اعباء العالم أكثر من كونها محاولات عملية للاقتراب من مشاكل الحياة، يا له من انسان محبوب قادر على البحث في أعمق الميتافيزيقا وأدق الرياضيات في بساطة الحديث ووضوح الأسلوب، فقد عكف على دراسة مواضيع ينضب فيها منبع الشعور، ومع ذلك فقد كان يطفح بحرارة العطف والشفقة والرأفة نحو الانسانية، انه ليس مجاملاً أو متزلفاً بل عالما ولطيفاً، وافضل مسيحية من كثير ممن يتشدقون بهذه الكلمة، ويسعدنا انه عاش طوال حياته قوياً وصادقاً مخلصاً، حمل شعلة الحياة التي أضاءت فيه نوراً"([6]).
موقف راسل من الدولة الصهيونية والقضية الفلسطينية:
في مقالة بعنوان "عن إسرائيل والقصف" كُتبت عام 1970، قال راسل: "مأساة شعب فلسطين هي إعطاء بلادهم بقوة خارجية لشعب آخر من أجل بناء دولة جديدة. إلى أي حد سيتحمل العالم رؤية هذه المشاهد من القسوة الوحشية؟ إنه واضحٌ بما فيه الكفاية أن اللاجئين لهم كل الحق في أرض وطنهم من حيث تم استياقهم، وإنكار هذا الحق هو جوهر الصراع الدائم، ويضيف راسل قائلاً([7]):
"إن التوصل لتسوية دائمة عادلة للاجئين في وطنهم عنصر أساسي لأي تسوية حقيقية في الشرق الأوسط، فقد قيل لنا مراراً وتكراراً "أنه يجب التعاطف مع إسرائيل وذلك بسبب معاناة اليهود في أوروبا على أيادي النازيين، لكن ماتفعله إسرائيل اليوم لا يمكن التغاضي عنه، ولإثارة أهوال الماضي لتبرير أهوال الحاضر فهو نفاق عظيم، وليس فقط تحكم إسرائيل على عدداً كبيرا من اللاجئيين بالبؤس، وليس فقط العديد من العرب تحت ظل الاحتلال يحكم عليهم بالحكم العسكري؛ ولكن تدين إسرائيل الأمم العربية التي خرجت حديثاً من الحكم الاستعماري لتفقرهم عن طريق المتطلبات العسكرية عوضاً عن التنمية الوطنية".
لذلك – كما يضيف راسل- "تتطلب العدالة خطوة أولى تجاه تسوية وبالتأكيد هي تكون بالتراجع الإسرائيلي من كل الأراضي المحتلة في يونيو عام 1967.
في 31 يناير 1970، أصدر راسل بياناً يدين العدوان الإسرائيلي في الشرق الأوسط داعياً إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967. وكان هذا البيان أخر موقف سياسي لراسل، وكان قد أُلقي في المؤتمر الدولي للبرلمانيين في القاهرة يوم 3 فبراير 1970 مع ملاحظة أشارت إلى أن راسل قد توفي في اليوم السابق على المؤتمر"([8]).
توفي راسل إثر إنفلونزا حادة في 2 فبراير 1970 في منزله في ويلز، أحرقت رفاته في كلوين باي في 5 فبراير 1970. وحسب وصيته، لم تقم احتفالية دينية ونثر رماده على الجبال الويلزية لاحقاً ذاك العام.
إميل برهييه (1876 – 1953 م):
فيلسوف ومؤرخ فرنسي للفلسفة، أستاذ في السوربون من 1919 إلى 1946، ورئيس تحرير على مدى سنين عديدة للمجلة الفلسفية، وعضو في أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية، وكذلك في الأكاديمية البريطانية، وأكاديمية آل لنشي، وأكاديمية بلجيكا.
يقول المفكر الراحل جورج طرابيشي "قليلون هم الرجال الذين مارسوا، بفضل وضوح ذهنهم وموضوعية تعليمهم الغنية، ما مارسه إميل برهييه من تأثير عميق، وعلى الرغم من أنه لم يعرض فكره الشخصي إلا من خلال فكر الفلاسفة الذين ربطه وإياه حسه المشترك باللوغوس الموحد للفكر الفاعل والمنظم حيثما وجد، أُعجِبَ بأفلوطين وشيلنج.
كان اميل برهييه، أقرب إلى العقلانية الصوفية منه إلى العقلانية المجردة، فلم يتراَء له أنه مستطيع أن ياخذ بتصور التأليه الديني للوجود، وكان يطيب له أن يطبق قول أفلوطين: "أحاول أن أرد الإلهي الذي فيَّ إلى الإلهي الذي في الكون"، وقد انتهى في أواخر حياته إلى رؤية "الوجود الكلي الذي يجاوز تمايز المادة والروح"، وبقي حتى نهاية حياته يرتاب في الأشكال المَرَضية من الوجودية، ويعارض التشبيب بالعاطفة وعبادة اللامعقول بعلوم الفكر.
أما عمله كمؤرخ فعظيم الشأن عبر مؤلفاته: تاريخ الفلسفة في سبعة مجلدات (1926 – 1932)، وترجمة وبطعة مبنية على الأصول لتاسوعات أفلوطين، وأطروحة دكتوراه: الأفكار الفلسفية والدينية لفيلون الاسكندري (1901)، وشلينغ (1912)، وفلسفة أفلوطين (1928)، وتاريخ الفلسفة الألمانية (1921)" ([9]).
ازفلد شبنجلر([10]) (1880 – 1936):
" مؤرخ وفيلسوف ألماني شملت اهتماماته أيضاً الرياضيات والعلم والفن، يُعْرَفْ بكتابه "إنحلال الغرب"، الذي تُرجِمَ إلى اللغة العربية بعنوان "تدهور الحضارة الغربية" ويتناول: نظرية "شبنجلر" عن سقوط وازدهار الحضارات وأن ذلك يتم بشكل دوري، ويغطي كل تاريخ العالم،كما قدم نظرية جديدة جعل فيها عمر الحضارات محدوداً وأن مصيرها إلى الأفول"([11]).
"في نظرة مغايرة لما هو متعارف من أن الشعوب والأمم تجمعها روابط مختلفة ومعينة منها الدم واللغة، تشكل معنى الحضارة، نجد شبنجلر يعتقد بأن الشعوب ليست وحدات لغوية أو سياسية أو ذات دم نقي، إنما هي وحدات روحية، لأن الحضارة هي التي تعطي الروح للشعوب وهكذا عَرَّفَ الشعوب، وفي هذا المعنى دلالة كبيرة على معنى التضامن والأبعاد الجمعية للانتماء الهوياتي، وعليه أمكن أن يقسمها على"([12]):
- شعوب سابقة على الحضارة وهي ما يسميها بالشعوب الأولية وهي جماعات فرارة غير متجانسة تتكون وتنحل بلا قاعدة معروفة.
- شعوب متأخرة على الحضارة: وهي ما يسميها بشعوب الفلاحين.
- والشعوب المتحضرة: وهي تلك التي تنشأ حين تستيقظ روح الحضارة فالحضارة الغربية –كما يقول- استيقظت في القرن العاشر.
كانت نظرة المؤرخين ترى أن الشعوب هي التي تُنشِئ الحضارات، وأنها وحدات خالقة للتاريخ، إلى أن جاء شبنجلر فَقَلَبَ هذه النظرة رأساً على عقب، فقال: "يجب أن نؤكد بكل ما أوتينا من قوة أن الحضارات العليا شيء أصيل كل الأصالة بينما الشعوب على العكس من ذلك ليست المنتجة وإنما هي إنتاجها". أي إن الشعوب هي نتيجة تحقق التحضر ونشوء الحضارة.
الحضارة عند شبنجلر "هي التي تصنع الأمة وليس الشعب، كما يرى أن التاريخ يتكون من كائنات عضوية هي الحضارات، وكل حضارة منها تشبه الكائن العضوي تمام الشبه، فتاريخ كل حضارة هو كتاريخ الإنسان أو الحيوان أو الشجرة سواء بسواء، ولما كانت الحضارة كالكائن الحي العضوي، فإنها تمر بنفس الأدوار التي يم بها هذا الكائن الحي إبان تطوره فلكل حضارة طفولتها وشبابها ونضجها وشيخوختها، وبذلك فهو يقارن بين مراحل حياة الروح للشعوب المتحضرة وبين حياة الإنسان الفرد، وما يمر به من أطوار وأدوار مختلفة تنتهي به إلى الشيخوخة، وهو بذلك يسير نحو حتمية تاريخية لانهيار الحضارات"([13]).
"أصدر شبينغلر كتاب "البروسية والاشتراكية" سنة 1920، وفيه عَرَضَ صورة عضوية من الاشتراكية والسلطوية.
شهدت فترة الحرب العالمية الأولى وفترة ما بين الحربين العالميتين خصوبة في إنتاج شبينغلر الفكري، وشهدت تأييده لسيطرة ألمانيا في أوروبا، وقد اتخذ الاشتراكيون القوميون من شبينغلر مُنَظِّراً لأفكارهم، غير أنهم ما لبثوا أن نبذوه سنة 1933 عندما أبدى تشاؤمه بشأن مستقبل ألمانيا وأوروبا، ورفضه تأييد الأفكار النازية المتعلقة بالتفوق العرقي، ولإصداره كتاباً ينتقدهم بعنوان "ساعة الحسم".
كارل ياسبرز (1883 – 1969):
فيلسوف وجودي ألماني، "بدأ استاذاً في جامعة بال، ثم كطبيب للأمراض العقلية، وقد حدد هذا بشكل كبير تصوره للمشكلات الفلسفية، ولم ير "ياسبرز" في الظواهر السيكولوجية المرَضَية ("المقدمة إلى علم النفس المرضي" – 1913) تعبيراً عن تحلل الفرد، بل رأي فيها بحث الإنسان عن فرديته، ولما كان ياسبرز قد اعتبر هذا البحث المَرَضي هو لُبْ التفلسف الحقيقي، فقد توصل إلى أن أية صورة عقلية للعالم ليست حتى الآن معرفة، فهي لا يمكن إلا أن تكون شيفرة للوجود تحتاج دائماً إلى تفسير، وفي رأيه "أن المحتوى الداخلي للفلسفة لا ينكشف إلا بـ"الفهم" الصميمي للـ"شيفرة"، فليست مهمة الفلسفة سوى استيعاب ما هو لا عقلي، الذي يسود العالم، وفهمه على أنه مصدر الحكمة القصوى ("العقل الوجود" – 1935).
"تتجلى خصائص وجودية ياسبرز بأجلى ما تكون في مذهبه عن "المواقف الحدية"، فالمعنى الحقيقي للوجود عنده يتضح للناس خلال فترات أعمق الصدمات (المرض، الموت، الخطيئة الكبرى.. إلخ)، ففي هذه اللحظة بالضبط يحدث "سقوط الشيفرة" ويصبح الإنسان حراً من حمل الهموم اليومية ("الوجود في العالم") واهتماماته المثالية وآرائه العلمية عن الواقع ("الوجود المتعالي") وهو يواجه وجوداً صميمياً بشكل عميق ("استعادة الوجود")، كما يواجه تجربته الصادقة عن إله (متعال)، وقد افاد مذهب "الموقف الحدي" ياسبرز في الدفاع عن القيمة السيكولوجية الثقافية للحرب الباردة ("القنبلة الذرية ومستقبل الانسانية" – 1958)"([14]).
وعلى هذا النحو سينشر على التوالي: "الإثم الألماني" (1946)، "أصل التاريخ ومعناه" (1949)، "العقل واللاعقل في زماننا" (1950)، "القنبلة الذرية ومستقبل الانسانية" (1958)، "الحرية وإعادة التوحيد" (1960)، والفكرة المركزية التي تدور عليها هذه التصانيف جميعاً هي مشكلة التواصل، فعلى المجتمع والدولة أن يوفرا الشروط للتعارف المتبادل الذي يفترض ممارسة الحرية كشرط للحوار.
قالوا عنه([15]):
- "تبدو لي استنتاجات ياسبرز، على الرغم من المجهود الذي يبذله أو يعتقد أنه يبذله ليتخطى الوضعية والمثالية، موسومة بميسم المذاهب التي يحاربها ويزعم أنه يجاوزها، فهو يتخذ مثلاً على نحو ازدرائي موقفاً قاطعاً ضد كل فكرة عن الخلود، مؤكداً أن الموت بالأحرى هو ما يمكن البرهان عليه، وهنا نجد أنفسنا وجهاً لوجه مع الفسيولوجي – السيكولوجي الوثوقي. صحيح انه سيبذل داخل هذه الوثوقية الدنيوية، مجهوداً بطولياً للارتفاع إلى أعلى حد مستطاع نحو ما هو مفارق، ولكن هل نستطيع ألا نرى أنه يتحرك على كل حال ضمن سور؟ ولئن اكد أن هذا السور ليست له حدود قابلة للتعيين، أفلا يكون بذلك قد جعله أكثر انغلاقاً وأشد أسراً؟" (غبرييل مرسيل)
- "إن فكر ياسبرز بالاجمال أكثر توازناً بكثير من فكر معظم فلاسفة الوجود فهو يولي العلوم مثلاً اهمية أعظم بكثير.. وما يميزه عن زملائه هو مجهوده للوصول إلى ميتافيزيقا وإلى ضرب من لاهوت طبيعي" (إ. م. بوشنسكي)
غاستون باشلار (1884- 1962):
وُلد الفيلسوف الفرنسي باشلار لأسرة فرنسية فقيرة، لكن يبدو أن نبوغه المبكر خَلَقَ عنده نوع من الطموح لاثبات وجوده، ففي شبابه لم يتوقف عن تثقيف نفسه في المساء بعد الانتهاء من عمل النهار، حيث كان يقضي الليالي الطويلة في الدراسة والكدح والعزلة التأملية، وقد وصف كل ذلك في كتابه "لهب شمعة" (1961)، وفي عام 1912 حصل العصامي الفتى على إجازته في الرياضيات؛ و"حصل على شهادة التبريز في الفلسفة سنة 1922، وعلى الدكتوراه في الآداب سنة 1927، وجاءت أطروحته: "دراسات في تطور مسألة فيزيائية": الانتشار الحراري في الجوامد لتنبئ بموضوعها وروحها عن المكانة التي سيشغلها في تطور الفلسفة المعاصرة، وعُيِّنَ في سنة 1930 أستاذاً للفلسفة في كلية الآداب في ديجون، وهو منصب بقي يشغله عشراً من السنوات، وبين 1940 و1955 شغل كرسي فلسفة العلوم في السوربون، وفي عام 1961، منح الجائزة القومية الكبرى للآداب"([16]).
يعتبر "باشلار واحداً من أهم الفلاسفة الفرنسيين، وهناك من يقول أنه أعظم فيلسوف ظاهري، وربما أكثرهم عصرية أيضاً، كما يعتبره البعض " أحد أبرز فلاسفة المعرفة والعلم في القرن العشرين، وقد أثرَّت افكاره بقوة على العاملين في حقول: تاريخ العلم، وعلم المعرفة، وعلم النفس التحليلي والنقد الأدبي الجديد"([17]).
كرّس باشلار جزءاً كبيراً من حياته وعمله لفلسفة العلوم، وقدّمَ أفكاراً متميزة في مجال الابستمولوجيا حيث تُمَثِّل مفاهيمه في العقبة المعرفية والقطيعة المعرفية والجدلية المعرفية والتاريخ التراجعي، مساهمات لا يمكن تجاوزها بل تركت آثارها واضحة في فلسفة معاصريه ومن جاء بعده، وفي هذا الجانب، أشير إلى أن "باشلاو" من أوائل الفلاسفة الذين استخدموا مصطلح "القطيعة المعرفية".
ولعل أهم مؤلفاته في مجال فلسفة العلوم هي([18]) :
- العقل العلمي الجديد / 1934
- التحليل النفسي للنار / 1937
- تكوين العقل العلمي / 1938
- العقلانية والتطبيقية / 1948
- المادية العقلانية / 1953
- الخيال الشعري والتأمل / 1961 "الذي اكمل فيه نظريته في المعرفة، والعلاقة بين الوعي واللاوعي، وبين المحسوس والمتخيل وبين الاحساس والتجريد، لتحقيق معرفة متكاملة"([19]).
درس باشلار بعمق الوسائل التي يحصل بها الإنسان على المعرفة العلمية عن طريق العقل، وعلى هذا الأساس يعتبره البعض "مؤسساً للعقلانية الجديدة وطامحاً إلى تأسيس إبستيمولوجية (معرفة) العلوم الطبيعية. باشلار أيضاً، يُعتَبَر رائداً من روّاد علم الجمال يرى في الخيال بشقيّه العلمي والشاعريّ أساساً لما يسميّه الفلسفة المفتوحة، وهي فلسفة تتوسط (المثاليّة والمواصفاتيّة والصوريّة) التي تعلوها، والواقعيّة والاختبارية والوضعيّة التي تأتي تحتها، وهي فلسفة يطلق عليها باشلار أسماء مختلفة منها: العقلانية التطبيقية والمادية التقنية، ويرى فيها أن الواقع الذي يدرسه العلم، في تطوّره، واقع مصطنع، وهو الأمر الذي يظهر جليّاً في الميكرو فيزياء، وهو واقع مُبَنيّ، لأن الواقع العلمي قد صار بُنيات، ولهذا يجب النظر إلى الفلسفة العلمية بذاتها، من دون استخدام أيّ أفكار قَبْلية، ذلك أن العلم هو أفكار مصحّحة باستمرار، تتحول كل فكرة إلى عقبة إبستيمولوجيّة (معرفية)، والعقبات الإبستيمولوجية كثيرة منها المعرفة العامة والمعرفة الواحديّة التجريبيّة، ومفهوم الجوهر والمعرفة الكميّة.
لهذا فعلى الفيلسوف العلمي–عند باشلار- أن يرسم ما يسميّه "الجانبية الإبستيمولوجية" وهي الوجه المعرفي الجانبي لمختلف الصيغ المفهوميّة لظاهرة ما، فتطور المعارف يحدث بالقفزات وتجاوز العقبات الإبستيمولوجية أي بما يسميّه باشلار "القطيعة الإبستيمولوجية (المعرفية)""([20]).
ربما كان مفيداً معرفة شيء عن ظاهرية باشلار، إنّ الفكرة الرئيسة في الظاهراتيةPhenomenology كما أوجدها أدموند هوسرل، هي قصدية الوعي أي أن الوعي يتجه دائماً إلى موضوع، أي أنه يؤكد مقولة أنه لا يوجد موضوع من دون ذات.
كما يؤكد المنهج الظاهراتي على الامتناع عن الحكم فيما يتعلق بالواقع الموضوعي وعدم تجاوز حدود التجربة المحضة " الذاتية " ويؤكد على عدم اعتبار موضوع المعرفة موضوعاً واقعياً تجريبياً واجتماعياً بل مجرد وعي مفارق " أي أنه مستقل عن التجربة والمعرفة المحددة أي ميتا فيزياء ".
إنّ المهم، في فلسفة باشلار، هو أن يَظَلْ الإنسان ذا شخصية مفتوحة على العالم والقراءة، ويظهر الإنسان في كتابه "شاعرية أحلام اليقظة" وهو يبدع ويَخْلِق؛ يَظْهَر بصفته منبعاً وموقظاً لعوالم، سواء كانت عوالم العلوم أم عوالم الفنون، وهو الكائن الذي يواجه جميع التحديات، لاسيما تحدي اللحظة، بالإبداع والاختراع، الكائن الذي يناضل ضدّ نوم العالم وضدّ غفلته، يقول بشلار:"نحن نعيش في عالم نائم علينا أن نوقظه بواسطة الحوار مع الآخرين،وما إيقاظ العالم إلاّ شجاعة الوجود بأن نوجد ونعمل ونبحث، نخترع، نبدع، نخلق".
([1]) يوسف حسين – محاضرة في اليوتيوب – الانترنت.
([2]) ول ديورانت– قصة الفلسفة – ترجمة: د.فتح الله محمد المشعشع - مكتبة المعارف – بيروت – الطبعة الخامسة 1985م - ص585
([3])المرجع نفسه – ص589
([4])المرجع نفسه - ص591
([5]) المرجع نفسه - ص593
([6]) المرجع نفسه – ص595 - 597
([7]) ابراهيم أبو عواد – برتراند راسل والقضية الفلسطينية – موقع القدس – 16/4/2017.
([8]) المرجع نفسه – ابراهيم أبو عواد.
([9]) جورج طرابيشي – مرجع سبق ذكره – معجم الفلاسفة – ص 170
([10]) ازفلد شبنجلر: فيلسوف حضارة ألماني، أحدث تأثيراً هائلاً بكتابه "انحلال الغرب"، ولد بلاكنبورج في 29 مايو 1880 وتوفي في 8 مايو سنة 1936 في منشن، وأمضى حياته وحيداً في عزلة هائلة وحرية كاملة منقطعاً للبحث والقراءة والتاليف وكان كتابه "انحلال الغرب" مصدر ثروة كفلت له المعاش طوال حياته.
([11]) موقع ويكيبيديا – الانترنت .
([12]) فلسفة التاريخ .. جدل البداية والنهاية والعود الدائم - تأليف مجموعة من الأكاديميين العرب- دار الروافد الثقافية – الطبعة الأولى ، 2013 – ص595
([13]) المرجع نفسه - ص595
([14]) م. روزنتال و ب. يودين – الموسوعة الفلسفية – دار الطليعة – بيروت – ط1 – أكتوبر 1974 -ص 590
([15]) جورج طرابيشي – مرجع سبق ذكره – معجم الفلاسفة – ص 738-739
([16]) المرجع نفسه– ص 143
([17])سامى خشبة – مرجع سبق ذكره - مفكرون من عصرنا – ص 155+156
([18]) موقع ويكيبيديا – الانترنت.
([19])سامى خشبة – مرجع سبق ذكره - مفكرون من عصرنا – ص 155+156
([20])كاستون باشلار - موقع المعرفة – الانترنت www.marefa.org