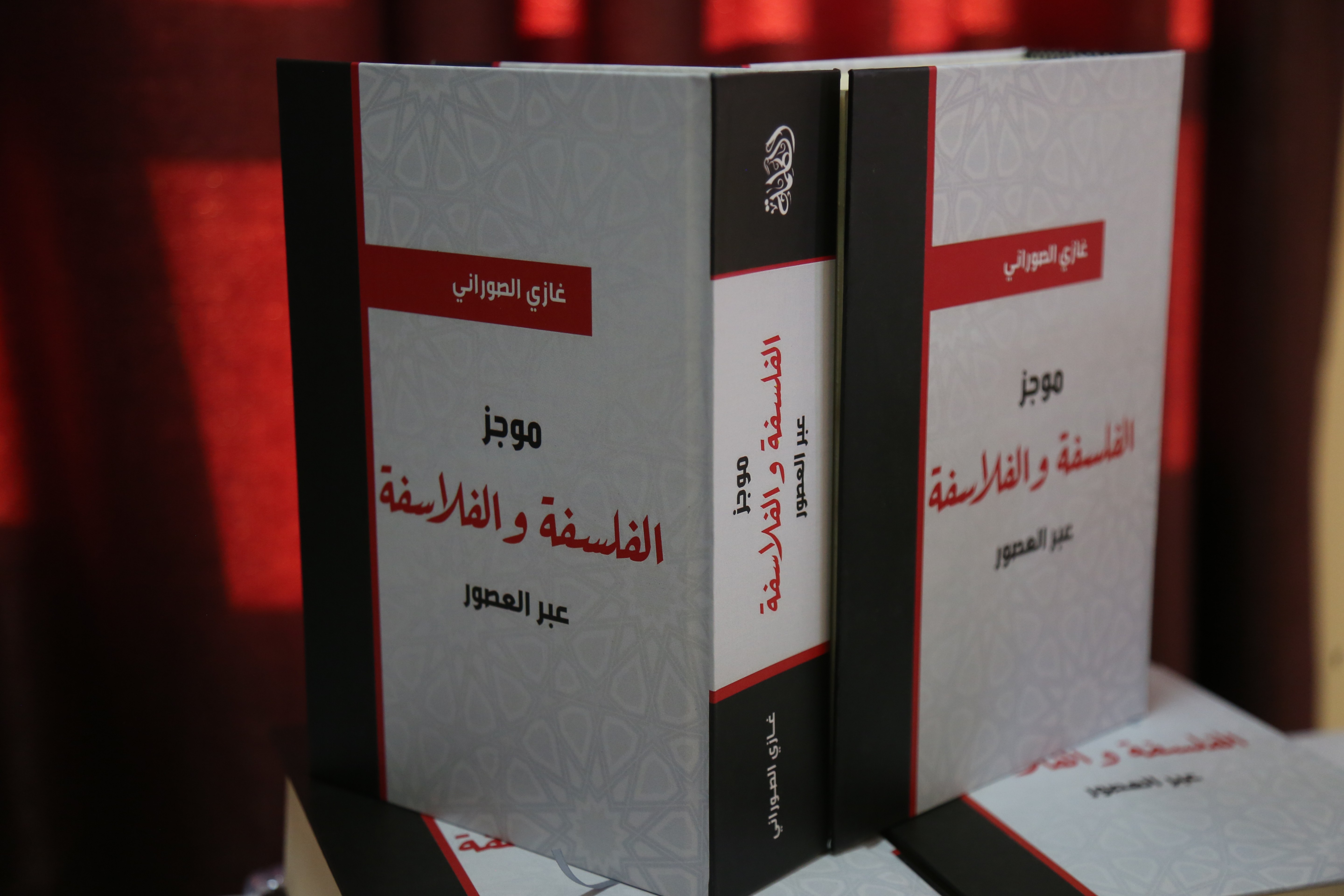(تنفرد بوابة الهدف، بنشر كتاب المفكر غازي الصوراني، المعنون: موجز الفلسفة والفلاسفة عبر العصور، الصادر عن دار الكلمة للنشر والتوزيع، في يونيو/ حزيران 2020، على حلقات متتابعة.. قراءة مثمرة ومفيدة نتمناها لكم).
الباب الرابع
الفصل الحادي عشر
الفلسفة في القرن العشرين
أبرز فلاسفة القرن العشرين
ريمون آرون (1905م - 1983م):
من كبار ممثلي الانتلجنسيا الفرنسية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. من جيل جان بول سارتر، قرأ منذ وقت مبكر علماء الاجتماع وفلاسفة التاريخ الألمان، وكان أول كتاب نشره: "مدخل إلى فلسفة التاريخ" (1938)، وهو في الأصل أطروحته للدكتوراه، كما "تأثر بفكر هايدجر وهوسرل وماكس فيبر، وعنهم أصدر كتبه الأولى: "علم الاجتماع الألماني المعاصر" (1936)"([1]).
"ابتداء من عام 1946 افترق عن سارتر لتعاطف هذا الأخير مع الشيوعيين، وقد عرض "آرون" أفكاره السالبة حول الماركسية في كتابه الذي أصاب شهرة كبيرة: "أفيون المثقفين" (1955)،وتناول نقده ثلاث كلمات "مقدسة" في حينه: اليسار، الثورة، البروليتاريا. وفي الواقع، لم يكن هدفه الشيوعيين أنفسهم، بل "التقدميون" من المثقفين الفرنسيين الذين كانوا يبدون حساسية مفرطة إزاء نواقص الديموقراطية الغربية ويعبئون طاقاتهم الفكرية لتبرير أخطاء الماركسية وجرائم ستالين. وكان رأس حربة نقده موجهاً إلى سارتر"([2]).
في عام 1955 انتخب لشغل كرسي علم الاجتماع في السوربون، ففرضت دروسه نفسها للحال وكأنها من كلاسيكيات علم الاجتماع المعاصر: "ثمانية عشر درساً في المجتمع الصناعي" (1963)، "صراع الطبقات" (1964)، "الديمقراطية والتوتاليتارية" (1965)، "مراحل الفكر السوسيولوجي" (1967). وعندما وقعت في عام 1968 "الثورة الطلابية" وقف منها، بعكس سارتر وممثلي الانتلجنسيا اليسارية، موقفاً معارضاً صارماً، وأدان أهدافها ووسائلها في كتابه "الثورة المفتقدة" (1968)، وفي كتابه التالي: "من عائلة مقدسة إلى أخرى: دراسة في الماركسيات الوهمية" (1968) أجرى تحليلاً نقدياً لاذعاً للكيفية التي كان يجري بها توظيف ماركس أيديولوجياً من قبل سارتر، وعلى الأخص من قبل لوي ألتوسير الذي كان آنذاك في قمة شهرته.
تميز ريمون آرون بمواقفه اليمينية المؤيدة للسياسات الأمريكية، بما في ذلك تأييده للولايات المتحدة في حربها ضد فيتنام، على النقيض من سارتر، فعلى حين أن سارتر نظم مع الفيلسوف البريطاني برتراند راسل محكمة دولية لإدانة جرائم الحرب الأميركية في فيتنام، فإن آرون، الذي ارتقى هو الآخر إلى مصاف كبير مفكري الليبرالية الفرنسية أيد بالمقابل حرب الأميركان في فيتنام وقصفهم لهانوي"([3]).
على الرغم من كل ما تقدم، يعتبر ريمون آرون "أحد أبرز المفكرين الفرنسيين – والغربيين عموماً-، اهتم بمجالات عديدة في الفلسفة وعلم الاجتماع والاستراتيجية الكونية، والسياسة الاوروبية، والتحليل الاجتماعي والسياسي، ويعد أحد واضعي نظرية توازن الرعب النووي في العصر الحديث"([4]).
سيمون دو بوفوار (1908 - 1986):
فيلسوفة فرنسية وجودية، أديبة وروائية، وناشطة سياسية ونَسَوية، اشتهرت بكتابها "الجنس الآخر" ضد اضطهاد المراة والتأكيد على مساواتها بالرجل.
حصلت على شهادة التخرج من جامعة السوربون في "علم النفس والاجتماع والأخلاق" عام 1928، وكانت حينها السيدة التاسعة التي تحصل على إجازة من السوربون في ذلك الوقت.
"ترعرعت سيمون دو بوفوار في وسط بورجوازي تقليدي في فرنسا، حيث لم تكن النساء قد حصلن على حقوق التصويت العامة إلا بعد الحرب العالمية الأولى، يوم كانت قد قاربت الأربعين عاماً من العمر. كما صارت عضواً في وقت مبكر في الحلقة الوجودية الراديكالية مع سارتر. وخلال حقبه الاضطراب تلك "ركزت دو بوفوار اهتمامها على الدور الاجتماعي اللامتساوي المفروض على النساء كجماعة، ففي ذلك المجتمع: عَرَّفَتْ النساء بأنهن الآخر نسبة إلى الرجال، وكانت نظرة الذكر هي التي تعرف الرجال والنساء كليهما، وهي التي عَرَّفَتْ النساء بأنهن "الجنس الآخر"، وعليهن أن يقبلن تلك النظرة عن أنفسهن وتلك النظرة عن الرجال. وكانت النتيجة أن هوية النساء لم تكن صحيحة، وقد رفضت دوبوفوار ذلك التعريف، واعتبرته إساءة تثير الغضب، لأن البشر في نظر الوجوديين يُعْرَفونَ بالحرية بشكل رئيسي، الحرية بأن يقرروا بصورة شخصية من سيكونون"([5]).
"كان هدف دو بوفوار المساواة في نواح عديدة. فعلى الرجال والنساء أن يتبادلوا الاعتراف بأنهم متساوون. ولا يعني ذلك أن الجميع متشابهون، وأن لا وجود لأساليب حياة فردية متنوعة، غير أن القمع العمومي للنساء يجب الاعتراض عليه، وطالبت بمساواة المرأة مع الرجل في كافة النواحي"([6]).
أهم مؤلفاتها: "الجنس الآخر" و "المرأة بين الحب والزواج" و "نموذج المراة الحديثة" ورواية "المثقفون".
توفيت عن عمر يناهز 78 عاماً بسبب الالتهاب الرئوي، ودفنت في باريس في مدفن "مونبارناس" بجانب رفيق وشريك عمرها جان بول سارتر.
كلود ليفي ستراوس ( 1908 – 2009 ):
ولد في بلجيكا بمدينة بروكسل، ونشأ في جو مليء بالفنون والثقافة والأدب، وفي الفترة من 1927 – 1932 كان ستراوس طالباً في جامعة باريس حيث حاز على إجازة في القانون والفلسفة، واشتملت قراءاته في هذه المرحلة على أعلام المدرسة الفرنسية في علم الاجتماع.
وبعد أن درس القانون لفترة قصيرة في جامعة باريس، ابتدأ العمل مدرساً في الليسيه. لكنه سرعان ما تركه ليرتحل إلى البرازيل عام 1934، بعد أن عُرِضَ عليه منصب أستاذ لعلم الاجتماع في جامعة ساوباولو، إذ رأى في هذا المنصب فرصة للقيام برحلات للدرس الميداني في أدغال البرازيل، وفي عام 1940 عاد إلى فرنسا للخدمة العسكرية، ولكنه تركها ورحل إلى الولايات المتحدة بعد سقوط باريس عام 1941، حيث تولى في نيويورك منصبًا في الكلية الجديدة للبحث الاجتماعي عام 1943، وقد أتاحت له فترة الإقامة هناك الفرصة لكتابة أطروحته في الدكتوراه "البنى الأولية للقرابة.
يعد كلود ليفي ستراوس من أهم البنيويين المعاصرين، وأكثرهم شهرة، بل ان البنيوية ترتبط باسمه ارتباطاً مباشراً، وهذا ما جعل الباحثين يطلقون عليه عدد من الألقاب، التي تشير إلى مدى تأثيره وتأثره بالبنيويين والبنيوية عموماً، فَلُقِّبَ بعميد البنائيين، أو شيخ البنيويين، أو البنيوي الأول، أو رائد البنيوية المعاصرة، أو أكبر مهندسي الفكر في العصر الحديث.. الخ. ولعل هذا الاهتمام من قِبَلْ الباحثين به يرجع إلى استعماله المنهج البنيوي في كافة المجالات التي تطرق إليها بالبحث، وخصوصا في مجال الأنثروبولوجيا، ذلك المنهج الذي يبحث عن الحقيقة التي تكمن وراء الوقائع الملاحظة.
تم اختياره لكرسي الأنثروبولوجيا الاجتماعية في الكوليج دي فرانس 1959، وفي 1964، ونال وسام جوقة الشرف في هذه المدة من حياته، ألَّفَ شتراوس مجموعة من المؤلفات، وكتب العديد من المقالات التي نشرها في المجلات العالمية، والتي ضمها فيما بعد إلى مؤلفاته، حيث تناول فيها دراسة الكثير من الظواهر على وفق المنهج البنيوي.
من مؤلفاته:
- الحياة العائلية والاجتماعية لهنود النامبيكوارا (1948).
- العرق والتاريخ (1952).
- الانتروبولوجيا البنيوية (ج.1)(1958).
- الفكر البري (1962).
- الاسطورة والمعنى (1978).
ألبير كامو (1913 - 1960):
روائي وفيلسوف فرنسي، ولد ونشأ في الجزائر،انتمى إلى الحزب الشيوعي عام 1935، ولكنه تركه بعد سنة، لكنه شارك في مقاومة المحتل النازي في إطار المقاومة الفرنسية، نشر عام 1942 رواية "الغريب"، وفي العام التالي "أسطورة سيزيف"، تعرف إلى سارتر وتعاون معه إلى يوم القطيعة بينهما على 1951 الذي أصدر فيه "الإنسان المتمرد".
يعتبر كامو ممثلاً للوجودية الملحدة، "تشكلت آراؤه تحت تأثير "شوبنهور" و"نيتشه"([7])، لكن "علاقته بالوجودية – رغم اشتهار انتمائه إليها – متوترة ولم يكن مفهوما الماهية والوجود من مصطلحات معجمه، ورأى في الخصومة حول أسبقية أحدهما على الآخر سكولائية جديدة.
عارض الإلحاد الفلسفي بلاأدرية ملتزمة، واشتهر قوله: "إنني لا أؤمن بالله، لكنني لست ملحداً، كما ذاع في الآفاق مفهومه عن "العبث" أي عن عالم يغيب عنه الله والاعتقاد بالخلود، ولا يبقى فيه أمام الإنسان من اختيار آخر غير أن يعيش في حالة مضنية من صحو الفكر"([8]).
العالم الخارجي، أي الكون، "في رأي كامو هو حالة من حالات الذات، والمشكلة الفلسفية الوحيدة عنده، هي "مشكلة الانتحار" وقد تشبعت آراؤه في مجال الأخلاق بالتشاؤم المتطرف: فالإنسان عنده هو دائماً، في "حالة عابثة"، ويواجه "مواقف عبثية"، (الغيرة والطموح والانانية)، كما أنه مُقَدَّر عليه أن يقوم بنشاط لا معنى له ولا هدف، وتتجلى في أعمال كامو النزعة الفردية والنزعة اللاعقلانية المتطرفتان"([9]).
أهم أعماله "اسطورة سيزيف"، (1942) و"الطاعون" (1947) و"الإنسان المتمرد" (1951)، وكان رئيس تحرير لصحيفة "كومبا"، نال جائرة نوبل عام 1957.
بول ريكور (1913 - 2005):
فيلسوف فرنسي وعالم إنسانيات معاصر، هو واحد من ممثلي التيار التأويلي، اشتغل في حقل الاهتمام التأويلي، ومن ثم بالاهتمام بالبنيوية، وهو امتداد لفريديناند دي سوسير. يعتبر ريكور رائد سؤال السرد. أشهر كتبه "نظرية التأويل" و "التاريخ والحقيقة" و "الزمن والحكي" و "الخطاب وفائض المعنى" من منشورات جامعة تكساس المسيحية عام 1976.
" يمثل في الفلسفة الفرنسية المعاصرة محاولة أصيلة تستلهم الوجودية والفينومينولوجيا، وتريد بالإضافة إلى التيارات البنيوية والعقلانية، أن تحصر نفسها بمسألة التأويل أو "توضيح الحواس"، أي النظر في الوجود من خلال تحليل الفعل الإرادي، وذلك هو منحى كتابه الأول "الإرادي واللا إرادي" (1950) الذي وَصَفَ فيه إيجابية الإنسان وسلبيته إزاء العالم.
يرى ريكور –كما يقول جورج طرابيشي- "أن الشر ياتي إلى العالم من جراء عدم تطابق الإنسان مع ذاته على مختلف مستويات المعرفة والفعل والعاطفة، وهو كمفكر مسيحي وثيق الارتباط بالبروتستانتية، يرمي بمذهبه إلى تعقل "كلية الإنسان" ككائن يعرف ويحس ويفعل، أي إلى التحليل الأخير كشخص غير قابل للاختزال"([10]).
بول ريكور الذي عاش مديدا تجاوز التسعين، بعد أن بلور فلسفة كاملة عن الإنسان والمجتمع والدين والسياسة، كان من الداعين إلى تفسير الدين بشكل عقلاني جديد، لكي نخرج –وفق منظوره- "من جحيم التعصب وظلامية المتعصبين الضيقي الأفق"، وقال "إن للدين مجاله وللفلسفة مجالها ولا ينبغي الخلط بينهما، ولكن الدين يستفيد كثيرا من الفلسفة إذا ما تبنى مناهجها العقلانية في التحليل دون أن يقضي ذلك على خصوصيته أو روحانيته أو تنزيهه وتعاليه"، وبالتالي فقد "أقام بول ريكور مصالحة ذكية بين الدين المسيحي والفلسفة"، ومعلوم–كما يقول هاشم صالح- أن "محمد أركون الذي كان تلميذه وصديقه فعل نفس الشيء بالنسبة للإسلام"([11]).
علاقة فلسفة ريكور والدين أو اللاهوت:
فيما يتعلق بالعلاقة بين الفلسفة والدين أو بالأحرى اللاهوت، "عمل ريكور – دائماً – على التمييز بين أسلوب ومضمون الخطاب الفلسفي من جهة، وأسلوب ومضمون اللاهوت من جهة أخرى؛ وذلك من أجل تجنب الخلط بين الأنواع والفروع المعرفية المختلفة"([12]).
لكن، وعلى الرغم من ذلك، فقد اشتبه، بل واَتَهَم، بعض النقاد ريكور بأنَّ كتاباته الفلسفية ليست إلا "لاهوتاً متخفّيا"، ويبدو أنَّ "منتقدي ريكور –كما يقول حسام درويش- بخصوص الجانب اللاهوتي من فكره، لا يميزون – لدى ريكور – بين البواعث العميقة لالتزامه الفلسفي ولوجوده الشخصي والطائفي من جهة، وبين البنية أو الأسلوب الفلسفي الذي اتبعه ريكور في الحجاج والتدليل على أفكاره في أعماله الفلسفية من جهة أخرى، فريكور نفسه لم يدَّع أنَّ قناعاته واعتقاداته الدينية لم تؤثِّر على الاهتمام الذي أبداه – في أعماله الفلسفية – تجاه هذه المسألة أو تلك، لكنَّ ذلك لم يمنعه من التأكيد على الاستقلال النسبي لكلّ ميدان معرفي عن الآخر، مع التأكيد أيضاً على ترابطهما الوثيق بشكل يسمح بتأسيس علاقة تصالحية – لا عدائية – بين هذين الميدانين"([13]).
تيوردور إيليتش أويزرمان (1914 - 2017):
فيلسوف ماركسي روسي معاصر، ولد سنة 1914، انتسب إلى الحزب الشيوعي عام 1941، من 1941 إلى 1951 أدار "قطاع الفلسفة البورجوازية وعلم الاجتماع" في معهد الفلسفة التابع لأكاديمية العلوم السوفياتية.
حصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الفلسفية عام 1952، وترأس منذ 1954 كرسي تاريخ الفلسفة الأجنبية في جامعة موسكو([14]).
إبتداء "من سنة 1954، أدار "أويزرمان" كرسي استاذية تاريخ الفلسفة في جامعة موسكو، وفي 1962 أصبح عضواً في هيئة تحرير مجلة "مسائل فلسفية"، ونشر في نفس العام كتابه "تكوين الفلسفة الماركسية" (550 صفحة)، ثم صدر له عام 1969 عن دار ميسل للنشر، كتاب "مشاكل العلم التاريخي – الفلسفي" (398 صفحة) وكتاب "المراحل الكبرى للفلسفة قبل الماركسية" بالإضافة إلى عدد من الدراسات أهمها: "حول أسطورة الرجعية البورجوازية" و "الهرطقة المناهضة للشيوعية" و "الفلسفة والوعي الاعتيادي" و "ماركس ، هيجل والوعي البورجوازي المعاصر" و "حول معنى السؤال: ما هي الفلسفة"([15]).
ويبدو أن معظم كتبه ودراساته لم تترجم إلى اللغة العربية.
أدولفو سانشيز فاسكيز (1915 - 2011):
فيلسوف ماركسي مكسيكي مولود في إسبانيا، وعمل ككاتب وأستاذ، "درس الفلسفة في جامعة كمبلوتنسي بمدريد، ثم هاجر إلى المكسيك في عام 1939 مع الآلاف من المفكرين والعلماء والفنانين الآخرين بعد هزيمة الشيوعيين والمناضلين من أجل الجمهورية في أسبانيا، وانتصار القوى اليمينيه الفاشية بقيادة "فرانكو" في الحرب الأهلية الاسبانية، والتي شارك فيها "فاسكيز" كمحرر للنشر المركزي لرابطة الاجتماعيين الجمهوريين"([16]).
تم تعيين سانشيز كأستاذ متفرغ للفلسفة في الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك في عام 1959، ليصبح أستاذًا فخريًا للجامعة في عام 1985.
اعتنق أدولفو الماركسية، وكان تفسيره الجديد للماركسية متوازيًا مع تفسير مدرسة فرانكفورت. تم نشر كتابه "فلسفة براكسيس" في نفس الوقت الذي كان فيه هربرت ماركيوزه يكتب كتابه "الإنسان ذو البعد الواحد".
- الأفكار الجمالية لماركس (1965)
- فلسفة براكسيس (1967)
- فلسفة روسو وأيديولوجية الاستقلال (1969)
- الجماليات والماركسية (1970)
لوي ألتوسير (1918 - 1990):
فيلسوف فرنسي ماركسي، ولد في بلدة "بير مندريس" في الجزائر. تابع دراسته في فرنسا حتى نال شهادة في الفلسفة سنة 1948.
"وضع ألتوسير خطة لعمله الفكري الذي استغرق كل حياته، كما وضع أسساً فلسفية لتحديد النظرية الماركسية مكنته من فهم ماركس فهماً خاصاً، فقد رأى أن مؤلفات ماركس الشاب وليدة تأثير هيغل، وأن حياة ماركس الفكرية كانت محاولة مستمرة للخروج من هذا التأثير، وأنها لم تصل إلى تحققها واستقلالها إلا بكتابه "رأس المال"، لهذا رأى ألتوسير أنه لابد من فصل مؤلفات ماركس الشاب عن "رأس المال"، والنظر إلى هذا الكتاب على أنه عمدة الماركسية، وأن ما عداه من مؤلفات ماركس ليس ماركسياً إلا بقدر ما يوافق مضمونه مضمون "رأس المال""([17]).
يعتبر ألتوسير"من أكبر نقاد الفكر الستاليني، ومن المناضايين ضد النازيه، قضى خمسة أعوام في معسكرات الاعتقال النازية أثناء الحرب، وفي عام 1948 أنضم إلى الحزب الشيوعي الفرنسي، واستقال منه عام 1968 عقب الغزو السوفيتي لتشيكوسلوفاكيا، "نشر أول كتاباته الهامة عام 1961 وجمعها في كتابه: "من أجل ماركس" في باريس 1965، وكان هدفه الأول –كما يقول- هو: تحرير الماركسية (وبشكل خاص: المادية التاريخية) من التشويهات التي أدخلها ستالين ومن قبله فريدريك انجلز الذي فرض تصورات الفيلسوفين: هيجل وفيورباخ على أفكار ماركس؛ وكان هدفه الثاني هو اثبات ان الماركسية ليست فلسفة، ولا وجهة نظر شاملة للكون وللمجتمع، ولا حتى أيديولوجية، وإنما مجرد علم للتاريخ وعلم لإنتاج المفاهيم النظرية نفسها"([18]).
وقد برز هذا الاتجاه في فهم ماركس في كتابات ألتوسير التي ظهرت في الستينات، مثل مقالاته: "حول العمل النظري، صعوباته ومصادره" (1967) و"الفلسفة سلاحاً ثورياً" (1968) وكتاب "قراءة في رأس المال" (1968) الذي صدر في جزأين (وهو عمل فريق من المفكرين الماركسيين تزعمه ألتوسر). إضافة إلى كتابين آخرين هما: "الفلسفة وفلسفة العلماء التلقائية" (1967)، و" لينين والفلسفة" (1969)([19])، " وكان الهدف الذي رمى إليه هذان الكتابان -كما يقول المفكر الراحل جورج طرابيشي- تجديد تأويل الماركسية، وقد أثارا مناقشات حامية الوطيس داخل الحزب الشيوعي الفرنسي وخارجه على حد سواء، ذلك أن ألتوسير انتمى إلى هذا الحزب منذ عهد المقاومة ضد الاحتلال النازي، كما أن التلاميذ الذين التفوا حوله أعضاء في الحزب نفسه، لكن العمل النظري الذي قاموا به أرادوه خارج الرقابة الإيديولوجية لقيادة الحزب. وقد أفلح ألتوسير، إذ استغل مرحلة " ليبرالية" في الحزب ووجود تيارات متباينة في قيادته، في نشر مؤلفاته بصورة مستقلة وفي فرض نفسه كمحاور ممكن داخل حزبه بالذات .
يشكو ألتوسر، في المقدمة التي وضعها للدراسات التي يتألف منها كتابه "مع ماركس"، من عدم كفاية نظرية ماركس داخل الحزب، ويأخذ على عاتقه تكوين فلسفة ماركسية بحق معنى الكلمة. ذلك أنه يفترض أن مؤسسي الماركسية ما زادا على أن قدما أحجار زاوية ؛ ولئن وضعا نظرية علمية في التاريخ، فإنهما لم يرسما بالمقابل إلا المعالم الأولية للمادية الجدلية، لذلك سعى ألتوسير إلى البرهان على أن مؤلفات ماركس الشاب لم تكن ماركسية بعد، وأن أثر هيجل ثم فيورباخ غالب عليها. أما المفاهيم الماركسية النوعية فينبغي طلبها في كتابه "رأس المال"، وبالتالي فإن قراءة ألتوسير الجديدة هذه لماركس –كما يضيف جورج طرابيشي- "لا تتردد في ان تغرف على سعة من مَعِين مؤلفين غير ماركسيين (باشلار، فرويد، لاكان، ليفي، ستراوس) لتؤكد على الجانب العلمي للمذهب نافية عنه كل مظهر إنسانوي، وقد أدت هذه النظرة إلى الماركسية بألتوسر إلى مخالفة خط الحزب الشيوعي الفرنسي، وما لبثت أن أدخلته في نزاع سياسي، وترك الحزب الشيوعي سنة 1978"([20]).
وفي هذا السياق، يعلق المفكر الراحل صادق العظم قائلا: " إن الخلفية المثالية التي انطلق منها ألتوسير واستخدمها في إعادة قراءة الماركسية، ومن أجل بناء ماركسيته البنيوية، هي السليلة الشرعية الأكثر تطوراً وعصرية للخلفية الفلسفية المثالية التي كان قد انطلق منها لوكاش واستخدمها في صياغة ماركسيته الأولى"([21])، ثم يطرح د. العظم استنتاجاته النهائية حول دعاوى آلتوسير في هذا الميدان على شكل خمس اطروحات موجزة تتناول البنيوية عموماً والماركسية الآلتوسيرية تحديداً ([22]):
- تعني علمية الماركسية عند آلتوسير: موت مركزية الموضوع في المعرفة لصالح أولوية الجهاز المعرفي ذاته.
- تعني لا إنسانوية الماركسية عنده: موت مركزية الإنسان الفاعل الصانع لصالح أولوية البنيات المفعولة والمصنوعة.
- تعني لا تاريخانية الماركسية عنده: موت مركزية التعاقب التطوري لصالح أولوية التزامن الوظيفي.
- تعني لا تجريبية الماركسية عنده: موت مركزية الواقع المادي لصالح أولوية النموذج النظري.
- تعني لا اقتصادوية الماركسية عنده: موت مركزية القاعدة الاقتصادية لصالح أولوية الكل الاجتماعي.
يضيف صادق العظم قائلاً: "في قراءة آلتوسير "لرأس المال" لا يرى الجماهير عند ماركس بشراً وناساً وذوات فاعلة، إنما مجرد "حوامل" نظرية لمفهوم علاقات الانتاج في منظومة التصورات التي تشكل بارادايم أو إشكال المادية التاريخية، وهنا أعتقد – يقول د. العظم – " أن موقف آلتوسير يخلط ببساطة بين الأيديولوجيات التاريخانية – المثالية (الذات المطلقة عند هيجل، مشاريع الوجود لذاته عند سارتر، مفهوم كارل بوبر للتاريخانية) وبين تاريخانية ماركس المادية والجدلية العاملة على تجاوز سكونية العلوم الاجتماعية والإنسانية نقدياً بدمجها في التاريخ وصيرورته وتحولاته"([23]).
أما السؤال عن إمكانية استيعاب بنيوية آلتوسير حقيقة التطور التاريخي والتعاقب الزمني إلخ بحيث تسمح لنا تعاليمه ومصطلحاته بالكلام عن نشوء العناصر الأولية لبنية المجتمع البورجوازي، مثلاً، في داخل بنية المجتمع الاقطاعي؟ فإن جوابي على ذلك -يقول د. العظم- "في المادية التاريخية لا يوجد بنية بلا تاريخ أنتجها، كما أن التاريخ يكون تاريخ لا شيء إن لم يكن تاريخ بنيات حقيقية محددة، لهذا لابد للبنيوية السكونية التي يحاول آلتوسير إقحامها في المادية التاريخية من الاصطدام الحتمي بتاريخية المادية التاريخية، من هنا هذا الشعور بالدوار واللاجدوى الذي يصيب القارئ وهو يعمل على متابعة تعرجات نصوص آلتوسير (وباليبار بصورة خاصة) والتواءاتها ولفها ودورانها في محاولاتها الشاقة للتعامل بصورة مقبولة مع مسائل حركة التاريخ ومشكلات تحول المجتمعات وقضايا الانتقال من أنماط إنتاج معينة إلى أخرى، في مقابل إعلان ماركس وإنجلز في "الايديولوجيا الألمانية" بأنهما لا يعرفان إلا عِلْماً واحداً هو عِلم التاريخ، وفي مقابل إسهامهما الأصيل في الكتابة العلمية للتاريخ وفي مقابل إهتمامهما الواسع والعميق بالانتاج الفكري التاريخي والتأريخي للعصور الحديثة كلها، يوجد شيء ما مأساوي وبائس في قراءة ألتوسير للماركسية عموماً ولـ"رأس المال" خصوصاً، تجعل من التاريخ خصماً للمادية التاريخية ومعضلة غير قابلة للاستيعاب والتفسير ضمن إطار منهجها وأطروحاتها، تتجلى هذه الخصومة في إعلان آلتوسير المبدأين التاليين في "قراءة رأس المال":
- في مواجهة الهيجليين والتطوريين والنشوئيين والتجريبيين نحن نهتم بالنتيجة دون صيرورتها.
- كل تعاقب هو تعاقب تابع لنسق تزامني معين ومحدد لأن التزامن هو المبدأ الذي يحكم كل شيء، فإذا كان لوكاش قد حول الزمن التاريخي من معناه التراكمي التطوري، كما عند هيجل وماركس، إلى تجربة انحطاط وتدهور، فإن ألتوسير يلغيه من حسابه وحساب الماركسية نهائياً"([24]).
من المفيد هنا ، أن نشير إلى إلحاح ألتوسير على نقطتين في فهم ماركس وشرحه، أولاهما أن الجدل الماركسي ليس استمراراً للجدل الهيغلي، وأن هناك قطيعة معرفية بينهما؛ وثانيهما أن ماركس يعطي مقولة المادة أولوية فلسفية، فما يجب تحليله هو الوقائع المادية من حيث هي مادية، ويجب دراستها دراسة علمية، وهذا ما فعله في "رأس المال"، فقد قَسَم ألتوسير فكر ماركس إلى مرحلة أيديولوجية تنتهي سنة 1845 ومرحلة علمية تبدأ بانتهاء المرحلة الأيديولوجية، كما يضع ألتوسير القارىء هنا أمام طورين ماركسيين مختلفين: أحدهما أيديولوجي يعنى بما هو إنساني وفلسفي وأنتروبولوجي، وثانيهما علمي يعنى بالدراسة النظرية البنيوية التي تقوم على مفهومات علمية دقيقة. وهو يعتقد أن هذه المرحلة الأخيرة هي التي تمثل الماركسية.
في هذا الجانب، يستشهد ألتوسير بما كتبه ماركس في أطروحته عن فويرباخ، إذ قال: "إن الفلاسفة صرفوا كل اهتمامهم حتى الآن إلى تفسير العالم تفسيرات متعددة، في حين إن الأمر يتعلق بتغييره". وهو يرى أن هذا الكلام بمنزلة إعلان القطيعة بين الفلسفة والإيديولوجية، لإحلال علم جديد محلهما، ويقوم هذا العلم على مفهوم "البنية" المتحققة الذي هو محاولة للحلول محل الذات، وإقامة قطيعة إبستيمولوجية مع كل فلسفة تنطلق من الذات.
وهكذا كان على ماركس، بحسب رأي ألتوسير، أن يستبعد كل تاريخ الفلسفة، من حيث هو سرد للأوهام التي يجب تبديدها، ومواجهة الواقع وحده لأنه هو الذي يفرض نفسه على كل بحث نقدي، ولكن ألتوسير لا يقصر القطيعة على الفلاسفة، بل يريدها أن تتعداهم إلى علماء الاقتصاد والمؤرخين والمناطقة، في سبيل الاهتمام بالسؤال الإبستيمولوجي الذي يذهب إلى صميم الممارسة النظرية الجديدة التي دعا إليها ماركس.
انتهى ألتوسير من دراسة ماركس إلى الأفكار التالية([25]):
- إن ماركسية ماركس لم تنضج إلا في "رأس المال" ونضجها لم يكن دفعة واحدة، وإنما مر بمراحل نمو متقطعة.
- إن الماركسية ليست منظومة مغلقة، بل مفتوحة على تجربة الواقع والتاريخ.
- إن الماركسية تلح على الرؤية الكلية من دون تفسير الأمور بسبب وحيد؛ فالعلاقات الاجتماعية مثلاً ترتد إلى أسباب ثقافية وأيديولوجية وسياسية يحددها العامل الاقتصادي الذي يكملها ويدفعها في اتجاه التحقق التاريخي.
- إن الماركسية لا تؤمن بحياد سياسي فكري، لأن كل نظرية تحمل اتجاهاً سياسياً معيناً.
لكن ألتوسير لم يقف عند فهم ماركس وشرحه، بل ذهب أبعد من ذلك لاستخلاص أفكار خاصة به، فهو يرى أن للمثقفين الثوريين دوراً إيجابياً في توجيه الطبقة الكادحة (البروليتارية) في نضالها مع الرأسمالية، وفي إقامتها المجتمع الشيوعي، وأنها كانت تشعر في الماضي بأنها مُستَغَلَّة، من دون أن تفهم طبيعة استغلالها، إلى أن أتت الماركسية، فبينت لها ذلك، وأتاحت لها القيام بأفعالها الثورية طبقاً للواقع الموضوعي لصراع الطبقات.
بيد أن الطبقة الكادحة قد تخطئ، وقد تنحرف عن خطها النضالي الصحيح، ومن هنا كان دور المثقفين الثوريين الذين ينظِّرون للبروليتاريا ويوجهونها: إنهم وإن كانوا لا يصنعون التاريخ، إلا أنهم يوجهون البروليتاريا التي تصنعه.
لكن يبدو أن ألتوسير قد تراجع عن موقفه بالنسبة لدور المثقفين، حين قال عام 1968 في مقابلة أُجريت معه "إن المثقف في جوهره برجوازي صغير، فمجرد ما يفتح فمه لكي يتكلم، تنطق أيديولوجيا البرجوازية الصغيرة، لذلك من الصعب جداً أن يتحول المثقف إلى ثوري، إلى ماركسي لينيني، فعليه أن يعاني ثورة فكرية جوانية لكي يصبح كذلك، لأن غرائزه برجوازية صغيرة بعكس العامل، الذي يتمتع بغرائز ثورية تمكنه إذا فكر واجتهد أن يُعَبِّر بِيُسْر نسبي عن المواقف الثورية، إلى الماركسية اللينينية، وعاد ألتوسير ليؤكد هذه الرؤية في كتابه "لينين والفلسفة ومقالات أخرى". ما زال لوي ألتوسير راهناً ومهماً"([26]).
يرى التوسير كذلك، أن الفلسفة الماركسية هي السلاح الثوري الذي لا بد للمثقفين الثوريين من أن يستخدموه في إفهام الطبقة الكادحة مقولات هذه الفلسفة، وإطلاعها على طريقة استخدام ماركس وأنغلز لها، ثم على الطريقة التي تستخدم هي ذاتها أدواتها في الظروف الطارئة في الحاضر والمستقبل من أجل نجاح ثورتها.
فالفلسفة في رأيه هي في النهاية الصورة النظرية لصراع الطبقات، والماركسي الصحيح هو الذي يضع نفسه في إطار الماركسية التاريخي الدقيق انطلاقاً من موقف معين في مكان وزمان معينين، كأن ينظر إلى أزمة الرأسمالية من حيث ارتباطها بأزمة الماركسية([27]).
لقد تركت آراء ألتوسير في الشبيبة الطالبية، أثراً لا ينكر، تَمَثَّل في الموقف النقدي الذي وقفته حركة أيار 1968 من قيادة الحزب الشيوعي المتهمة بـ "التحريفية" لتخليها عن مبدأ دكتاتورية البروليتاريا، وهو موقف جديد يعتقد ألتوسير أنه من الصعب إيجاد تبرير نظري له في الماركسية.
وبالمقابل، فإن نقاد ألتوسير رموه بتهمة الستالينية، والواقع –كما يقول جورج طرابيشي- أنه بقدر ما يبدو ألتوسير مجدداً في المنهج يبدو " قويم العقيدة" في الآراء.
أما أرنست ماندل، فيقول " إن ضعف ألتوسير الأساسي يكمن في رفضه التمييز بين المنهجين الجدليين، المثالي والمادي، وفي شكوكه حيال الجدل المادي باعتباره جدلاً "هيغلياً"، وفي رفضه الفعلي لكل الجدل لهذه الأسباب"([28]).
أما المفكر د. صادق جلال العظم، فقد انتقد ألتوسير بحدة، بل شن عليه هجوماً شرساً في كتابه "دفاعاً عن المادية والتاريخ" كما يقول المفكر د. هشام غصيب الذي رأى إن هجوم صادق العظم افتقر كلياً إلى روح الانصاف الموضوعي، خاصة وأن صادق العظم يقول في نقده لألتوسير: "في مؤلفاته كلها، حين يهاجم ألتوسير الماركسية الهيغلية وينتقدها، فإنه لا يؤكد أبداً مادية الماركسية في مواجهتها، بل يؤكد دوماً علميتها فقط بعد أن يكون قد فسر ضمناً معنى العلمية تفسيراً شكلانياً مثالياً معادياً للمادية، وبالتالي فإن الهدف الحقيقي من هجوم ألتوسير المستمر والمتكرر على مثالية هيجل الموضوعية، هو النيل من مادية ماركس الموضوعية، لأن الهدم المباشر للأخيرة صعب دون الظهور بمظهر الخارج كلياً عن إطار الماركسية عموماً والمادية التاريخية تحديداً، لهذا يركز ألتوسير نقده الهدام على:
- الإرث الذي تركته المثالية الموضوعية للماركسية.
- استعارة ماركس الشهيرة والقائلة، بأنه وَجَدَ مثالية هيجل الموضوعية واقفة على رأسها فأوقفها على قدميها.
- دعوى ماركس بأنه استخلص من القشرة الصوفية للمثالية الهيغلية قلبها الديالكيكي".
وتعليقاً على نقد د. العظم، يدافع د. هشام غصيب عن ألتوسير بقوله "برغم ما يشوب الألتوسيرية من ثغرات في هذه المسألة، وفي مقدمتها مفهوم القطع الإبستمولوجي، إلا اني أرى في هجوم العظم في الفقرة المقتبسة أعلاه تجنياً واضحاً على ألتوسير، لا بل تزويراً جلياً لموقف ألتوسير يثير حيرتنا بالنظر إلى ما نعرفه عن صادق جلال العظم من صدق وعمق ودقة في قراءة غيره"([29]).
لذلك –كما يستطرد د. هشام– "نجد مستغرباً زعم العظم بان ألتوسير، حين يهاجم الماركسية الهيغلية وينتقدها، لا يؤكد أبداً مادية الماركسية في مواجهتها، إننا نجد ذلك مستغرباً بالفعل، لأن مفهوم التحديد الفائق ابتكره ألتوسير خصيصاً لكي يؤكد مادية الماركسية في مواجهة الهيغلية في صورها كافة، بل، إن مأخذنا على ألتوسير أنه يغالي في توكيده هذا، بحيث إنه يريد تطهير الماركسية من كل أثر للمثالية الهيغلية، إنه يغالي في توكيد اختلاف الجدل المادي عن الجدل الهيغلي بحيث إنه يريد توكيد انعدام الصلة كلياً بين الجدلين، فهو إذاً لا يجابه الجدل الهيغلي بعلمية الماركسية، كما يزعم العظم، وإنما يجابهه بمادية الماركسية إلى حد المغالاة"([30]).
لقد أدرك ألتوسير جيداً –كما يضيف د. هشام- "أن المفهومات القائمة في المادية التاريخية والمادية الجدلية في صورتها التقليدية لا تكفي لتحقيق ذلك، لاختلاف موضوعها، ومن ثم، أدرك الحاجة إلى ابتكار مفهومات جديدة لإنتاج معرفة فلسفية بصدد الجدل المادي بوصفه موضوعاً. فقد أدرك أن كون الجدل المادي موضوعاً جديداً، يقضي بابتكار مفهومات جديدة لاستيعابه، وأن استعماله بوصفه أداة معرفية لاستنطاق غيره لا يكفي، هذا هو أحد الدروس المهمة التي نستخلصها من ألتوسير، إذا نظرنا إلى فكره نظرة نقدية، لكن موضوعية، وإذا لم نجعل من بعض هفواته حاجزاً يمنعنا من التواصل مع دوره"([31]).
" لقد سعى ألتوسير منذ الخمسينيات إلى إحياء الماركسية اللينينية، في حقيقتها المادية الجدلية في الأوساط اليسارية، لإنقاذ الأخيرة من جهة، ولشحن الحركة العمالية، والحركة التحررية العالمية بروح تغييرية جديدة تواصل المسيرة الكبرى التي بدأها ماركس ولينين من جهة أخرى، إذ شعر أن لا خلاص للحركة الشيوعية العالمية إلا بمثل هذا التجديد، فهذه الحركة إما أن تكون ثورية، إما أن تكون مادية جدلية، وإما ألا تكون"([32]).
من المؤلفات التي أصدرها ألتوسير لاحقاً، قبل أن يصاب في مطلع الثمانينات بنوبة جنون، كتاب "لينين والفلسفة" (1969) و"رد على جون لويس" (1973)، و"عناصر لنقد ذاتي" (1974).
وأخيراً، ومهما قيل في ألتوسير، "فإنه يبقى في تاريخ الفكر الفرنسي والأوروبي ذاك الذي أثار من حول كتاباته عاصفة من الردود والردود المضادة لا تجد نظيراً لها إلا في العاصفة النظرية التي أثارتها الوجودية غداة الحرب العالمية الثانية"([33]).
وفاته:
في سنة 1980 دخل ألتوسير داراً لرعاية المسنين بعد أن إتُّهِمَ بقتل زوجته، وأُسْقِطَت التهمة عنه لعدم ثبوت التقصد سنة 1981، ثم توفي منتحراً في إيفلين فرنسا عام 1990.
قالوا عنه([34]):
- " إن ضعف ألتوسير الأساسي يكمن في رفضه التمييز بين المنهجين الجدليين، المثالي والمادي، وفي شكوكه حيال الجدل المادي باعتباره جدلاً "هيغلياً"، وفي رفضه الفعلي لكل الجدل لهذه الأسباب". (إرنست ماندل).
- هل قرأ ألتوسير الرأسمال حقاً ؟ إنه يُعْمِلْ التأمل في مفهوم القراءة بصدد الرأسمال. ولو قرأ الرأسمال حقاً لاكتشف أن نص ماركس لا يعرض نفسه على أنه رسالة تتطلب من يفك لغزها، بل على أنه فك للغز نص هيروغليفي: عالم البضاعة". (هنري لوفيفر).
- " إذا كان في مستطاع البنيويين أن يستخدموا ألتوسير، فلأن لديه تصميماً على إعطاء الامتياز للبنى على حساب التاريخ "(جان بول سارتر ).
([1]) سامى خشبة – مرجع سبق ذكره - مفكرون من عصرنا – ص 77+78
([2]) جورج طرابيشي – مرجع سبق ذكره –معجم الفلاسفة – ص 9
([3]) المرجع نفسه –ص 10
([4])سامى خشبة – مرجع سبق ذكره - مفكرون من عصرنا – ص 77+78
([5]) غنارسكيربك و نلز غيلجي – مرجع سبق ذكره – تاريخ الفكر الغربي - ص 919
([6]) المرجع نفسه - ص 921
([7]) م. روزنتال ، ب. يودين - مرجع سبق ذكره - الموسوعة الفلسفية – ص387
([8]) جورج طرابيشي – مرجع سبق ذكره – معجم الفلاسفة – ص 512
([9]) م. روزنتال ، ب. يودين - مرجع سبق ذكره - الموسوعة الفلسفية – ص387
([10]) جورج طرابيشي – مرجع سبق ذكره – معجم الفلاسفة –ص 338
([11]) هاشم صالح – بصمات الفلسفة الفرنسية على القرن العشرين – الانترنت – 8 ديسمبر 2013.
([12]) حسام الدين درويش – فلسفة بول ريكور وعلاقتها بالدين والعلم – الانترنت – 8 ديسمبر 2013.
([13]) أ. روني إيلي ألفا - موسوعة أعلام الفلسفة - الجزء الأول – دار الكتب العلمية – بيروت – ط1 – 1992 – ص152.
([14]) جورج طرابيشي – مرجع سبق ذكره – معجم الفلاسفة – ص 126
([15]) م. روزنتال ، ب. يودين - مرجع سبق ذكره - الموسوعة الفلسفية – ص387
([16]) موقع ويكيبيديا – الانترنت.
([17]) موقع: المعرفة - www.marefa.org .
([18])سامى خشبة – مرجع سبق ذكره - مفكرون من عصرنا – ص 85 - 86
([19]) موقع: المعرفة - www.marefa.org .
([20]) جورج طرابيشي - معجم الفلاسفة – دار الطليعة – بيروت – ط2 - ديسمبر 1997–– ص88
([21])د. صادق جلال العظم – دفاعاً عن المادية والتاريخ – دار الفكر الجديد – بيروت – الطبعة الأولى 1990 –ص 363
([22]) المرجع نفسه –ص 385
([23]) المرجع نفسه –ص 389
([24]) المرجع نفسه – ص 454
([25]) موقع: المعرفة - www.marefa.org .
([26]) د. هشام غصيب – الفيس بوك – 29/5/2019.
([27]) موقع: المعرفة - www.marefa.org .
([28])جورج طرابيشي- مرجع سبق ذكره - معجم الفلاسفة – ص88
([29]) د.هشام غصيب – نقد العقل الجدلي – دار التنوير – بيروت – 2011 – ص50
([30]) المرجع نفسه - ص51
([31]) المرجع نفسه– ص52
([32]) المرجع نفسه – ص57
([33]) جورج طرابيشي - مرجع سبق ذكره - معجم الفلاسفة – ص88
([34]) المرجع نفسه – ص 88