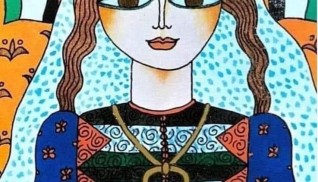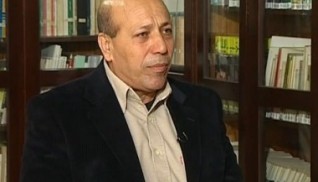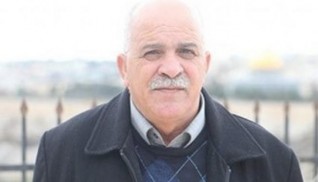مثّلت الدولةُ العثمانيّةُ حتى أواخرِ القرن التاسع عشر، الفكرةَ الجامعةَ والمواطنةَ الوحيدةَ لأهلِ بلادِنا، فقد رأوا فيها امتدادًا لدولةِ الخلافةِ الشرعيّة، في حين لم تكن محاولاتُ فخر الدين المعني في جبل لبنان أو الشيخ ظاهر العمر في الجليل، إلّا من داخل الجدارِ العثماني، ولم تكن في حقيقتِها محاولاتِ استقلال، وإنّما اعتراضٌ على ظلمِ الولاةِ وتجبرهم، أو على سياساتِ الضرائب، أو تنافسٌ على أحقيّة جبايتها، إلّا أن أخذت الفكرةُ القوميّةُ بالظهور في الهزيع الأخير من القرن التاسع عشر. قبلَ ذلك بقرنٍ من الزمن، احتلّ نابليون مصر، في محاولةٍ لإعادةِ اكتشافِ الشرق، في حين كان العالمُ لم يزل منخرطًا في اكتشافِ عوالمَ جديدةٍ أكثرَ من اهتمامِهِ بالعالم القديم، ودخلت مع نابليون لمصر قيمُ الثورة الفرنسيّة ومفاهيمُ الحداثة، الأمرُ الذي التقطه محمد علي باشا وأعجب به، فكانت البعثاتُ إلى فرنسا وإيطاليا في سائر مجالات العلم والمعرفة، وأدّت إلى تحديث مصر صناعيًّا وزراعيًّا ومعرفيًّا، ولعلَّ تجرِبةَ محمد علي هذه، هي الأكثرُ جديّةً وعمقًا، كونها اعتمدت الحداثةَ و قيمَها، إلّا أنّها بقيت نظريًّا ملتزمةً بالبقاء داخلَ الحظيرة العثمانيّة ولو من حيث الشكل. هذا في حين كانت الدولةُ العثمانيّةُ تتآكلُ من داخلها فسادًا و تخلّفًا، ومن خارجها بقضم أطرافها وهزائمها المتكرّرة؛ الأمرُ الذي زعزع اليقينَ بمشروعيّتها الدينيّة، وقدرتها على مواجهة أعدائها؛ الأمرُ الذي منح محمد علي السببَ غيرَ المبرّر للانتفاض عليها، وأطلق عليها الأوروبيّون في حينه لقب (الرجل المريض)، وقد وجدت الدولُ الأوروبيّةُ ضرورةَ إطالة عمر هذا المريض إلى حين تأتي اللحظةُ المناسبةُ لوراثته، وذلك بتقاسم الجثّة، وبتقطيع أوصالها، ومن هنا بدأت أفكارُ التجزئة والتفتيت، التي اشتغلوا عليها واقعيًّا بإيجاد موطئ قدمٍ لكلٍّ منهم عبرَ الطوائف والإثنيّات برعاية القناصل ذوي الصلاحيّات الواسعة، فأصبح الإنجليزُ حماةَ الدروز، والفرنسيّون حماةَ الموارنة والكاثوليك، والروسُ حماةَ الأرثودوكس، والألمانُ حماةَ الأكراد، وأخذت كلُّ قنصليّةٍ تُراكمُ النقاطَ بانتظار اللحظة التي يتقرّر بها إماتة الرجل المريض. ومن الجدير ملاحظتُهُ أنّ هؤلاءِ القناصل تمتّعوا بصلاحيّاتٍ استثنائيّة، فقد كان كلٌّ منهم مرتبطًا مباشرةً بوزارةِ خارجيّة بلده لا بالسفير في إستنبول، ويمكن ملاحظةُ كثيرٍ من ذلك في مذكّرات مستر فن القنصل الإنجليزي ب القدس في منتصف القرن التاسع عشر.
حفرُ قناةِ السويس الذي بدأ مشروعًا مصريًّا – فرنسيًّا، الذي مثّل امتدادًا غيرَ مباشرٍ لحملة نابليون، جعل من الطرقِ أقصرَ ما بين أوروبا والشرق البعيد المستعمرّ في غالبه من الإنجليز والهولنديّين؛ الأمرُ الذي أقلقهما من سيطرةِ الفرنسيّين على هذا الممرّ الحيويّ، فكان لا بدَ من العمل على طرد الفرنسيّين ثمّ الاستيلاء على مصر بعد إغراقها بالاستدانة؛ تمهيدًا لاحتلالها. وهذا ما تمَّ عامَ 1888، كما ظهرت في التوقيت ذاته فكرةُ إقامةِ كيانٍ غريبٍ معادٍ للمنطقة شرق قناة السويس لحمايتها، ثم لمنع التواصل مستقبلًا بين الهلال الخصيب ووادي النيل، انطلق من هنا التفكيرُ بإقامة دولةٍ يهوديّة، وكان من لزوم ذلك إحياءُ بعض جوانب الفكر البروتستانتي المتعلّق بنهاية العالم، وظهور المخلّص وارتباطها بعودة اليهود إلى أرض ميعادهم، وأُسّس للغرض ذاته صندوقُ إعادة اكتشاف فلسطين بميزانيّةٍ ضخمة، واجتذب إليه المغامرون والمستشرقون والإنجيليّون وغيرهم، وكان من هؤلاء اللورد كتشنر واللورد كيرزون ولورنس العرب والمستر بيل وجون فيلبي وكثيرون غيرهم... ممّن توافدوا لبلادنا لدراسةِ أحوالها؛ وذلك بحجّةِ رسمِ خرائطِ المنطقةِ وَفْقًا للأحداث التوراتيّة، فيما كان الهدفُ الحقيقيُّ منصبًّا على كيفيّة استعمار بلادنا و تقسيمها.
مع انطلاقِ شرارةِ الحربِ العالميّةِ الأولى، كان القرارُ الاستعماري قد اتّخذ برفع أجهزة التنفس الصناعي عن الرجل المريض؛ إذ آنَ الأوانُ لموتِهِ وتقطيع جثّته، فكان اتّفاق سايكس - بيكو، وملحقاته في سان ريمو وسيفر ولوزان، حيث اعتمد الجاني الفرنسي جبل لبنان وجواره، حيث استثماره في الموارنة، واعتمد الإنجليز مصادرَ البترول وطريقها للمتوسّط، واعتمد وضعًا غامضًا لفلسطين الكبرى الشاملة للأردن وفلسطين حاليًّا (بانتظار صدور وعد بلفور)، ومن الجديرِ ذكرُهُ أنّ خطوطَ التقسيمِ تلك خطّت بقلم رصاص، حيث أنّها عرضةٌ للإزاحةِ والتغييرِ وَفْقَ مصالح الأطراف وميزان القوى بينهم، فالموصلُ التي كانت من حصّة فرنسا عادت إنجليزيّة، وكذلك حوران وجبل العرب (جبل الدروز) الذي كان إنجليزيًّا عاد ليصبحَ من حصّة فرنسا، إلّا أنّ الاستعمارَ والتجزئةَ ما لبث أن أصبحَ قرارًا أمميًّا، في مؤتمر فيرساي، الذي رأى أنّ أمّتنا لا تزال قاصرةً ثقافيًّا واجتماعيًّا و سياسيًّا، عن حكم نفسها بنفسها، لذلك لا بدّ من وجود وصيٍّ عليها يعلّمها ويثقّفها ويؤهّلها لأنْ تحكمَ نفسها بنفسها ذات يوم، وهو الأمرُ الذي أخذ مشروعيّته الأمميّة عن تأسيس عصبة الأمم، التي أقرّت نظامَ الانتداب والوصاية، وأصبحت الدولُ المستعمرّةُ المحتلّةُ لبلادنا تحملُ أسماء أكثرَ لباقة؛ انتداب ووصاية، وهي بالطبع أدرى من أهل البلد بكيفيّة تشكيلها داخليًّا، ثمّ رسم حدودِها خارجيًّا.
خلق الاستعمارُ – الانتداب وفرض واقعًا جديدًا؛ وذلك بتكبير جبل لبنان وفصله عن سوريا، وخلق طبقةٍ مستفيدةٍ من هذا الواقع – واقع التجزئة، بحيث تكونُ الوحدةُ متعارضةً مع مصالحها المنفعيّة الصغيرة، وكذلك فعل في العراق إذ أذكى جذوةَ الإثنيّة والطائفيّة ما بين سنةٍ وشيعة، ومندائيّين وآشوريّين، وما بين عربٍ وكرد؛ الأمرُ الذي نرى ثمارَهُ في عراق اليوم بعد قرن ونيّف، وكذلك فعل في فلسطين التي خلق بها غرب النهر، دولةً معاديةً، عدوانيّةً، مسلّحةً، فيما خلق إلى الشرق من النهر دولةً ريعيّةً، وخلق بها طبقةً مستفيدةً من ضياع فلسطين، بغضّ النظر عن منابتها وأصولها.
كانت المرحلةُ الثانيةُ - إذًا - من تكريس التجزئة هي بتقسيمِ الجسدِ القوميّ إلى أوطانٍ على أسسٍ طائفيّةٍ أو إثنيّة، أو حتّى عرقيّة مزعومة، لكي تبقى على حالها من الضعف والهوان، ولتبقى الدولة اليهوديّة (إسرائيل) الأقوى في مجموعة الدول العرقيّة والطائفيّة، فتمَّ خلقُ الهُويّات الفرعيّة على حساب الهُويّة القوميّة الجامعة: الموارنةُ هم أحفادُ الفينيقيين، وأهلُ فلسطين الانتدابيّة هم أحفادُ شعوب البلست القادمين من البحر – والمتمايزين عرقيًّا عن الشعوب السامية الآتية من جنوب غرب جزيرة العرب (وهي مدرسةٌ في التفكير الفلسطينيّ)، ولا بدَّ من إقامةِ دولةٍ للعلويّين في شمال غرب سوريا وأخرى للأكراد إلى الشرق منها وصولًا إلى شمال العراق، ودولةٍ درزيّةٍ في حوران وجبل الدروز تمتدُّ إلى البقاع والجنوب اللبناني وبعض مناطق الجبل، والنخب المشوّهة تعملُ بجدٍ ونشاطٍ في خدمة ذلك. مارست السياسةُ الإنجليزيّةُ سابقًا الدورَ الذي مارسته السياسةُ الأمريكيّةُ حاليًّا، وكلتاهما تسيرُ على الخطى ذاتها في الجوهر، وإن اختلف الشكل، فمع انتهاءِ الحرب العالميّة الثانية، اقترح الإنجليزُ على حزب الوفد الموالي لهم فكرةَ إنشاء جامعة الدول العربيّة، لتنسيق السياسات الاقتصاديّة أوّلًا والسياسات العامّة ثانيًّا، مقابلَ إغراءِ أن تكونَ مصرُ قائدةَ المشروع، وهدف هذا المشروع كما يرد بشكلٍ واضحٍ في أهدافِهِ المعلنة، الحفاظ على حدود الدول القائمة الأعضاء واحترام سيادتها، ومن ثَمَّ فقد كان مشروعُ جامعة الدول العربيّة، مخصّصًا لتكريس حالة التجزئة والانقسام، وهو أمرٌ قد أخذ يتّضح من الحربِ الأمريكيّةِ على العراق، وازداد بشاعةً مع الربيع العربي الزائف الذي شرعنت به هذه الجامعة تدميرَ ليبيا وسوريا وتآمرت على اليمن.
مشكلتُنا تكمن في فشل الدولة الوطنيّة في أيّ إنجاز، فلم تحقّق الوحدة ولا الحريّة والديمقراطيّة، لم تصنع تنميةً أو رخاء، لم تحرّر فلسطين، ولم تدرك معاني الأمن القوميّ أو المصالح العليا، فقد فشلت في كلّ أهدافها، إلا تحقيق أمن الحاكم والطبقة المتنفّذة ومصالحهم.
اليوم نرى أنّ التجزئةَ التي كانت مطلبًا استعماريًّا قبلَ قرنٍ من الزمن – وما تزال، إلّا أنّها أصبحت مطلبًا محليًّا عند هؤلاءِ الحكام ومن يواليهم، ويدعمهم جماعاتٌ ثقافيّةٌ مشوّهةٌ منها منظّماتٌ غيرُ حكوميّة، تبشّرُ بالثقافة والأفكار النيو- ليبراليّة، التي تجعلُ لكلّ شيءٍ قيمتَهُ المادية، الماليّة النقديّة، بعيدًا عن أيّة قيمةٍ قوميّةٍ أو وطنيّةٍ أو أخلاقيّة، مثالٌ فاضحٌ على ذلك ما نراهُ اليوم في اتّفاقيّات الطاقة الكهربائيّة، وصفقات المياه بين الدولة الأقوى والمركزيّة (إسرائيل) ودول التجزئة والانقسام !