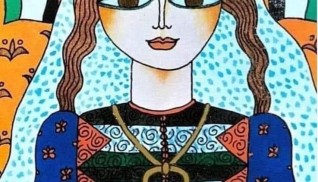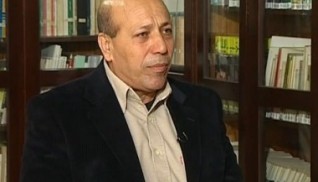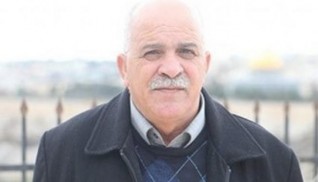يستحسنُ عدمُ المجازفةِ بممارسةِ التعميمِ الشاملِ خلالَ المرحلةِ الأولى من اندلاعِ الحربِ الروسيّة – الأوكرانيّة... ومع ذلك لا يمكن سوى النظر بتشاؤمٍ واقعيٍّ إلى الدور القياديّ العالميّ الذي تتوّلاه الولايات المتّحدة الأمريكيّة على نحوٍ خاصٍّ في العقدين المنصرمين من القرن الواحد والعشرين، وهنا يصحُّ القولُ: إنّ العلاقات الدوليّة - على جميع المستويات – هي الآن في حقبةٍ جديدةٍ من "الأزمة العدوانيّة". وهذا الوضعُ لا يؤشّرُ فقط إلى نهايةٍ مشؤومةٍ لما يُعرف باسم "السلام الأمريكيّ العالميّ"، بل يطرح أيضًا تحدّيًا أكبرَ بمحتواه ومضمونه: تآكل نظامٍ عالميٍّ ليبراليٍّ تحكمه أنظمةٌ وضوابطُ محدّدة...!
يواجهُ "السلام العالميّ" مخاطرَ ناجمةً عن التحوّل في مركز القوّة العالميّة الاقتصاديّة والجيوسياسيّة من العالم الغربيّ الأطلسي إلى آسيا، وهذا الوضعُ الجديدُ هو تحوّلٌ نمطيٌّ يؤشّرُ إلى نهاية ثلاثة قرونٍ من الهيمنة الغربيّة على العالم، ويفسّر صعود آسيا، في ظلّ هذا الوضع، فإنّ ما نشهده - وإن لم يكن سقوطًا للولايات المتحدة - هو تراجعها النسبيّ مقارنةً بالقوى الاقتصاديّة والعسكريّة الجديدة؛ فإلى جانب عودة ظهور روسيا عالميًّا، فإنّ صعود آسيا يشكّلُ تحدّيًا كبيرًا للتفوّق الاقتصاديّ والعسكريّ الأمريكيّ، لذلك فإنّ أفول عصر "السلام العالمي" ينبغي عدم ردّه إلى الحرب المشتعلة اليوم في شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا فحسب بقدر ما يتعيّن فهمه بفعل تحوّلات التاريخ الكبرى؛ أي التراجع النسبيّ للقوّة الأمريكيّة، وبروز الصين الصاعدة... وفي هذا السياق أعلن الرئيسُ الصيني "شي جين بينغ" أمامَ المنتدى الاقتصاديّ العالميّ في دافوس بسويسرا عام 2020: "إنّ الصين مستعدّةٌ لقيادة النظام العالميّ إذا لم تفعل الولايات المتّحدة ذلك".
الدورُ الروسيّ:
قبل أن تدخلَ روسيا الحربَ مع أوكرانيا؛ أنهى الرئيسُ بوتين عقودًا من الغياب الروسي عن خريطة العالم، وبنى موقعًا أقوى ممّا كان يحظى به الاتّحاد السوفياتي قبل أربعين عامًا، ليس سرًّا: كيف فعل بوتين ذلك؟!
فهو يعرفُ كيفَ يجمعُ بين الدبلوماسيّة والقوّة العسكريّة، كما أنّه منذ تدخّله في سوريّة، أقام علاقاتٍ فاعلةً مع القوى الإقليميّة الشرق أوسطيّة بما في ذلك إسرائيل و مصر والسعوديّة وإيران وتركيا، على الرغم من أنّ بعضها يعارضُ بشدّةٍ ما يفعله بوتين اليوم في أوكرانيا... لقد أبرمت موسكو صفقاتٍ ناجحةً مع السعوديّة لدعم أسعار النفط والغاز الدوليّة، وعلاقة موسكو بـ "إسرائيل" لم تكن أقربَ وأكثرَ توطّدًا ممّا هي عليه الآن، بالرغم من أنّ روسيا عزّزت الوجودَ الإيرانيّ في سوريّة بشكلٍ كبير.
لقد تجاوزُ الرئيسُ الروسيّ بوتين والرئيس التركي أردوغان التوتّر الناجم عن اقتتال الفصائل والميليشيات المتعارضة في سوريّة والعراق و ليبيا واليمن ولبنان، وعن عضويّة تركيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" واستطاعا التوصّل إلى اتّفاقٍ يقضي بشراء أنقرة صواريخَ الدفاع الجوي الروسيّة و"مُفاعِلًا نوويًّا روسيًّا"... أمّا الرئيس المصري السيسي فهو على غرار رئيس الحكومة "الإسرائيلي" الحالي نفتالي بينت، قام بزياراتٍ عدّةٍ لموسكو، ووقّعت مصرُ وروسيا مُسوَّدَةَ اتفاقيّةٍ تسمح لموسكو بعبور المجال الجويّ المصري، كما أنّ موسكو وافقت على بيع مصر نظامَ الصواريخ المتطوّر الذي اشترته تركيا، وعلى بناء أوّل مُفاعلٍ نوويٍّ في مصر، علاوةً على التفاهمات مع "إسرائيل" حولَ مشروعيّة هجماتها على القواعد والمواقع التي "تهدّد أمنها" من الأراضي السوريّة والفلسطينيّة.
من هنا إلى أين؟!
من ينظرُ إلى المشهد الدوليّ يلاحظُ هذه الصورةَ الضبابيّة:
- نجحت روسيا الاتّحاديّة في النهوض من تحت أنقاض الاتّحاد السوفياتي، وشرعت تستعيدُ دورَها متحرّرةً من تلك الضمانات والقيود الأيديولوجيّة التي كانت تلتزم بها في حقبة الحرب الباردة.
- أمّا منظومةُ الاتّحاد الأوروبيّ التي حاولت أن تؤدّي دورَ البديل المفترض لانكسار معادلة "توازن القوّة" في تسعينيات القرن الماضي، باتت مهدّدةً بالانفراط بعد أن أخفقت بتكوين صورةٍ معقولةٍ توفّر الاطمئنانَ للقوى الصاعدة في العالم.
- بينما بدأت الولاياتُ المتّحدةُ الأمريكيّةُ بالتراجع بعد أن فقدت كثيرًا من اعتباراتها الخاصّة، ولم تعد تمتلك تلك القدرات التي كانت تعطيها سابقًا؛ تلك المؤهّلات التي تخوّلها القيامَ بدورها في ضبط إيقاع السياسات الدوليّة!
أمامَ هذهِ الفوضى الدوليّة الثلاثيّة الأبعاد، باتت الاحتمالاتُ مفتوحةً على مزيدٍ من الحروب الإقليميّة وعدم الاستقرار... فالفوضى تبدأُ بغياب القانون، وعدم احترام قرارات المرجعيّة الدوليّة، والمبالغة في الاعتماد على القوّة، والإفراط في اللجوء إلى حقّ النقض "الفيتو" في الأمم المتّحدة، واستخدام التضليل والذرائع التي تجيز الامتناع عن القَبول بالحدّ المعقول "لتوازن المصالح"؛ وذلك لأهدافٍ وغاياتٍ تؤذي الأطراف الأخرى.
تبدأ الفوضى والحرب عادةً من الأعلى "الفوق" ثمّ تأخذ بالهبوط إلى "الأدنى" فالأدنى، وصولًا إلى "قانون الطبيعة" شريعة الغاب الذي حذّر المفكرون من العودة إليه؛ لأنّه يفسح المجال لسياسة "الحرب الدائمة"...!
إنّ عدمَ احترام القوى الكبرى للمرجعيّة الدوليّة يعني - عمليًّا - دفعَ مختلِف الأطراف إلى تجاوز السقف القانوني الضامن لتوازن المصالح، والانخراط الدائم في حروبٍ عبثيّةٍ لا تستقرّ إلا بعد تغيير الخرائط الديمغرافيّة، وتشكيل "خرائط" تخضع ألوانها لمنطق قانون القوّة الغاشمة، فماذا يعني ذلك؟!
باختصارٍ؛ إنّه بدايةُ ارتدادٍ من طور حكم القانون إلى طور العودة إلى حكم الطبيعة أو غير القانون، مثلما أشار مرارًا المفكّر توماس هوبز: "قانون الطبيعة هو قانون التوحّش وحرب الجميع على الجميع وضدّ الجميع"، بسبب انعدام المسؤوليّة وعدم وجود مرجعيّة عليا تضبط انجرار الحشود نحو الدفاع عن مصالحها دون ضوابطَ سياسيّةٍ مدنيّةٍ تهذّب الطموحات، وتضعها في إطارٍ يحترم توازن المصالح.
تبدأ الفوضى والحرب عندما تصبحُ المرجعيّة الدوليّة لا وظيفة قانونيّة لها سوى إصدارِ الإداناتِ والبيانات دون قدرةٍ على التوصّل إلى صيغة قرارٍ مُلزم، وهو ما يؤدّي إلى التراجع ثمّ التراجع إلى أن تفقد الدول حاجتها إليها، وحين تفقد الأمم المتّحدة مكانتها وتخسر دورها، تخرج "اللعبة الدوليّة" عن قواعدها السياسيّة، وتنزلق القوى الكبرى تجاهَ اعتماد منطق القوّة الغاشمة لتعديل الموازين، وكسر الحقوق وتحطيم العدالة... وحين تعجز الشعوب التي تطالب بالحريّة والتنمية والعدالة والديمقراطيّة وتداول السلطة عن نيلها أو إنجازها في إطار القانون المدني؛ يصبح الخروج على الدبلوماسيّة واللجوء إلى العنف، هما القانون الطبيعي البديل الذي تضطر إلى اعتماده تحاشيًا للانزلاق نحو الأسوأ، هذا هو الحاصل العام الذي وصلت إليه شعوب العالم في العقود الثلاثة الأخيرة، أي منذ سنة 1991 حتى يومنا هذا، عندما اعتمدت الدول على قوى خارجيّةٍ لإعادة إنتاج موازين القوى الداخليّة في إطار لحظة انهيار الحرب الباردة، وتنمّر الولايات المتّحدة الأمريكيّة في سياساتها الدوليّة.
ثمنُ الانتقال من الأحاديّة إلى التعدديّة:
في هذهِ الحالة تصبح السلطة بوصفها التكثيفَ السياسيَّ لتناقضات الواقع، هي الطرفُ الأكثرُ استعدادًا للانهيار حين تبلغ الأزمة طور الانفجار، لذلك يرجّح أن تتواصل عمليّات التفكّك في بلدان وأقاليم العالم التي تفتقر إلى إمكانيّات التكيّف مع التحوّلات الدوليّة، وما تفرزه من انقساماتٍ قطبيّةٍ بدأت تنتقلُ من الأحاديّة إلى التعدديّة، فالعالمُ الذي يعاني - الآن - إرهاصات التخبّط السياسيّ والحروب بالوكالة بسبب سرعة وتيرة المتغيّرات، يحتاجُ إلى فترةٍ زمنيّةٍ كي يستقرَّ على "خريطة" أخذت تتشكّل معالمها، لكنّها كما يبدو ستكون مغايرةً عن تلك التي تبلورت هويّتها بعد تلاشي حقبة الثنائيّة والأحاديّة.
لا شكَّ في أنّ تعدّد النماذج أفضل من الثنائيّة والأحاديّة، لكنّه في النهاية الأكثر صعوبة، وما شاهدناه ونشاهده من تفكّكٍ سياسيّ – أهلي على امتداد المساحات من آسيا الوسطى إلى شرق أوروبا مرورًا بشرق المتوسّط ليس سوى بداية، أمّا النهايةُ فلن تكون واضحةً قبل أن ترتسم صورة المثال "النموذج".
التعدديّةُ القطبيّةُ في خطواتها "التأسيسيّة" وهي في حال فوضى يرجّح أن تأخذ مداها الزمنيّ، قبل أن تستقرّ على نسقٍ عقلانيٍّ وواقعيٍّ يعكس فعليًّا تلك الجدليّة المتبادلة بين واقعٍ مأزومٍ وقوى قمعيّةٍ تكثّف ما تفرزه التناقضات من متغيّراتٍ تتمظهر في كثيرٍ من المحطّات والمفاصل بأشكالٍ عنفيّةٍ لا ضابط لها بسبب غياب "السلطة العليا" وضمور دور الأمم المتّحدة وقراراتها معطوفةً على فراغٍ تشريعيٍّ وقانونيٍّ يعطّل إمكانات المراقبة والمحاسبة.
المرجعيّةُ الدوليّةُ بالرغم ممّا لها وعليها، تبقى أفضل من اضمحلال وظيفتها القانونيّة المدنيّة وما تنتجه من انقساماتٍ تدفع بالعلاقات الدوليّة إلى طورٍ متدنٍّ من الانحطاط المرتكز على جزئياتٍ هي أقربُ إلى "حال التوحّش الطبيعي" في رؤية الإنسان إلى الآخر.
هناك مرحلةٌ انتقاليّةٌ تحتاجها الدول الكبرى كي تتمكّن من استعادة وظيفتها، وذلك ضمنَ تحوّلاتٍ أخذت ترسمُ صورتها مجموعةُ قوى متنافسة على أخذ المبادرة، في ظلّ غياب القانون المدني والمحكمة الدوليّة، وعدم وجود إطارٍ تشريعيٍّ دستوريٍّ للمحاسبة... وهذه المرحلةُ الانتقاليّةُ لا يمكن قياس أو تحديد فترتها الزمنيّة قبل أن تتوضّح معالم الطريق وهويّته الأيديولوجيّة والجيوسياسيّة، من الصين إلى الولايات المتّحدة مرورًا بشرق المتوسط وأوروبا.