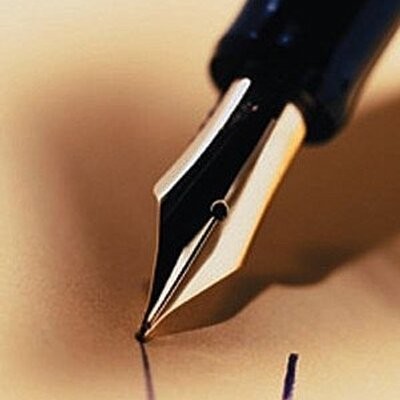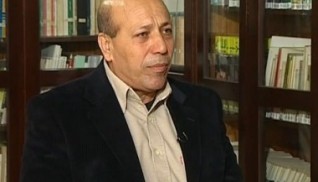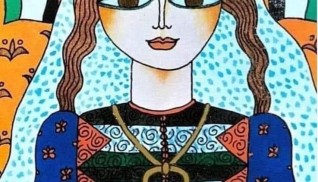إنّ الحديثَ عن المسالةِ القوميّةِ يدفعنا إلى طرح الإشكاليّة التالية:
القوميّةُ بين التحوّلِ المتسارعِ الذي يعرفُهُ العالمُ على المستوى الاستراتيجيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ والسياسيّ والتكنولوجيّ وبين الانغلاقِ على الذات..
ولتحليلِ هذهِ الإشكاليّةِ لا بدَّ من طرح الأسئلة التالية: أي مفهوم للقوميّة؟ هل القوميّةُ كانت سبيلًا لتحدي الاستعمار والعولمة؟ هل القوميّةُ كانت خيارًا استراتيجيًّا أم إفرازًا اجتماعيًّا أو سياسيًّا؟ هل للدولة القوميّة روافدُ تقويها؟
1 ـ على مستوى مفاهيم القوميّة
هناك عدّةُ أبحاثٍ واجتهاداتٍ لتحديد مفهوم القوميّة، ويمكن أن نأخذَ منها ما يلي: القوميّة (Nationalisme ) هي كيانٌ سياسيٌّ واجتماعيٌّ واقتصاديٌّ له خصوصيّةٌ معيّنةٌ تتميّزُ بمصالح الجماعة/ الأمة من حيث الحفاظ على السيادة الكاملة على وحدة التراب أي الحكم الذاتي، على اعتبار أن المذهب السياسي يرى أنّه على الأمّة أن تحكم نفسها بنفسها دون أيّ تدخلٍ خارجيٍّ وأن تقرّر مصيرها بنفسها (الحق في تقرير المصير بالمفهوم الحديث). كما يمكن تعريفُ القوميّة على أنّها شكلٌ من أشكال الارتباط بالأرض وبالعادات أو التقاليد وبالآباء والأجداد، وتقديم مصلحة الوطن على المصلحة الشخصيّة. وحسب "كارلتون جاى اتش هايز" (HAYES, CARLTON J.H ) وهو مؤرّخٌ أمريكيٌّ يرى أنَّ القوميّة هي اندماجٌ عاطفيٌّ حديثٌ لظاهرتين قديمتين للغاية؛ هما: الوطنيّة، والتبعيّة لدولةٍ معيّنة".
نماذجُ من القوميّة
- النموذج الأوّل وهو المعروفُ باسم البدائيّة أو المعمرة أي الدائمة أي ما هو مستمرٌ لا يموت، يرى هذا النموذج بأن القوميّة ظاهرةٌ طبيعيّة. ويرى هذا النموذج أنّه على الرغم من أن مفهوم الأمة قد يكون حديث العهد، غير أن الأمم كانت موجودةً دائمًا.
- والنموذج الثاني: هو الإثنوسيمبولية، "'ethnosymbolisme وهو منظورٌ معقّدٌ يسعى إلى تفسير دولةٍ قوميّة، أو هُويّة قوميّة، أو قوميّة إقليميّة، أو قوميّة مدنيّة، أو عرقيّة ويسعى إلى تفسير القوميّة من خلال السياق التاريخي ظاهرةً ديناميّةً وتطوّريّةً نتيجةً لروابط الدولة الذاتيّة بالرموز الوطنيّة المشبّعة بالتطوّر التاريخيّ.
- النموذج الثالث: والأكثر هيمنةً هو الحداثة " le modernisme" الذي يعدُّ بأنّ القوميّة ظاهرةً حديثةً هي حاجةٌ إلى العوامل الهيكليّة للمجتمع الحديث كي ينفتح ويخرج للوجود.
- أما على مستوى المصطلحات اللغويّة فإنّه في قاموس المعجم الوسيط: القوميّة هي الجماعةُ من النَّاس تجمعهم جامعة يقومون لها، جماعة من الناس تربطهم وحدة اللغة والثقافة والمصالح المشتركة، قومية عرقية، قومية ثقافيّة، قوميّة مدنية، قومية أيديولوجية، مدارس اللاسلطوية التي تعترف بالقومية، قومية الوحدة، قومية الاغتراب. ولقد استخدمت كلمة nation «أمة، قوم» في اللغة الإنجليزية قبل عام 1800 وفي أوروبا للإشارة إلى سكان بلد ما وكذلك إلى الهويات الجماعية التي يمكن أن تشمل التاريخ المشترك، والقانون، واللغة، والحقوق السياسية، والدين والتقاليد، بمعنى أنها أقرب إلى المفهوم الحديث لمفهوم الجماعة. أصبح هذا المصطلح سلبيا بشكل متزايد بعد عام 1914 حسب غليندا جليندا آنا سلوجا (مواليد 29 مايو 1962) وهي أستاذةُ التاريخِ الدولي والرأسمالية في معهد الجامعة الأوروبية، في إيطاليا حيث تشغل منصب مدير مجلس البحوث الأوروبية. لم تكن القوميّةُ معروفةً من الناحية النظريّة تاريخيًّا إلا في نهاية القرن الثامن عشر وتطوّرت في القرن التاسع عشر لدرجة إنشاء دولٍ على أساس الهُويّة القوميّة كالقومية العربيّة مثلًا. قبل ولادة عصر القوميّات حيث بنيت الحضارة على أساسٍ دينيٍّ لا قوميّ، وسادت لغاتٌ مركزيّةٌ مناطقَ أوسعَ فكانت الشعوب الأوروبيّة تنضوي تحت الحضارة المسيحيّة الغربيّة وكانت اللغة السائدة في الغرب هي اللغة اللاتينية. بينما سادت في الشرقين الأدنى والأوسط، الحضارة الإسلامية واللغة العربية. ونحو عام 1835ـ تنبه المؤرخون والسياسيون لدلالة القومية في الثقافة الغربية، حيث احتل مفهوم القومية مكانة بارزة في الفكر السياسي والتاريخي والاجتماعي والثقافي. فإن نشأة هذا المفهوم كانت في أوائل القرن التاسع عشر وأن نشأته أتت ضمن ما يسمى "نظريات العقد الاجتماعي"، هذا المفهوم بديلًا عن الانتماء العقائدي الديني بعد كوارث حكم الكنيسة في أوروبا (عصر الوطنية والقومية والشيوعية والعلمانية والليبرالية) كلها انتماءاتٌ وضعيّةٌ لتكون بديلًا عن تلك الانتماءات العقائدية ليتأسس مفهومNationalisme بالإنجليزية والقوميّة بالعربيّة كلاهما حديثان، يعود هذا المصطلح إلى عام 1844، على الرغم من أن هذا المفهوم قديم. أصبح مهما في القرن التاسع عشر. كما أنه أصبح سلبيًّا بشكلٍ متزايدٍ في دلالاته بعد عام 1914. تلاحظ غليندا سلوغا أن «القرن العشرين، كان فترة مخيبة للآمال جدًّا للقوميّة، كان أيضًا العصر العظيم للعولمة».
نشأة القوميّة:
تمَّ إنشاءُ هذا النظام من قبل بعض الأشخاص الذين يعتقدون بأنّ بلادهم أفضل من الآخرين، ويعود ذلك الاعتقاد إلى بعض الجذور العرقيّة لديهم، ويمكن لبعض البلدان إنشاء القوميّة على أسسِ اللغة، أو الدين، أو الثقافة، أو مجموعة من القيم الاجتماعيّة المشتركة، حيث إنّ القوميّين لا ينضمون إلى منظّماتٍ عالميّة، ولا يتعاونون مع دولٍ أخرى، فهم يطالبون بالاستقلال عن الدول الأخرى، ويهدفون إلى إنشاء دولةٍ ذات حكمٍ ذاتيٍّ لتحقيق المصلحة الذاتيّة للأمّة... ويعتقد الأشخاص القوميّون بأنّه يمكن لمصالحهم المشتركة أن تحلَّ محلَّ جميع المصالح الفرديّة أو الجماعيّة للأفراد الآخرين، كما يعتقدون بأن لهم الحق في السيطرة على أمّةٍ أو قومٍ آخر بسبب تفوّقهم عليهم، ويميلون إلى العدوان في بعض الحالات التي تهدّدهم، ويُبدون معارضتهم للعولمة أو الإمبراطورية، ويتظاهرون ضدَّ أي فلسفةٍ في بلادهم، مثل الدين، بينما يتميز الأشخاص الوطنيون بفخرهم ببلدهم ورغبتهم في الدفاع عنه.. أوّل مظهرٍ للقوميّة برز في أمريكا، وكان برفض النظام الحاكم القديم ونقل إلى الشعب، وتحرير الأمة من الاضطهاد والاستبداد داخليًّا وخارجيًّا ولم يكن مجرّد دوافع وطنيّة، وكما قال هانز كوهن في عام 1957م إن القومية لا يمكن تصورها دون وجود السيادة الشعبية، وأشار كارلتون هايز إلى أنَّ القومية هي اندماجٌ عاطفيٌّ حديثٌ لظاهرتين قديمتين للغاية؛ هما: الوطنية، والتبعية لدولة معينة.
القومية العربية: أو العروبة في مفهومها المعاصر هي الإيمان بأن الشعب العربي شعب واحد تجمعه اللغة والدين والثقافة والتاريخ والجغرافيا والمصالح.
في عام 1913 اجتمع بعض المفكرين والسياسيين العرب في باريس في المؤتمر العربي الأول. وتوصلوا إلى قائمة من المطالب للحكم الذاتي داخل الدولة العثمانية. وطالبوا كذلك ألا يُطلب من المجندين العرب في الجيش العثماني أن يخدموا خارج أقاليمهم إلا في وقت الحرب. وتزايدت المشاعر القومية خلال انهيار السلطة العثمانية. كما تزايد القمع العنيف للجمعيات السرية في دمشق وبيروت من قبل جمال باشا وإعدامه الكثير من الوطنيين في عامي 1915 و1916، ساعدا على تقوية المشاعر المضادة للأتراك. وفي نفس الوقت قام البريطانيون من جانبهم بتحريض حاكم مكة، الشريف حسين على الثورة العربية خلال الحرب العالمية الأولى. هُزم العثمانيون بدعم من بريطانيا ودخلت القبائل العربية الموالية لفيصل، ابن الشريف حسين، دمشق عام 1918. حينها شهدت القومية العربية أول محاولاتها الفاشلة المتمثلة في إقامة المملكة العربية بقيادة الملك فيصل الأوّل ثم استمرت هذه الحركة وفي هذه المرة كانت لمواجهة الاحتلال الإنجليزي والفرنسي والإيطالي للبلدان العربية. وبعد سنوات من النضال استطاعت البلدان التحرر من الاحتلال الأوروبي لها. إلا أن المحتل البريطاني قام بتنفيذ وعد بلفور وتأسيس وطن لليهود على أرض فلسطين.
يبدو مما سلف بأنّ القومية رسمت لها حدودًا على أساسِ قوميّةٍ عرقيّةٍ أو قوميّةٍ أو دينيّةٍ أو قوميّةٍ مدنيّةٍ أو أيديولوجيّةٍ أو قوميّةِ الوحدة أو الاغتراب. وأنها بجلالتها هذه فإنّها خالية من أية تطوّراتٍ سياسيّةٍ وفق متغيّرات المحيط العام الذي أصبح يوصف بالمحيط الدولي، كما أنّها خاليةٌ من أية مضامين وأبعاد فكريّة تجعلها قادرةً على الانفتاح والانخراط الإيجابي في سيرورة الحياة العامة، مما جعلها تفقد أسباب القوة وخلق المناخ السياسي الذي يجعل من القوى السياسية قادرةً على النهوض ومعالجة مشاكلها على المستوى الفكري والتكوين والبحث وسبل الانفلات من قبضة الجمود والغموض والانحلال؛ ذلك لأنّ القوميّة لا تمتلك في حد ذاتها فكرة شمولية عن الكون وعلاقته بالإنسان وبالحياة العامة. فالقومية لا يمكنها المساهمة في تحرير الإنسان من الوثنية ومن الارتباط الأعمى المعتقد، وهي لا تمتلك قواعدَ فكريّةً ولا منهاجًا ثقافيًّا تساعد على الاكتشاف وبلورة المواقف الصحيحة في الوقت المناسب والمكان المناسب، كانت فكريّةً آو عقائديّةً أو سياسيًّا. إنّها تنطوي على أسباب الضعف والفشل السياسي وتعطيل حركة التقدم ودينامية التحدي لشروط العولمة. وعليه فالقوميّة لا تصلح أساسًا، بل هي داءٌ قاتلٌ للقوى السياسيّة، سواءً أكانتْ هذه القوى. تقوم على فكرةٍ عالميّةٍ أم لا، وخطرها القاتل يتعدّى القوى السياسيّة ليشمل القوّة العالميّة التي تقوم عليها هذه القوى، فهي من الأسباب التي ولدت النزاعات والصراعات والحروب والتشرذم للقوى السياسية في العالم.
إنّ القوميّة هي بمثابة سلاحٍ قاتل؛ لأنّها بوضعها وبمرتكزاتها المبنية أساسًا على اللغة أو العرق أو الأقلية كانت مستهدفةً من الاستعمار الإمبريالي وأداة لخلق كيانات موالية للدول العظمى حيث كانت القومية كفكرة سياسية عند الغرب لمعالجة خطر سيطرة الدول الكبرى على القوى السياسية الصغرى والضعيفة، مما جعلها ترسم سياساتها لحماية نفسها من خطر القومية، وقامت باستغلال القومية سياسيا واستراتيجيا بنشرها أو خلقها في مناطق عدة من العالم من أجل السيطرة واستعمار الشعوب، بافتعال النزاعات والصراعات والحروب بينها أو إضفاء الشرعية على سيطرتها واستعمارها وترسيخ فكرة القومية، تحت شعارات تعتبر سلاحا قاتلا للشعوب التابعة أو المستعمرة، كحقّ الشعوب في تقرير مصيرها وانفصالها واستقلالها أو باسم السيادة القومية والدولة القومية، ومن خلال هذا المنطلق القاتل تم تضليل القوى السياسية في العالم بجعل شعار القومية أساساً لها مع العلم أن القومية فارغة من أية قوة فكرية أو سياسية تجعلها تتفاعل مع حقيقة التحول وأهداف العولمة الرامية إلى السيطرة السياسية والعسكرية والاستراتيجية والاقتصادية والمالية، في حين أن الدول الكبرى تستمر في عملية التضليل الفكري والسياسي من خلال مفهوم الثقافة القومية، والاقتصاد القومي، والمصلحة القومية، وهي في الحقيقة ثقافة غربية رأسمالية، واقتصاد رأسمالي، ومصلحة للرأسماليين. وحين طهور الفكرة الشيوعية في الواقع، سارت على ضلال وتضليل الرأسمالية، فاعترفت بالقومية، وعمدت إلى استغلالها ضد الشعوب الضعيفة، ورسمت سياساتها لحماية كيانها من خطر القومية وعمدت أمريكا إلى بناء فكرة التحرير على أساس رأسمالي وقومي، وأمريكا الآن تعمد إلى العمل على تفتيت روسيا وأوروبا والصين على أساس القومية والوطنية والرأسمالية بالمفهوم الأمريكي. إن القومية كانت سببا في ألاف الضحايا في أوروبا، ومن خلالها قامت بريطانيا وفرنسا بتمزيق الخلافة الإسلامية في الشرق والقوميات العربية وضرب الإسلام، وبواسطتها تمكنت بريطانيا من إحكام سيطرتها على أمريكا الشمالية وكندا، وتتولى أمريكا حاليا بنشر سم القومية من أجل إحكام سيطرتها على العالم، مع أنها في الواقع من أكثر الدول قابلة للتفكك وللتشرذم والموت بسهولة بسبب القومية، لأنها تتكون من قوميات مختلفة، فهي ليست كياناً متجانساً من ناحية القومية كألمانيا واليابان مثلاً، وبالتالي هي قابلة للتمزيق إلى أكثر من مائة دولة،
القومية البديل
في خضم عملية تفتيت الشعوب من خلال القومية وسلبياتها التي استغلتها الدول الاستعمارية للهيمنة والاستغلال الهمجي لثرواتها الطبيعية كانت القومية العربية واعية كل الوعي بأبعاد ومخاطر الدول الاستعمارية/الإمبريالية وبخطر امتداد سيطرتها على منطقة الخليج العربي وشمال إفريقيا، حيث في نهاية القرن التاسع عشر، بدأت الحركة القومية العربية بالتأسيس لمواجهة الحكم العثماني للبلدان العربية، وتحديداً عام 1891 عند تأسيس الجمعية العربية الفتاة في باريس، فكانت أول إرهاصات القومية العربية في بلاد الشام بعد حملة محمد علي والتدخل الأوروبي الذي تبع ذلك. في البداية كانت مطالب القوميين العرب محدودة بالإصلاح داخل الدولة العثمانية، واستخدام أوسع للغة العربية في التعليم والإدارات المحلية، وإبقاء المجندين العرب في وقت السلم في خدمات محلية، إلا أن هذه المطالب كثيرا ما كانت تلقى الرفض. في ذلك الوقت لم يمثل القوميون العرب تيارا شعبيا قويا يعتد به حتى في سوريا معقلها الأقوى آنذاك، حيث معظم العرب كانوا يهتمون بولائهم لدينهم أو طائفتهم أو قبيلتهم أو حكوماتهم المحلية.
وفكرة القومية العربية جاءت في سياق تاريخي مشحون بالحروب وباستعمار الشعوب واستغلال القوميات التي لا تمتلك القوة اللازمة للصمود أمام القوميات الاستعمارية في أروبا وأمريكا الشمالية وفي أروبا الشرقية (الستالينية والنازية والميسولونية) خاصة بعد الحرب العالمية الأولى (1914 ) والحرب العالمية الثانية سنة 1939، هي فكرة القومية العربية التقدمية التي بدأت تتبلور منذ بداية القرن العشرين وكان من أهدافها تجاوز الخلافات وتأسيس كيان عربي يواجه الاستعمار في إطار حركة تحررية عالمية ودعم الشعوب العربية من أجل التحرر من قيود الاستعمار والهيمنة الرجعية. وقد لقي هذا المبتغى تجاوبا من لدن المفكرين والسياسيين العرب في كل من سوريا والعراق ولبنان ومصر. وتجسدت فكرة القومية العربية التقدمية على أرض الواقع من خلال الإعلان عن الوحدة المصرية السورية 1952-1958 والنضال من أجل القضية العربية وإصلاح الأراضي ومناهضة الاستعمار. وهي القومية الوحيدة التي حاربت فكرة القومية المنعزلة أو الضعيفة محاربة لا هوادة فيها، لأن هده القوميات تعتبر مقدمات لتغلغل الاستعمار، خاصة الاستعمار الصهيوني الذي عبر عن قدومه لمنطقة الخليج العربي عبر احتلال فلسطين في إطار التوازنات الاستراتيجية للدول الإمبريالية. وفي هذا السياق التاريخي تم الإعلان عن جمهورية العربية المتحدة، الاسم الرسمي للكيان السياسي للوحدة، المتشكل بين جمهوريتي مصر وسوريا. في 22 فبراير / شباط 1958 بتوقيع ميثاق الجمهورية المتحدة من قبل رئيسي سوريا شكري القوتلي ومصر جمال عبد الناصر. لقد كان الإجراء الوحدوي بتابة بداية قوة القومية العربية. لكن المخطط الامبريالي الصهيوني الذي يعتمد على القوميات العرقية أو العقائدية أو اللغوية من أجل إفشال امتداد القومية العربية حتى لا تشكل خطرا على إسرائيل وعلى مشروعه الشرق الأوسطي، وما هزيمة حرب 1967 وما تلاها من تفتيت للقوى السياسية والحركات التحررية إلا نتيجة الاختراق والمؤامرات الداخلية والخارجية على بناء قومية عربية وخاصة لما أصبح مشروع القومية العربية هو المقاومة ضد الاستعمار الصهيوني وضد برنجه الاستعماري التوسعي (الشرق الأوسط الكبير) بزعامة إسرائيل. إنه بالرغم من مخططات الاستعمار الصهيوني فإن الانتصار عليه لن يكون إلا في إطار جبهة عربية تقدمية مندمجة ومنفتحة على كل الحركات التقدمية التي تتصدى للاستعمار بشتى أشكاله.