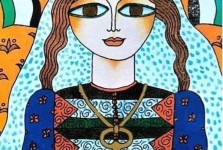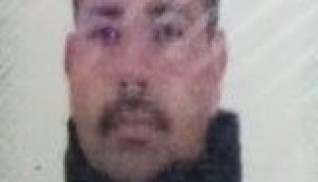تعدُّ روايةُ "الطنطوريّة" (2010) لصاحبتها الروائيّة رضوى عاشور، إحدى أهمّ السرديّات الفلسطينيّة التي تؤرّخُ للنكبة الفلسطينيّة وتوثّق لتفاصيلها. تتناولُ الرواية قصّة المذبحة التي تعرّضت لها قرية الطنطورة، الواقعة على الساحل الفلسطيني جنوب حيفا، على يد القوّات الصهيونيّة عام 1948، من خلال تتبعها لقصّة حياة عائلةٍ اقتُلِعت من هذه القرية، وتشتّت أجيالها في لبنان و مصر والإمارات وكندا وغيرها عبر ما يقرب من نصف قرن. والرواية تمزج في سطورها بين الوقائع التاريخيّة من ناحية والإبداع الأدبي من ناحيةٍ أخرى.
يشيرُ عنوان الرواية - "الطنطورية"- إلى "رقية" بنت قرية "الطنطورة" الفلسطينية التي سقطت في يد الاحتلال الصهيوني عام 1948، وهي الرَاوية التي تسرد الأحداث، وتقدم حكايتها وحكاية أهلها وأبنائها وأحفادها، بدايةً من عام 1948، وحتى عام 2000، وتتبع حكاية شتات الأجيال إلى لبنان والإقامة في صيدا ثم بيروت ثم في مدنٍ عربيّةٍ أخرى. فهي رواية أجيالٍ تستخدمُ منظور المرأة والسرد المستعاد لتحكي لنا قصّةَ أسرةٍ من أربعة أجيال، تبدأ بالجد الكبير "أبو الصادق" الذي قتله الصهاينة بعد وقوعه في الأسر عقب اجتياح الطنطورة عام 1948، وصولًا إلى الحفيدة "رقية" ابنة "حسن" المولودة في اللد عام 2000، على بُعد كيلومترات من الطنطورة.
وهنا تواصل رضوى عاشور في روايتها "الطنطورية" ما بدأته من قبل- ولو بشكلٍ غير مباشر- في رواياتها السابقة التي ترصد حاضر العرب الآن وضياع فلسطين، فمعظم رواياتها، وعلى رأسها "أطياف" و"قطعة من أوروبا"، تتصدّى لمأساة فلسطين وضياعها، وتصوّر مجمل المأزق العربي، وربما يرجع ذلك لارتباطها برمزٍ من رموز فلسطين، وهو الشاعر "مريد البرغوثي"، ووعيها بالقضية التي تجمع بين المصير التاريخي الفلسطيني والحياة العربية بأكملها. فمشروع رضوى عاشور عن فلسطين يتميز بمزج التاريخي والإنساني، والجمع بين الواقعي والخيالي في خطابٍ إبداعيٍّ يضفر الحكاية التاريخية مع الحكاية المتخيلة في نسيجٍ سرديٍّ محكم.
ومن المعروف أن الزمن في الرواية الفلسطينية يرتبط بالمكان ويتشكّل من خلاله، حيث يتوزّع هذا الزمن على مساحاتٍ مكانيّةٍ متعدّدةٍ بتعدّد المنافي، ومناطق الشتات التي يعيش فيها الفلسطينيين، ولذلك يقوم الخطاب الروائي عادةً على أساس التناقض بين "ما كان" في الوطن و"ما هو كائن" من حقيقة معيشة في المنفى و"ما سيكون" عندما يتحقّق حلم العودة، ولذلك يظلّ الزمن - الفرديّ والجمعيّ- في الرواية الفلسطينيّة محكومًا دائمًا بأزمة المكان.
ومن هنا تعلن "الطنطورية" عن أصلها الزماني والمكاني معًا، من خلال انطلاق السرد بها من زمن النكبة، وما نتج عنه من أزمنةٍ مختلفةٍ ترتبط بتشتت أبناء الشعب الفلسطيني وتوزّعهم عبر المنافي القسريّة، حيت امتدَّ زمن الحرب ليلاحق الفلسطينيين في المنفى بدايةً من أحداث التهجير عن الوطن، مرورًا بانتقال المقاومة الفلسطينيّة إلى لبنان، واستمرارًا - وليس انتهاءً - بانتصارٍ استثنائيٍّ بتحرير الجنوب اللبناني؛ لتغطي الرواية الكثير من المساحات الزمنيّة التي واكبتها القضيّة الفلسطينيّة منذ نكبة 1948، وحتّى الزمن الحاضر، وتتوزّع تلك الأزمنة على أماكن الشتات في بلدان الوطن العربي والعالم.
ولذلك، تتجلى البنيةُ الزمكانيّة بالرواية بدايةً من افتتاحيتها التي تتكون من عنصرين رئيسين، هما: الماضي والمكان، حيث خصت رضوى عاشور صفحات البداية في رواياتها لوصف المكان (قرية الطنطورة وبالأخص بحرها) وتقديم الماضي (قبل أحداث النكبة) في لحظةٍ من لحظات حياة بطلتها/ رقية، فتعود إلى الوراء لسنواتٍ طويلةٍ لإعطاء القارئ الخلفية الزمكانية اللازمة، وإدخاله في عالم الرواية الخاص. وتجمل الرَاوية مشهد الافتتاحية في عبارةٍ موجزةٍ وموحيةٍ تنقل بها القارئ إلى مكان الأحداث وزمانها المنسوجين في ذاكرة الشخصية تستدعيهما بغير نظامٍ أو ترتيب: "أسترجع المشهد ثم أعود أسترجعه على خلفية صوت الأمواج والأهازيج والزغاريد الآتية من اتجاه بيتنا". (الطنطورية، صـ 14)
فجاءت كتابة المكان الغائب/ الحاضر لتتجسد عبر استدعاءات الماضي التي لا تُقدم بطريقة التسلسل الزمني المنتظم، ولكن نجد نوعًا من الذبذبة الزمنية بين الحاضر والماضي في حياة الشخصيات؛ حيث لا يتشكّلُ الزمن الروائي بشكلٍ تتابعي، إنّما تستعيده "رقية" على مدار السرد عبر بلورة ملامح الوطن وتاريخه وماضيه رغم ابتعادها عنه زمنيًّا ومكانيًّا؛ بهدف إعلاء سلطة المكان، غائبًا أو حاضرًا، من خلال استدعائه عبر المخيّلة الروائيّة وترسيخه في ذاكرة الزمن، وكأنّ الراوية/ رقية تستعين بالحكي سلاحًا لحماية ذاكرة المكان ونقلها للأجيال التالية، فاستمرار فعل الحكي كان- في رأيها- ضمانًا لبقاء تاريخ المكان وحمايته من المحاولات المستمرّة لتغييبه ومحو هويته.
ويتجسّدُ الارتباط المكاني والزمني عبر النصّ السرديّ في اهتمام الأديبة في روايتها بالتاريخ وعلاقته بالمكان، حيث وقائع التاريخ تحتضنها دائمًا جغرافيا المكان، فلا يتمَّ تصوير المكان إلا من خلال الأحداث التاريخيّة الكبرى التي وقعت به (مثل: وصف مركز الأبحاث الفلسطيني ببيروت وقت تدميره أثناء حرب لبنان الأولى، ووصف مستشفى عكا وتدميرها أثناء مذبحة صابرا وشاتيلا، ووصف تدهور وضع المخيمات أثناء الحرب الأهلية اللبنانية، وغيرها)، مما يبرز ارتباطًا وثيقًا بين المكان والزمان. فكان وصف المكان تمهيدًا للحدث الزمني الرئيس الذي ستركز الرواية على عرضه في المشاهد التالية، فنجد، مثلًا، وصف مستشفى عكا أثناء أحداث مخيّم شاتيلا، من قتل الرُضّع، والتخلّص منهم، وتدمير المستشفى وقتل أطبائها وممرضاتها، جاء تمهيدًا لسرد تفاصيل مذبحة صابرا وشاتيلا (16/9/ 1982) وتداعياتها في الأيام التي تلت المجزرة: "كانت المستشفى في حال يرثى لها: الزجاج مُكسَّر والستائر محروقة والكافتريا مُحطمة بما في ذلك الثلاجة، والتموين مدلوق على الأرض وصورة أبو عمار ممزقة، إطارها مكسّر والزجاج محطَّم. داسوها بالأقدام. وقسم الأطفال خال وكذلك الحضانات". (الطنطورية، صـ 251)
وقد صرحت رضوى عاشور في كثيرٍ من حواراتها عن ارتباط الزمان والمكان في إبداعاتها ونظرتها لهما عنصرينِ لا ينفصلان في المتن الحكائي، وبالأخصّ بالروايات ذات الصلة الوثيقة بالتاريخ كـ"الطنطورية"، فـ"الرابط بين الزمان والمكان في نصٍّ روائيٍّ ما لا يأتي تخطيطًا أو بنيّةً مسبقة"، على حد وصفها، "بمعنى أن الأمر ليس فكرةً تشرع في تجسيدها، بل هو يتعلّقُ بطريقة استقبالك للوجود من حولك وتنظيمك غير الملحوظ لتجربتك، فلا ترى الزمان إلا في مكان، ولا ترى مكانًا إلا وتشكّله عناصر واقع تاريخي بعينه". (حوار الكاتبة بمجلة الرافد، في أغسطس 2012).
فكان من الطبيعي أن يكون لزمن الحروب التي عاشها الفلسطيني في الشتات أثرٌ واضحٌ في شعوره بالانفصال عن المكان الذي يعيش فيه بعد رحيله القسري عن الوطن، ولم يتوقّف الإحساس بالغربة خارج الوطن عند مجرد الحنين إليه والحلم بالعودة له، إنّما رافقه حالة من الاغتراب طالت أبناء الجيلين الأول والثاني، وتجلت مظاهرها في رحيل "رقية"- رغمًا عنها- بعيدًا عن لبنان بعد اشتداد أزمة الفلسطينيين بها أثناء الحرب الأهلية اللبنانيّة التي جعلت المكان يلفظ ساكنيه من اللاجئين. ولذلك يكشف تصوير المكان في الرواية عن الحالة النفسية للشخصيات التي ينتابها إحساس بعدم الانتماء للمكان الذي تعيش فيه، في الوقت الذي يظلّ المكان الفلسطيني البعيد حاضرًا بقوّةٍ من خلال الذاكرة، حيث لجأت الشخصيات إلى البحث عن حلول لهذا الاغتراب المكاني في الماضي الفلسطيني، بعد إبعادها عن زمكانيتها الأولى ودخولها في زمكانيّة جديدة لا تألفها، مما يؤكد أن للمكان والزمان تجلياتٍ واضحةً ومترابطةً في المتن الحكائي الروائي لدى رضوى عاشور.