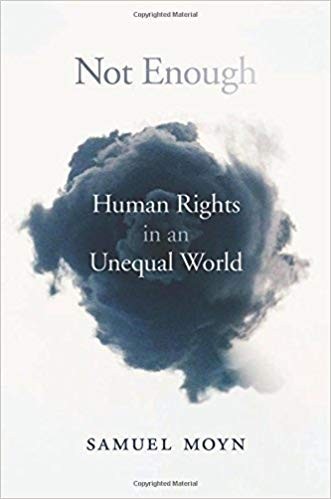في هذا النص المطول يراجع نيلز جيلمان (نائب رئيس البرامج في معهد بيرغروين المستقل في لوس أنجلس) كتاب "لايكفي: حقوق الإنسان في عالم غير متكافئ" ل صمويل موين (أستاذ القانون والتاريخ في جامعة ييل، ومؤلف العديد من الكتب حول تاريخ وفلسفة حقوق الإنسان) والذي يحاول فيه تفسير أمر إشكالي للغاية، هو العلاقة بين حقوق الإنسان والليبرالية الجديدة، ورغم صعوبة كتابة تاريخ الأحداث غير المرتبطة بسبب الالتزام المنهجي للمؤرخين بالتمسك بالقرب من المصادر الوثائقية، ونادراً ما تترك الأشياء التي لا تحدث أثراً وثائقياً واضحاً، في هذه الحالة، فإن الحدث الذي لم يقع والذي يصفه صمويل موين في كتابه الجديد، هو إضفاء الطابع المؤسسي على أخلاقيات سياسية للمساواة المادية.
يأخذ الكتاب شكل تدخل في نقاشين تاريخيين كبيرين، الأول حول تاريخ الليبرالية الجديدة والثاني حول تاريخ حقوق الإنسان، وهو مجال ساعدت معالمه الحالية موين في تحديده مع كتابه اليوتوبي الآخر لعام 2010 "اليوتوبيا االجديدة: تاريخ حقوق الإنسان " حقوق الإنسان في التاريخ"، و اللغز الذي يسعى إلى شرحه هو: كيف يتزامن عصر النيوليبرالية، التي قيل إنها بدأت في منتصف السبعينيات إلى أواخر سبعينيات القرن الماضي، بشكل مثالي تقريبًا مع الصعود المنتصر في خطاب حقوق الإنسان؟
بمعنى آخر، كيف يمكن أن تكون تلك الحقبة التي كان فيها مفهوم الذات الأخلاقي متجذرًا في حركة عابرة للحدود الوطنية لمنع الانتهاكات مثل التعذيب والحرمان من الحقوق السياسية والسجن، هي نفسها حقبة عادت فيها الاقتصادات الوطنية والعالمية إلى الظهور بطرق جديدة. سمحت لأصحاب رؤوس الأموال الأثرياء بالحصول على الغالبية العظمى من مكاسب الإنتاجية الاقتصادية، مما أدى إلى عدم مساواة داخل البلد لم نشهدها منذ أواخر القرن التاسع عشر؟
للإجابة على هذا السؤال، يبدأ موين بإعادة النظر في مشهد ما يعتبره جريمة تاريخية - أي الادعاء بأن الأربعينيات كانت حقبة عظيمة من حقوق الإنسان، تركزت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948، حيث أعلن المؤرخون غالبًا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو المنطلق الأول لعصر حقوق الإنسان الحديث، وهو الإعلان العظيم عن الآمال عبر الوطنية لعالم ما بعد الحرب الأكثر عدلاً والذي سوف يتكشف على مدى العقود المقبلة - وهو حجر الزاوية في "صفقة جديدة من أجل العالم"، على حد تعبير عدد من المؤلفين، والمشروع المركزي لهذا الكتاب كان فضح هذا الإدعاء، بمناسبة السبعينيات بدلا من الأربعينيات باعتبارها لحظة عظيمة لازدهار حقوق الإنسان، وتحولت قضية موين عن الانهيار الإيديولوجي للاشتراكية: "أدى الحلم الجديد لحقوق الإنسان إلى ردم حلم الاشتراكية الفاشل في أعقاب "العالمية 1968". كما يقول، ورفض التفسير لتاريخ حقوق الإنسان باعتباره واحداً من النمو المنتصر، بل ينظر إلى حقوق الإنسان كنوع من جائزة العزاء الأخلاقي.
ومع ذلك، ظهرت العديد من الألغاز والمشاكل من هذا التفسير، يتعلق أولها بوضع لحظة حقوق الإنسان في الأربعينيات، حيث رفض موين تلك اللحظة بشكل أو بآخر، وسخر من الادعاءات التي حاولت تحديد موقع أصول خطاب حقوق الإنسان حتى قبل ذلك، في عصور الثورتين الفرنسية والأمريكية، صحيح أنه كان هناك خطاب للحقوق خلال الأربعينيات من القرن العشرين، كما اعترف موين، لكن هذا كان غامضاً وواسع النطاق، وكلمة "متساوية" تظهر عدة مرات في هذا الإعلان، ولكن باستثناء مرحلة "الأجر المتساوي للعمل المتساوي،" ليس هناك أي إشارة إلى المساواة الاقتصادية، أو في الواقع إلى أسئلة التوزيع على الإطلاق، بدلا من ذلك، فإن المساواة المشار إليها في الوثيقة تتعلق بالعلاقات الرسمية مع الدولة (على سبيل المثال، "أمام القانون"، "الوصول إلى الاقتراع"، وما إلى ذلك)، وليس المساواة فيما يتعلق بأخوية المواطنين، وأقل بكثير من الجنس البشري ككل .
بصرف النظر عن تفاصيل الحقوق المذكورة، جادل موين بأنه من الناحية العملية، كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمثابة فشل فكري وأيديولوجي، تم تجاهله إلى حد كبير من قبل صانعي السياسات والأكاديميين على حد سواء، و على النقيض من ذلك، عندما شهدت حقوق الإنسان في سبعينيات القرن العشرين "اختراقها" السياسي فعلت ذلك بمفهوم أكثر تركيزًا بدرجة ضيقة للغاية والذي تحول حصريًا تقريبًا إلى الحقوق السياسية الفردية، وأن تكون خالية من أنواع معينة من الإساءات الجسدية إلى حد كبير على أيدي الدولة، وإن النسخة المقطوعة لحقوق الإنسان التي اقتحمت الخيال الأخلاقي العالمي في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي نجحت جزئياً لأنه، عن طريق قصر نقدها على الخطايا السياسية للدولة، أصبحت أداة مفيدة في الحجج الأخلاقية حول تفوق الرأسمالية الليبرالية الغربية على الشكل الشرقي من الاشتراكية الدكتاتورية.
ظهر اللغز التأريخي الثاني الذي يواجهه موين في كتاب "لا يكفي" جزئياً بسبب النمو الهائل في الاهتمام بالصعود التاريخي لليبرالية الجديدة وعدم المساواة في أعقاب الأزمة المالية عام 2008، من جهة، ونشر أعمال توماس بيكيتي من ناحية الأنماط التاريخية لعدم المساواة داخل البلد خلال القرنين الماضيين، من جهة أخرى، من خلال تمحيصه في مجموعة بيانات مفصلة بشكل كبير حول تطور توزيع الدخل والثروة في ما يقرب من اثنتي عشرة دولة صناعية، كشفت أعمال إعادة التعريف الميداني لـ بيكيتي ومعاونيه في وحول مدارس لندن وباريس للاقتصاد أن الثلث الأوسط من القرن العشرين كان فترة استثنائية في تاريخ التوزيع الاقتصادي، حيث ضاقت تباينات الثروة والدخل بشكل كبير عبر جميع الولايات في قلب شمال الأطلسي الصناعي، مقابل انعدام المساواة الذي نما طوال القرن التاسع عشر (وحتى عام 1929، في حالة الولايات المتحدة) وتم تقليصه بشكل كبير بسبب العوامل المزدوجة المتمثلة في تدمير الثروة في زمن الحرب وسياسات إعادة التوزيع التي فرضتها دول الرفاه بعد الحرب.
ابتداء من السبعينيات، ومع ذلك، بدأ توزيع الدخل والثروة في إعادة تأكيد نفسه في جميع البلدان، وعلى الرغم من الاختلافات الوطنية وسلسلة كاملة من دورات الأعمال، فقد استمر الآن بشكل لا يرحم منذ ما يقرب من نصف قرن، من خلال مجموعة متنوعة من التدابير، تقترب مستويات عدم المساواة في البلاد اليوم (الولايات المتحدة) من تلك التي ميزت ذروة الليبرالية الكلاسيكية في القرن التاسع عشر، بين الأكاديميين، غالبًا ما يتم شرح أسباب هذا التحول تحت عنوان "الليبرالية الجديدة".
"كتاب لا يكفي" يدرج نفسه في هذه الأسئلة من خلال تحويل نظرته من سبعينيات القرن العشرين إلى الأربعينيات وطرح سؤال غريب إلى حد ما، سلبي، وصعب: لماذا في لحظة ما بعد الحرب العظيمة من التضامن الوطني والديون وقتال الطبقات العاملة، حيث تم توسيع نطاق دول الرفاه الوطنية بشكل كبير، لم يتم إضفاء الطابع المؤسسي على روح المساواة بشكل دائم في أي بلد، أقل بكثير على المستوى عبر الوطني؟
هنا يقدم موين التمييز الرئيسي الذي يستند إليه كتابه، وهو التناقض بين مبدأين أخلاقيين مختلفين ينطبقان على سلسلة من المجالات المختلفة، الاقتصادية والسياسية على حد سواء: أخلاقيات المساواة مقابل أخلاقيات الكفاية، حيث تؤكد أخلاقيات المساواة أن النظام الأخلاقي العادل يعتمد على حصول الجميع بشكل أو بآخر على نفس القدر من "الأشياء الجيدة في الحياة"، بما في ذلك السلع المادية ولكن أيضًا أشياء مثل الكرامة والسلطة السياسية، وعلى النقيض من ذلك، لا تهتم روح الاكتفاء بالمساواة النسبية، بل تتأكد من أن كل فرد يلبي الحد الأدنى من العتبة فيما يتعلق بالسلع المعنية.
يجادل موين بأن كل من خطاب حقوق الإنسان ومبررات تطوير دول الرفاه في الأربعينيات كانت ضبابية في حين كان هناك بالتأكيد بعض من سخروا من المساواة (السياسي الاشتراكي البريطاني والمفكر هارولد لاسكي) ، يجادل موين بأن جزءاً من الدافع وراء دول الرفاهية في بناء المدن الكبرى كان على وجه التحديد تجنب المواجهة المباشرة للغز التغلب على المساواة مقابل المساواة من خلال رفع الحد الأدنى من توفير الدعم الاجتماعي إلى مستوى تكون فيه الفروق بين الأسوأ والأفضل حالًا، إن لم تكن غير ذات صلة، فيُعادل سياسيًا على الأقل، ومع ذلك، فإن الفشل في إثبات المساواة باعتباره الأخلاقيات الأساسية لدولة الرفاه في لحظة إنشائها ترك الباب مفتوحًا للعودة الانتقامية لعدم المساواة التي بدأت في السبعينيات، وبحلول ذلك الوقت، لم يكن مفهوم حقوق الإنسان الذي تم اقتطاعه الآن كافياً ببساطة لقمع الانتقام من الرأسمالية المالية والعولمة التي من شأنها أن تجتاح الربع الأخير من القرن العشرين.
بالطبع، ليس من العدل إلقاء اللوم على الناس في الأربعينيات من القرن الماضي لفشلهم في التنبؤ بما سيحدث بعد 30 عامًا، لكن النقطة المهمة هي أن مفهوم حقوق الإنسان لم يكن مفيدًا بشكل أساسي، ليس فقط للدفاع عن المساواة في وقت لاحق بل عن تبرير دول الرفاه في المقام الأول، و كان بناة دول الرفاهية بعد الحرب غير مهتمين إلى حد كبير بمسائل حقوق الإنسان، مبررين مواقفهم على أسس أخرى، لا سيما التوازن خارج السلطة الطبقية، وعلى النقيض من ذلك، في حالات ما بعد الاستعمار الناشئة، كانت الحقوق الاجتماعية المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان غالبًا ما يتم الاستشهاد بها كأساس لبناء أنواع الدول الحديثة (أي دولة الرفاه) التي كانت تتوق إليها ولكنها فشلت في تحقيقها في معظم الحالات، و باختصار، كان للحقوق الاجتماعية والاقتصادية (الجماعية إلى حد كبير والإيجابية) المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - والتي سيتجاهلها أبطال الحقوق السياسية الفردية والسلبية في سبعينيات القرن العشرين - صدى مع طموحات بناء الدولة في مجال الرفاهية في فترة ما بعد الحرب، لكنها كانت إلى حد كبير كمبرر للمؤسسات التي كانوا ينشئونها.
كما يجادل موين، فإن هذا التهرب عار، لأن الفشل في إضفاء الطابع الرسمي على الأسس الأخلاقية المتكافئة لدولة الرفاه في الأربعينيات من القرن الماضي ترك الباب مفتوحاً أمام صعود عدم المساواة في السبعينيات، نعم، سيستمر الوفاء بالمعايير المادية الدنيا في معظم الأماكن - الإسكان العام والتعليم الابتدائي والثانوي، والرعاية الصحية الأساسية، والمعاشات التقاعدية، وما إلى ذلك - ولكن ظلت هذه المعايير عالقة عند مستوى منخفض حتى مع السماح بتفاوت الثروة وتزايدها بدأ الأغنياء الناشئون في استخدام ثرواتهم للحصول على إصدارات أجمل من هذه السلع: المدارس الخاصة باهظة الثمن وبالتالي الحصرية، وشبكات النقل الخاصة باهظة الثمن وبالتالي الحصرية، وأنظمة الرعاية الصحية الخاصة الباهظة الثمن، وبالتالي، إلخ.
لنأخذ مثالاً واحداً: قد لا تتفاقم جودة التعليم المدرسي العام، كما تم قياسها بمهارات التعلم التي يغادرها معظم الناس، من حيث القيمة المطلقة منذ الأربعينيات، لكنها لم تتحسن بشكل أفضل أيضًا - حتى عند الأثرياء الذين قاموا بنقل أطفالهم إلى مدارس خاصة ذات أحجام فصول أصغر بكثير، ومعدات أفضل، واهتمام شخصي أكبر بكثير من المعلمين، وبالنظر إلى أهمية التعليم للنجاح في اقتصاد المعرفة، فإن هذه الفوارق تعزز الفروق الطبقية، مما يزيد من عدم المساواة.
إن دينامية "الاختيار السلبي" هذه هي كارثة سياسية وأخلاقية، والنقطة الحادة لموين هي أن خطاب حقوق الإنسان كما عرفناه في شكل ما بعد سبعينيات القرن الماضي، لا يعني شيئًا مما نقوله حول هذه المسألة.
إن ظهور دول الرفاه في شمال الأطلسي في الأربعينيات من القرن الماضي هو الحدث الذي يهمش الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في لحظة إعلانه، و بالنسبة لـ موين، فإن "إعادة اكتشاف" الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في سبعينيات القرن العشرين أمر مثير للسخرية للغاية، خاصة وأن الذين اعتنقوه، بدعوى أن أنشطتهم الخاصة تستفيد منه، فعلوا ذلك حتى عندما تجاهلوا الإشارات الفضفاضة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.، وهذا نمط غير شائع بين أولئك الذين يدعون "حقوق" جديدة للأشياء في الوقت الحاضر مع الإشارة إلى النصوص "الأصلية"، حيث فكر في أنصار حق الفرد في حمل سلاح عسكري في الولايات المتحدة بالاستشهاد بالتعديل الثاني للدستور ولكنهم تجاهلوا بصراحة الجزء حول "ميليشيا منظمة تنظيما جيدا" والتبرير الأصلي للحق كوسيلة لتجنب شرور جيش دائم.
إذا فموين يرفض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الأربعينيات من القرن الماضي باعتباره خطابًا ميتًا، في هذا الكتاب الجديد أعاد تقييمه فعليًا لالتزامه - مهما كان ضعيفًا - بعدالة التوزيع، حتى مع استمراره في الإصرار على أن هذا الجزء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تم تجاهله في وقت نشره ومن قبل أولئك الذين أعادوا إنشائه في السبعينيات من القرن الماضي كوسيلة للمطالبة بالحريات السياسية الفردية، وفي قراءة موين الجديدة، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعاد صياغته من علاقة هامشية بوثيقة يساء فهمها بشكل مأساوي.
يعد كتاب موين تاريخًا فكريًا في المقام الأول ولا يهدر الوقت في التفاصيل الفنية لنمو اللامساواة، وقد تكون هذه التفاصيل أكثر أهمية مما يوحي به موين لكيفية تفكيرنا في العلاقة بين النيوليبرالية والمساواة، على سبيل المثال، في حين أن بيكيتي وآخرون، وثقوا الصعود الذي لا يرحم للتفاوت داخل البلاد، وقد أكد عمل برانكو ميلانوفيتش على أنه يمكن القول إن هذا يمثل ضغطًا مهمًا لانعدام المساواة بين الدول التي تكشفت أيضًا خلال فترة الصعود النيوليبرالي منذ سبعينيات القرن الماضي، وفي حين أن الأغنياء أصبحوا أكثر ثراءً في كل مكان من مواطنيهم، فقد كان هناك نوعًا من التقارب الاقتصادي على مستوى العالم، حيث أن أفقر البلدان قد استوعبت الدول الغنية، بعبارة أخرى، بدأ تضييق الفوارق الاقتصادية عبر الوطنية، والتي كان منظري التحديث الأمريكيون في الخمسينيات وأنصار "النظام الاقتصادي الدولي الجديد" (NIEO) في السبعينيات، يتحدثون عنها، ومع ذلك، فقد حدث ليس تحت راية المساواة ولكن بدلاً منها راية الاكتفاء ومع تزايد عدم المساواة داخل البلدان في جميع أنحاء العالم.
يتجاهل موين هذه القصة إلى حد كبير، ويركز بدلاً من ذلك على حالات الرفاه الوطني التي كما يقول، كانت "المؤسسات السياسية الوحيدة التي، حتى الآن، هي التي تمكنت من تحقيق قدر ضئيل من المساواة في التوزيع، ولا سيما تقييد هيمنة الأكثر ثراءً"، بمعنى من المعاني، يسأل موين عن سبب فشل دولة الرفاهية في توفير حاجز ضد عودة التفاوتات الاقتصادية الشاسعة، كما ينادي ضمنيًا بإمكانية إعادة إنعاش دول الرفاه المعاصرة إذا لم يتم إعادة اختراعها بشكل مباشر على أساس المساواة كأساس في النهاية، لكن هل دولة الرفاه الوطني، بكل ما فيها من استثناءات حتمية بسبب التسلسل الهرمي للطبقة والعرق والجنس (التي يعترف بها موين صراحة)، هي حقًا الأساس الوحيد أو حتى الأفضل لسياسة المساواة في القرن الحادي والعشرين؟
فيما يتعلق باحتمالات وجود نظام عالمي للمساواة في إعادة التوزيع، يركز موين على شخصيتين بارزتين في تاريخ اقتصاديات التنمية، وهما الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل وعراب مملكة الرفاه الأسطورية غونار مردال، والعالم الخبير الاقتصادي في البنك ووزير المالية الباكستاني محبوب الحق، مردال يبرز كنموذج من البطل، يجادل في الأراضي الغنية والفقيرة(1957) أن ما يحتاج إليه عالم ما بعد الحرب هو الانتقال من سلسلة من دول الرفاهية الوطنية إلى "عالم الرفاهية" الذي يأخذ المساواة بين الأمم كنقطة انطلاق أساسية، كما يشير موين، ومع ذلك، لم ينجح ميردال في اقتراح أي إطار مؤسسي قادر على دعم هذه الرؤية، أفكار لمثل هذا الإطار الذي انبثق من المثقفين والقادة السياسيين فيما كان يطلق عليه "الجنوب العالمي"، لا سيما الاقتراح المقدم إلى الأمم المتحدة في عام 1974 من أجل "نظام اقتصادي دولي جديد" (NIEO)، لم يفلح في النهاية، سوى باستحضار مزيج من الانقسامات الداخلية بين بلدان الجنوب العالمي وعداء العديد من القادة في الشمال العالمي.
في مواجهة الإخفاق الواضح لعالم الرفاه في الظهور، توصل محبوب الحق في هذه السنوات نفسها ("بسخرية"، وفقًا لموين، ولكن ربما من الناحية الواقعية فقط) إلى أن طموحات المساواة العالمية لم تكن قابلة للتحقيق، وسيكون له دور فعال في دفع رئيسه روبرت ماكنمارا، الذي تم تعيينه كرئيس للبنك الدولي بعد توليه منصب وزير الدفاع خلال تصعيد الولايات المتحدة لحرب فيتنام، لإعادة توجيه البنك بعيدا عن مشاريع تمويل البنية التحتية التي كانت محورية في أول 25 عامًا، لصالح دعم "الاحتياجات الأساسية"، وهو مصطلح أصبح شعارًا لكثير من مشاريع التنمية العالمية خلال السبعينيات، كما يوحي المصطلح، كان هذا اعتناقًا علنيًا لروح الاكتفاء على روح المساواة، ويرى موين هذا على أنه لحظة أساسية في الابتعاد عن الآمال الاشتراكية في المساواة التي حفزت المرحلة الافتتاحية من عصر ما بعد الاستعمار، من خلال تحويل الانتباه عن مسائل المساواة، كان له صدى جيد أيضًا مع الحقبة الليبرالية الجديدة التي كانت على وشك أن تنفجر عبر الاقتصاد السياسي العالمي في العقود الأخيرة من القرن العشرين، بينما كانت حكومتا مارغريت تاتشر ورونالد ريجان معادية بنشاط لمشاريع إعادة التوزيع العالمي، كان يمكن إقناعهما بأن الترويج لبرامج التعليم والصحة العامة والتغذية في العالم الثالث كانت أهدافاً لطيفة للسياسة الخارجية.
عند هذه النقطة، تم دمج برامج تطوير الاحتياجات الأساسية مع حركة حقوق الإنسان المزدهرة: ركز كلاهما على رفع دعاوى نيابة عن الفرد ضد الدولة، واستخدم أنصار NIEO أيضًا ادعاءات "الحق في التنمية"، لكن هذا الشعور بالحق كان مختلفًا تمامًا عن الحقوق الفردية التي أطلقها مؤيدو الاحتياجات الأساسية وحركة حقوق الإنسان: فقد وصفت حقًا جماعيًا من جانب الدول إلى المساواة، وبعبارة أخرى، كان شكلاً من أشكال مطالبات دول ما بعد الاستعمار في الجنوب العالمي ضد الدول الغنية في الشمال الصناعي، وبالنسبة إلى مؤيدي الاحتياجات الأساسية وحقوق الإنسان، فإن أنواع المطالبات الجماعية هذه تجاهلت الانتهاكات السياسية والتفاوتات الاقتصادية داخل دول الجنوب العالمي، وبحلول أواخر سبعينيات القرن العشرين، كما يوضح موين، لوحظ بشكل روتيني أن الاحتياجات الأساسية كانت "الأساس المنطقي الشفاف لتجاوز مطالب NIEO وتأمين خدمة الفقراء كمهمة أساسية في الجنوب العالمي، كل بلد يفعل ذلك من تلقاء نفسه في علاقة غير رسمية وغير متغيرة مع أسيادها الاستعماريين السابقين".
يجادل موين بأن "الاحتياجات الأساسية وحقوق الإنسان أصبحت شائعة في الشمال العالمي، جزئياً على الأقل لأنها وفرت وسيلة لتحييد إعادة تعريف علاقات القوى بشكل أساسي بين الدول، وفي الوقت نفسه السماح بانتقاد وحتى تدخل في الدول المستعمرة السابقة من قبل الشمال، وسوف يتأرجح محبوب الحق نفسه في مواجهة هذا النقد، معترفًا بأن الاحتياجات الأساسية قد تحولت إلى "عذر مناسب للدول الغنية لتأجيل مناقشات جادة حول إصلاح النظام العالمي الحالي".
بالنسبة لمناصري الليبرالية الجديدة الناشئة، بالطبع، بدا هذا الجانب السياسي من الاحتياجات الأساسية وكأنه سمة أكثر من كونه خطأ. ويتناول الفصل الأخير من كتاب موين السؤال المحير حول العلاقة بين حقوق الإنسان والليبرالية الجديدة - شكل الرأسمالية المحررة والمالية والعولمة ومناهضة للرفاه الاجتماعي التي بدأت في الظهور في سبعينيات القرن الماضي، في نفس اللحظة التي شهدت طفرة حقوق الإنسان. تقييم موين هو أنه بينما نادراً ما كان أنصار حقوق الإنسان متعاطفين مع الليبرالية الجديدة، فإن مبادئ حقوق الإنسان وفهم العدالة الاقتصادية على أساس مفاهيم الكفاية لم تفعل شيئًا لمنع ظهور الليبرالية الجديدة. "
نظرًا لأن محور نقدهم كان على ممارسات الدولة، فإن حقوق الإنسان عند ظهورها والتي تم الدفاع عنها في الثمانينيات كانت عديمة الفائدة للدفاع عن الأشكال الجماعية لتقاسم المخاطر أو لانتقاد الامتيازات الباهظة للجهات الفاعلة الخاصة القوية اقتصاديًا، وفي جميع أنحاء أوروبا الشرقية، مع سقوط النظم الشيوعية، كانت دساتير الديمقراطيات الجديدة تكرس التزامات حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات، حتى عندما تم بيع الصناعات المؤممة سابقًا إلى القلة، جذبت هذه الخطوة اللصوص. ويلاحظ موين أنه لم يكن لدى حركة حقوق الإنسان ما تقوله عن الموجة المدمرة لبرامج التكيف الهيكلي التي اجتاحت العالم الجنوبي في الثمانينيات والتسعينيات، و باختصار، فإن حقوق الإنسان، على الرغم من أنها ليست مسؤولة عن الليبرالية الجديدة، قد عملت على إعادة صياغة عبارة جان جاك روسو، على أنها "أكاليل من الزهور فوق السلاسل الحديدية التي تزن الرجال [...] [مما يجعلهم يحبون حبهم للعبودية] لاستخدام استعارة مختلفة: كانت حقوق الإنسان بمثابة ملعقة من السكر الأخلاقي الذي جعل الدواء المرير للليبرالية الجديدة أسهل في البلع.
ينهي موين كتابه بأمل ضعيف في أنه ربما لا يمكن إحياء روح المساواة فقط بل يجب إعادة إحياءها لمعالجة عدم المساواة الراكدة التي كانت ثمرة النيوليبرالية والتي تكمن في جذر الإزدهار العالمي للقوميات الشعبية، ولتطوير شكل أفضل من المساواة، يجب على المرء أن يبدأ من الاعتراف بأن جميع الاقتصادات اليوم عالمية بعمق في النطاق والترابط، وإن العقبة الرئيسية أمام سياسة إعادة التوزيع الفعالة للقرن الحادي والعشرين هي قدرة رأس المال على الفرار من أي دولة تأخذ إعادة التوزيع على محمل الجد نحو سلطة قضائية أكثر ملائمة لرأس المال. وإن إغلاق الملاذات الضريبية والخدمات المصرفية الخارجية سيكون خطوة أولى جيدة، ولكن بدون وجود مجموعة من المؤسسات العالمية، فمن المرجح أن تؤدي أي مشاريع مساواة على المستوى المحلي إلى تعزيز عدم المساواة على المستوى العالمي (على سبيل المثال، بلدان الشمال الأوروبي، والتي هي أندية ريفية تتنكر كدول ذات سيادة وتتجذر في استبعاد الغرباء) أو أن تنهار بسبب هروبها إلى الأجواء الودية ذات الموارد التي تحتاج إلى إعادة توزيع، ولسوء الحظ، فإن ضعف "شبكات الحكم العالمية" العابرة للحدود الوطنية التي وصفتها آن ماري سلاوتر بمهارة تجعلها غير كافية للمهمة بشكل واضح، وفي الواقع، في اقتصاد متكامل عالميًا، فقط كيان تنظيمي عالمي النطاق لديه فرصة جدية لترويض قوة رأس المال العالمي.
باختصار، إذا كان من الضروري تجنب إعادة ترخيص الاقتصادات الوطنية، كما اقترح بعض القوميين والشعبيين، فقد نود إعادة النظر في حلقة فكرية أخرى منسية إلى حد كبير من لحظة ما بعد الحرب البروتينية في الأربعينيات من القرن الماضي - وهي فكرة الحكومة العالمية.
إن اقتراح فكرة وجود دولة على نطاق الكواكب، في وقت من ردود الفعل العنيفة ضد العولمة وتصاعد القوميات الشعبية، قد يبدو مجرد وهم طوباوي وليس شكلاً من أشكال الجنون السياسي، لكننا نعيش في زمن تتدهور فيه الحدود السياسية، والعديد من الأشياء التي بدت مستحيلة أو لا يمكن تصورها منذ بضع سنوات فقط تم تحقيقها أو تجاوزها، فمن الذي يقول إن المستقبل قد لا ينتمي إلى دولة عالمية؟ في الواقع، وبقدر صعوبة تخيل كيف يمكن لهذه الدولة أن تأتي إلى حيز الوجود؟