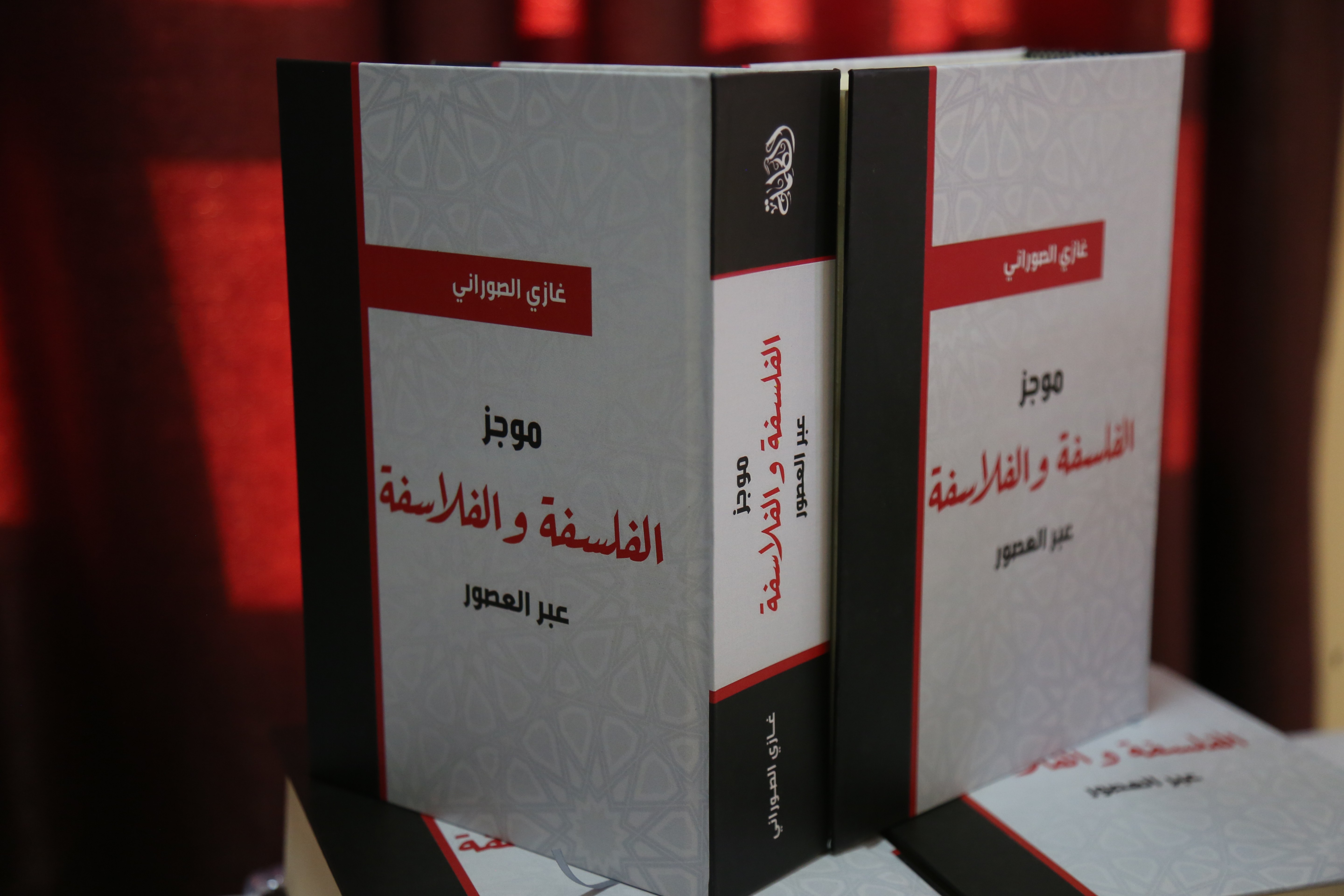(تنفرد بوابة الهدف، بنشر كتاب المفكر غازي الصوراني، المعنون: موجز الفلسفة والفلاسفة عبر العصور، الصادر عن دار الكلمة للنشر والتوزيع، في يونيو/ حزيران 2020، على حلقات متتابعة.. قراءة مثمرة ومفيدة نتمناها لكم).
الباب الثالث
الفصل السادس
أشهر فلاسفة الإسلام حتى بداية القرن الرابع عشر
شهاب الدين بن يحيى السهْرَوَرْدي (1155 – 1191 م):
ولد في سهْرَوَرْد سنة 549ه / 1155م، درس أولاً في مراغة بأذربيجان، ثم قدم إلى أصفهان بفارس حيث اطلع على ماثور ابن سينا، ومنها انتقل إلى الأناضول ونزل على الأمراء السلاجقة، وقصد أخيراً سورية.
السهروردي فيلسوف، وعالم زاهد من أعلام التصوف، ومؤسس المدرسة الإشراقية، وهو–كما يقول يوسف حسين-"شخصية جدلية انقسم الناس من حولها، فهو عند البعض شيخ الإشراق، وهو عند البعض الآخر: الضال والمرتد والزنديق، وأَطَلَق عليه البعض صفة المقتول وعند البعض الآخر العالِم الشهيد"([1]).
قرأ السهروردي –كما يضيف يوسف حسين- "معظم كتب الفلاسفة المسلمين ، وخاصة كتب ابن سيناء، وقام بترجمة بعضها إلى اللغة الفارسية، كما كان معتزلياً عقلانياً، ومتعاطفاً مع القرامطة، وكان أيضاً زاهداً مؤمناً بالله من ناحية، وبحرية الفكر وآراء المعتزلة من ناحية ثانية، فاتهم بالزندقة والكفر رغم شهادة بعض المؤرخين في عصره أنه امتلك عقيدة سليمه، وعاش حياته زاهداً ومتدنياً عقلانياً.
هذا الفيلسوف عاش حياة قصيرة، لكن غنيه بالتراث والابداع الأدبي والمعرفي، وكانت نهايته مأساوية إلى حد كبير، فقد كان من سوء حظه ان اجتمع ضده الَتَزُّمتْ والتعصب والحسد، فاتهموه بالزندقة وحاكموه بعد ان ألبَّوا عليه الملك الظاهر ابن صلاح الدين الايوبي، لكن "الظاهر" كان متعاطفاً مع السهروردي ولم يأمر بقتله، لكن العلماء المنافقين أرسلوا إلى والده صلاح الدين بضرورة قتل السهروردي، واستجاب صلاح الدين لهم وطلب من ابنه "الظاهر" قتل السهروردي فوراً، فقام الظاهر بوضعه في سجن قلعة حلب وطلب منه ان يختار طريقة موته، فاختار ان يموت جوعاً في السجن، وكان له ذلك ومات يوم 29 تموز 1191 وعمره 36، وبعد موته لقبه أتباعه بالشيخ الشهيد، وسماه مترجمو حياته بالشيخ المقتول.
وتعقيباً على مقتله ، قال أصدقاء السهروردي عن صلاح الدين: "كان كارهاً للفلسفة ولكل صاحب فكر سواء كان صوفياً أو شيعياً أو معتزلياً أو غير ذلك، واستجاب صلاح الدين للمنافقين ولم يستمع للمتهم السهرودري أو يُؤَمِّن له محاكمة عادلة، وأصدر حكم الموت دون محاكمة"([2]).
وفي هذا الجانب، أشير إلى ان صلاح الدين كان عدواً للقرامطة والفاطميين والمعتزلة، الأمر الذي شجعه على التعجيل بقتل السهرودري.
أما المؤيدين لمقتل السهروردي، فاعتبروا ان الحكم كان عادلاً بسبب زعمه بكفره من خلال كتبه التي قال فيها "ان الله نور وأن هذا العالم فاض عن الله بشكل الزامي ولم يأت عن طريق الخلق" كما كان يقول "ان هناك عالم للُمُثْل وعالم للأشباح يتوسط بين الأرض والسماء، وأن هناك عقول مجرده تتحكم بعالم الأرض، كما قال ان النبوة لم تنقطع.
أما ابن تيمية فقد قال إن "السهروردي كان يعد نفسه لكي يكون خليفة الله في الأرض، وعليه فهو يستحق الموت، كما قال أيضاً إلى ان أمثال السهروردي " كانوا يَدَّعون النبوة، لكنهم خافوا من السيف، ولذلك لا غبار على قتله"([3]).
ترك السهرودري–رغم عمره القصير- مجموعة من المؤلفات عددها يزيد عن 50 مصنف باللغتين العربية والفارسية، فقد كتب في العديد من الموضوعات: الفلسفة والمنطق، الطبيعة والميتافيزيقا، الحكمة، التصوف والعرفان، الأدب، والشعر، وقد تميزت كتبه بعمق الأفكار إلى جانب السرد التاريخي لفلاسفة اليونان والأديان القديمة وصولاً إلى الدين الاسلامي من موقع اعتناقه لمبادئ المعتزلة وتعاطفه مع القرامطة.
أهم مؤلفاته: "رسالة في اعتقادات الحكماء" ألفه السهروردي للرد على الأباطيل الملصقة بالفلاسفة والحكماء، كما استهدف السهروردي من خلال مؤلفاته – كما يستطرد يوسف حسين- "ازالة سواء الفهم لدى الناس حول الدين والعقل والايمان وشرح معتقدات الفلاسفة قبل الاسلام ، محاولاً التقريب بين الدين والفلسفة، خاصة الفلسفة الاشراقية، مؤكداً على "ان العقل كان أول ما خلق الله"([4]).
بلغ عدد كتبه تسعة وأربعين عنواناً، وأهمها إطلاقاً حكمة الإشراق وهياكل النور، وقد عرف أتباعه بالاشرافيين، وأشهرهم شمس الدين الشهرزوري و"فلسفة النور" هو العنوان العام الذي يمكن أن يوضع لفلسفته التي أرادها "حكمة مشرقية" تبعث حكمة فارس القديمة، وتتمم المشروع الذي ما استطاع ابن سينا إنجازه لجهله، على حد تعبير السهروردي، بـ"الأصل المشرقي"، وتسيطر على فلسفة السهروردي النورية وجوه ثلاثة: هرمس وأفلاطون وزرادشت.
ابن عربي (1165 - 1240):
أبو بكر محمد بن علي محيي الدين، الملقب بـ"الشيخ الأكبر"، كاتب متصوف عربي، ولد في 28 تموز 1165 (17 رمضان 560) في مرسيه (اسبانيا)، وتوفي في 16 تشرين الثاني 1240 (28 ربيع الثاني 638) في دمشق (سورية).
(وحدة الوجود) ومذهب ابن عربي .. في المصطلح ، والتاريخ :
فكرة "وحدة الوجود" تقترن، في تاريخ "التصوف الاسلامي"، باسم محيي الدين بن عربي أحد كبار الصوفية العرب ذوي الشهرة الأوسع والتأثير الأعمق في الفكر الصوفي الفلسفي خلال الزمن المتأخر من العصور الوسطى([5]).
هذه الفكرة اقترنت باسمه مصطلحاً ومضموناً معاً. فان مصطلح "وحدة الوجود"، بالرغم من تردده في المذاهب الصوفية التي سبقت مذهبه، لم يستقر كمصطلح صوفي معترف به يعبر عن اتجاه محدد في تفسير "التوحيد" في الفهم الصوفي، الا في مذهب ابن عربي، الذي أكسَبَ هذا المصطلح مضموناً جديداً يمكننا أن نرى فيه محاولة جديدة عند المتصوفة الاسلاميين لمعالجة استحالة الجمع بين الوحدة المطلقة للذات الإلهية وعدم انفصالها عن العالم"([6]).
نقول: انها محاولة جديدة، وجريئة ايضاً، وربما كانت جراءتها بالذات مصدر تأثيرها القوي في أدبيات الصوفية الاسلاميين منذ عصر ابن عربي حتى الازمنة الاخيرة.
فلماذا هي جريئة؟ انها كذلك، لان فكرة "وحدة الوجود" كانت دائماً، قبل ابن عربي، تتردد في الفكر الصوفي الصوفي باحتراس شديد وبحذر بالغ، بل بالرفض احياناً،ولعل مصدر الاحتراس والحذر، أو الرفض: إما الخضوع لمبدأ "التقية"، أو التأثيرات الايديولوجية اللاهوتية، وإما إفتقار الفكرة نفسها إلى التبلور في صيغة فلسفية صوفية كالتي انتهى اليها ابن عربي، ولعل هذه الأسباب مجتمعة هي مصدر ذلك الاحتراس والحذر، وذلك الرفض.
وربما صح القول –كما يرى د. حسين مروة- ان السبب الاقوى هو تلك المواجهة الحادة التي برزت، أو بلغت ذروتها، في عصر ابن رشد وابن عربي، بين اتجاهي الفكر العربي – الاسلامي الرئيسين: الاتجاه العقلاني، الذي تخلص عند ابن رشد من النزعة الصوفية نهائياً .. والاتجاه الحدسي الصوفي، الذي اعتمد "الرؤيا" الغيبية، عند ابن عربي، كأساس للمعرفة، ولعل المفهوم المغرق في التجريد الذي اتخذته فكرة "وحدة الوجود" في مذهب ابن عربي، كان التجلي الابرز لتلك المواجهة الحادة بين هذين الاتجاهين.
ابن عربي "يحمل دلالة غير مباشرة – لكنها واضحة- على اعترافه بأن العالم قديم (أزلي)،إنه هناك يضع مسألة الوجود، على نحو قاطع، بأن تحققه – أي الوجود- مرتبط بمشيئة الله في أن يرى نفسه متجلية في مرآة العالم، ومن المُسَلَّم به عند الصوفية الاسلاميين ، ان هذه المشيئة قديمة، فالتجلي الالهي، أي تحقق الوجود، قديم اذن بالضرورة"([7])،وقد "هاجم الفقهاء المسلمون السنيون، ابن عربي بضراوة، لأنهم رأوا في واحديته الوجودية، في نظريته في "وحدة الوجود"، مذهباً حلولياً بكل ما في الكلمة من معنى.
ترك لنا "ابن العربي" من شعره ديواناً، أما من الناحية المذهبية فقد ضمنت مجموعة تصانيفه الرئيسية، علاوة على تفسير للقرآن، كتاب "الفتوحات المكية"، وهو عبارة عن موسوعة للعلوم الباطنية في خمسمئة وستين فصلاً، و"فصوص الحكم"، وهو بمثابة وصية روحية حررها سنة 1229 ودرس فيها الرسالة الروحانية لكل نبي من الأنبياء الذين يجلهم القرآن، والفصلان الرئيسيان في فصوص الحكم – كما يقول جورج طرابشي- هما اللذان يتصلان بالحكمة الإلهية في كلام آدم، وبحكمة الوحي الإلهي في كلام شيت، وقد ترجمت رسالة القدس إلى الاسبانية في حياة القديسين الاندلسيين، بقلم د. ميغل آسين أي بالاسيوس، وهو واضع دراسة عظيمة الأهمية عن طريقة "ابن عربي" الروحية بعنوان "الإسلام متنصراً"؛ 1931، تضمنت ترجمة لعدة فقرات من الفتوحات المكية ومن تآليف أخرى بلغت أكثر من 150 مصنفاً"([8]).
ولنذكر أخيراً – كما يضيف جورج طرابشي- أن آلآسين إي بالاسيوس، في دراسته عن الأخرويات الإسلامية في الكوميديا الإلهية (1919)، أثبت ما كان لكتاب ابن عربي، "كتاب الإسراء"، الذي يصف رحلته عبر عوالم الآخرة الثلاثة، من تأثير على الكوميديا الإلهية لدانتي. (انطوان ترافير).
"هناك الكثير عند ابن عربي مما يذكرنا بسبينوزا، ولكنها مجازفة منا حقاً أن نزعم أن هذا اليهودي الاسباني كان على معرفة بآراء المسلم الأندلسي الذي كان تماديه في الخيال الصوفي كثيراً ما يخفي حقيقة كونه مفكراً جاداً عبقرياً كذلك" (رينولد أ. نيكولسون) ([9]).
ابن تيمية (1263 م– 1328م) :
تقي الدين بن أحمد ابن تيمية، فقيه حنبلي وإمام سلفي، ولد في حران سنة 661ه / 1263م، ومات في دمشق سنة 728ه / 1328م.
ارتحل إلى مصر سنة 705 ه / 1305م، وهناك وضع رسالته الشهيرة "رد المنطقيين" التي حاول فيها أن يدحض المنطق اليوناني، ودعاوي كبار الفلاسفة من أمثال الفارابي وابن سينا، حيث أعلن ابن تيمية في رسالته هذه، رفضه للفلسفة التي اعتبرها معادية للدين، واعتبر كل من اقترب من الفلسفة كافر، وهو القائل "من تمنطق فقد تزندق" ورد عليه ابن حزم الاندلسي قائلاً: "من تمنطق يكون قد تحقق" (أي أنه وصل إلى الحقيقة).
كان ابن تيميه من ألد خصوم الفلاسفة والمتكلمين والمتصوفة، وقد استلهم فكره على أوسع نطاق دعاة السلفية في القرن التاسع عشر، وهاجم مدارس الحلاج وابن عربي في صنوفها المختلفة، وبسبب آراؤه السلفيه المغالية في التصعب الديني، "اتهم بالتجسيم والتشبيه، وبالانتقاص من مقام النبي والأولياء، فحوكم وسجن مرتين، وتوفي في سجنه في دمشق سنة 728ه، تاركاً مؤلفات ضخمة كتب بعضها في حبسه، وكان أشهر تلاميذه ابن قيم الجوزية الذي تبعه إلى السجن وشرح مصنفاته"([10])، والتزم بآراء ومواقف استاذه ابن تيميه من حيث التطرف السلفي والمغالاة في الآراء الدينية، لدرجة العداء الشديد للفلسفة والمنطق، ومن ثم دعم وتبرير موجة الإرهاب خلال القرن الرابع عشر، مستلهماً أسلوب ابن تيمية الذي حارب الفلسفة داعياً إلى اضطهاد كل من يدعو إليها، "وطالب بتحريم قراءة كتب الفلاسفة، واتهم ابن سينا بالالحاد في كتابه "مجموعة الرسائل الكبرى""([11]).
أهم كتبه إطلاقاً منهاج السنة الذي وضعه بين عامي (1316 – 1320 م) رداً على منهاج الكرامة للعلامة الحلي، تلميذ نصير الدين الطوسي.
ابن القَيِّم الجوزية (1292 - 1350):
"محمد بن أبي بكر الزرعي، متكلم جدلي، وفقيه حنبلي، ولد في دمشق وتوفي فيها سنة 751 ه / 1350م.
يعتبر من أوفى تلاميذ ابن تيمية وأشهرهم على الإطلاق فيما يتعلق بالموقف ضد الفلسفة والفلاسفة كما في التطرف السلفي الإرهابي، وقد نشر تعاليمه وشرح تراثه وسجن معه مرتين.
قاوم الفلاسفة وأرباب المِلل والنِحَل ترك زهاء ثلاثين مؤلفاً، ومنها كتاب "الروح"، وهو يبحث في أرواح الأحياء والأموات، وكتاب "شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل"، وكتاب "حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح في ذكر الجنة"، وكذلك "مدارج السالكين وزاد المعاد في التصوف والأخلاق""([12]).
يعتبر ابن القيم الجوزيه، مع استاذه ابن تيمية، من أهم المراجع الفقهيه الدينية لكافة حركات الإسلام السياسي المعاصرة عموماً ولجماعة "الإخوان المسملين" خصوصاً.
ابن خلدون ( 1332 م . _ 1406 م . ):
هو عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون أبو زيد ولي الدين الحضرمي الإشبيلي، ولد في تونس وشب فيها وتخرّج من جامعة الزيتونة، وُلِّيَ الكتابة والوساطة بين الملوك في بلاد المغرب والأندلس ثم انتقل إلى مصر حيث قلده السلطان برقوق قضاء المالكية.
يمكن اعتبار ابن خلدون علامة بارزة في تأسيس علم الاجتماع، وذلك ارتباطاً بما توصل إليه من نظريّات حول قوانين العمران ونظرية العصبية، وبناء الدولة وأطوار عَمَارِها وسقوطها. وقد سبقت بعض آراؤه ونظرياته ما توصّل إليه لاحقًا بعدّة قرون عدد من مشاهير العلماء كالعالم الفرنسي أوجست كونت.
وضع ابن خلدون عدداً من المصنفات في التاريخ والحساب والمنطق، غير أن من أشهر كتبه كتاب بعنوان: "العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر"، وهو يقع في سبعة مجلدات وأولها "المقدمة" وهي المشهورة أيضا "بمقدمة ابن خلدون"، وتشغل من هذا الكتاب ثلثه، وهي عبارة عن مدخل موسع لهذا الكتاب وفيها يتحدث ابن خلدون ويؤصل لآرائه في الجغرافيا والعمران والفلك وأحوال البشر وطبائعهم والمؤثرات التي تميز بعضهم عن الآخر"([13]).
ففي مقدمته المطولة التي عرفت باسم " مقدمة ابن خلدون " تناول كثيراً من الموضوعات الهامة :-
- حقيقة التاريخ ومهمة المؤرخ .
- العوامل الطبيعية في تكوين الأمم .
- المؤسسات الاجتماعية في البدو والحضر .
- العوامل الاجتماعية في نشوء الأمم .
- العوامل العارضة في المجتمع الإنساني .
لقد حدد في هذه المقدمة، الهدف من بحثه ومنهجه، فالتاريخ عند ابن خلدون "هو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون الأولى تنمق فيها الأقوال وتضرب الأمثال"، ولكنه "في باطنه نظر وتحقيق، وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق، وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو ذلك أصيل فيا لحكمة عريق".
وبالفعل، ليس الهدف بالنسبة إلى ابن خلدون تقديم جردة باحداث التاريخ على نحو ما صنع المتقدمون عليه، بل خلق التاريخ بالأدوات التي يمده بها العلم الاسلامي.
وفي الوقت الذي عارض فيه ابن خلدون أهل النظر المحض من الفلاسفة وأصحاب الكيمياء والتنجيم، تبنى المبادئ المنهجية الواقعية للعلوم الدقيقة: طلب الموضوعية، وصرامة التحليل للظاهرات الاجتماعية – السياسية.
ولسوف يتوقف ابن خلدون، في تأمله في علة أحداث الماضي وكيفيها، عند الواقعة السوسيولوجية بوصفها بنية جدلية أساسية للتاريخ، ليعيد عقد الصلة في التيارات التاريخية بين السياسة والاقتصاد والثقافة"([14]).
بالاضافة إلى ما تقدم، كان ابن خلدون يرى أنه لا حاجة لنا بقوانين المنطق الصوري (الأرسطي) لأنها " لا تتفق مع طبيعة الأشياء المحسوسة، ولذلك يجب على العالم أن يفكر فيما تؤدي إليه التجربة الحسية وألاَ يكتفي بتجاربه الفردية"؛ إن ابن خلدون يعتبر فيلسوفاً حسي النزعة لا يؤمن إلاَ بالمحسوس والتجربة، ورأى أيضاً أن المنطق طبيعي في الإنسان وأن العقل الذي وهبه الله إياه طبيعة فطرها الله فيه، فيها استعداد لعلم ما لم يكن حاصلاً .
قالوا عنه([15]):
- ابتكر ابن خلدون وصاغ فلسفة للتاريخ هي بدون شك أعظم ما توصل إليه الفكر البشري في مختلف العصور والأمم. أرنولد توينبي
- إن مؤلف ابن خلدون يمثل ظهور التاريخ كعلم، وهو أروع عنصر فيما يمكن أن يسمى بالمعجزة العربية. ايف لاكوست
- إنك تنبئنا بأن ابن خلدون في القرن الرابع عشر كان أول من اكتشف دور العوامل الاقتصادية وعلاقات الإنتاج. إن هذا النبأ قد أحدث وقعًا مثيرًا وقد اهتم به صديق الطرفين (المقصود به لينين) اهتمامًا خاصا. من رسالة بعث بها مكسيم غوركي إلى المفكر الروسي انوتشين بتاريخ 21/ايلول سبتمبر 1912.
- ترى أليس في الشرق آخرون من أمثال هذا الفيلسوف. (لينين)
([1]) يوسف حسين – محاضرة في اليوتيوب – الانترنت.
([2]) المرجع نفسه .
([3])المرجع نفسه .
([4]) المرجع نفسه .
([5])هو أبو بكر محمد بن عربي الطائي (نسبة إلى قبيلة طيء العربية). ولد في بلدة مرسبة بالاندلس (560 هـ / 1164م)، عاش في موطنه الاندلس نحو 38 سنة، وعاش بقية عمره في المشرق. مات في دمشق 638 هـ / 1240. لقب بـ"محيي الدين" وبـ "سلطان العارفين" تعبيراً عن منزلته الصوفية و "العرفانية". وفي المشرق كتب أهم مؤلفاته الصوفية التي تشرح فكرة "وحدة الوجود"، لا سيما كتاباه : "الفتوحات المكية" و "فصوص الحكم". اجتمع وابن رشد في عصر واحد، والتقيا في قرطبة ، وكتب ابن عربي فصلاً ممتعاً عن هذا اللقاء في "الفتوحات المكية" (ج1 ، ص153 – 154، ط. القاهرة 1329).
([6]) حسين مروة – مرجع سبق ذكره – النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية – الجزء الثاني – ص271
([7]) المرجع نفسه – ص287
([8]) جورج طرابيشي – مرجع سبق ذكره – معجم الفلاسفة – ص 32
([9]) المرجع نفسه – ص 32
([10]) المرجع نفسه –ص 19+20
([11]) حسين مروة- مرجع سبق ذكره – النزعات المادية في الفلسفة العربية الاسلامية – الجزء الأول – ص906.
([12]) جورج طرابيشي – مرجع سبق ذكره – معجم الفلاسفة – ص 33
([13]) موقع ويكيبيديا – الانترنت .
([14]) جورج طرابيشي – مرجع سبق ذكره –معجم الفلاسفة – ص 21
([15]) موقع ويكيبيديا – الانترنت .