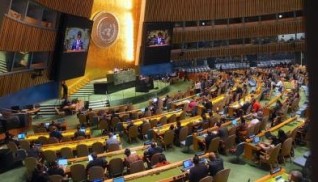بقلم الأسير: سامر عربيد
قيادي في الجبهة الشعبية - سجن نفحة الصحراوي/ فلسطين
لا شكَّ أنّه على الدوام هناك نقاشاتٌ وتحليلاتٌ تُثار في كثيرٍ من المحطّات والمراحل، وعلى الأصعدة الاجتماعيّة كافةً، الاقتصاديّة، السياسيّة وغيرها، ولكن محور السؤال فيها الذي يُشغل عقول الكثيرين: ما السبب الرئيس أو الحاسم في التغيير؟ سواء كان هذا التغيير إيجابيًّا أم سلبيًّا، إلى الأمام أو إلى الخلف، انكسارًا أو انتصارًا، وربّما الإجابة تختلف من فئةٍ إلى أخرى، ومن مصدرٍ إلى آخر، وذلك باختلاف المنهج التحليلي في التفكير، الذي نستند عليه بالخروج بالنتائج.
وبكل الأحوال فإنّ الطريقة التي تحلّ بها الإجابة عن السؤال المركزي لا تخرج عن نطاق التعريف بالفلسفة المثالية والمادية الجدلية من جهةٍ أخرى، وهناك اختلافٌ كثيرٌ بين الأولى والثانية تقودنا إلى إجاباتٍ مختلفةٍ ومتباعدة؛ فالمثالية تفسر أساس أي تطوّرٍ أو تغييرٍ من خارج الموضوعات والظواهر، أما المادية الجدلية فتفسر جوهر التطوّر والتغيير من داخل الموضوعات والظواهر؛ إذ إن المهم في التطور بالنسبة لها هو مسألة أصله وقواه المحركة، فكل موضوعٍ أو ظاهرةٍ تحمل بداخلها النقائض أي الأضداد (سالب/موجب) (قوة جذب/قوة انفصال) (خير/ شر) (معرفة/ جهل) (استعمار/ ثورة) (كراهية/ حب) وغيرها الكثير الكثير من الأضداد التي توجد في الظواهر والموضوعات، ومنها أنفسنا التي لا يحلّها غير قانون (وحدة وصراع الأضداد). فالتطوّر - إذًا - هو صراع الأضداد، الذي لا ينتهي إلا بسيادة أحد النقيضين ونفي الآخر، وهذه المسألة أساسية لا يمكن تجنبها في تحليل الواقع من أجل الخروج بنتائجَ سليمةٍ وصحيحة، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الترابط، الذي لا تُهمله الماديّة الجدليّة؛ فعناصر أي واقعٍ لا يمكن أن تتطوّر بصورةٍ منعزلةٍ أو مفصولة، وإنّما هي على ارتباطٍ مع بعضها البعض، وتؤثّر على بعضها بصورةٍ متبادلة.
غير أن العالم والواقع مليء بالتناقضات (الأضداد) وفي حياتنا نتصادم معها يوميًّا، فكيف نصنّفها ونحلّلها بفهم ما هو داخليٌّ وما هو خارجي؟ ما هو الأساسي أو الرئيسي وما هو الثانوي؟ ما هو التناحري وغير تناحري؟ إذ إنّ طرق حل التناقضات يعتمد بدرجةٍ أولى على تصنيفنا لها، وقبل كل شيء، ولكي لا نقع في خطأ الإجابة يتطلب المنهج المادي الجدلي أن نُميّز التناقضات الداخلية عن التناقضات الخارجية، وهذا مهمٌّ جدًّا إذ لا يجوز الخلط بينها وتداخلها لتصبح الخارجية هي الداخلية أو العكس، وسنوضح ذلك بأمثلة.
أما وحسب التعريف الماركسي فإنّ "التناقضات الداخلية هي تفاعل صراع الجوانب المتعارضة في موضوع معين، أما التناقضات الخارجية فهي العلاقات المتناقضة بالموضوع المعين مع الوسط المحيط، أي مع موضوعات وعناصر هذا الوسط".
إذن، وعند لجوئنا وتحليلنا لأي ظاهرةٍ علينا أن نحدّد أوّلًا ما هو الذاتي أو الداخلي منها، وما هو الموضوعي أو الخارجي؟ وما هي العلاقة بينهما؟ والأهم من هذا أو ذاك هو أيهما الحاسم في التغيير والتطور؟ إذ كما قلنا فإنّ منهج التفكير هو الذي يحدّد الإجابة.
على سبيل المثال، وعند دراسة التطور التاريخي للمجتمعات البشرية، وانتقالها من تشكيلةٍ اقتصاديةٍ اجتماعيّةٍ إلى أخرى، فإنّ المثالية بأنواعها تذهب في تفسيرها وتحليلها إلى التناقضات الخارجية مصدرًا وحيدًا للتطوّر، كأن يعدّون أن هنالك قوّةً خارج أو فوق الطبيعة والمجتمع هي سبب التغيير والانتقال، وهذه القوة خارج وعي الإنسان والمجتمع، وأن التناقض الخارجي بين المجتمع والطبيعة هو السبب، ولا يعترفون أن صراع الطبقات على مدار التاريخ البشري هو المصدر الأساسي وأصل تطور المجتمعات (من المشاعية البدائية إلى العبودية إلى الإقطاعية إلى الرأسمالية ومن ثم إلى الاشتراكية)؛ فالمحرّك الأساسي للانتقال من مرحلةٍ إلى أخرى، ومن تشكيلةٍ إلى أخرى، هو تفاعل وتناقض الطبقات فيما بينها، وهي المحرك والدافع الأساسي، وكأنّها صاعق الانفجار، وهذه ثورات لم تأتِ بفعل الطبيعة، أو قوى خارج أو فوق أو تحت الطبيعية وغير ملموسة، وإنما نتيجة الصراع الطبقي داخل هذا البلد أو ذاك، وبتأثير عواملَ محيطةٍ وموضوعيّةٍ غير حاسمة.
وكذلك الأمر عند دراسة انتقال جزيئات الماء من حالة السيولة إلى الغازية أو الصلبة؛ فالصراع بين قوة الجذب وقوة التفكك للجزيئات هو الذي يؤدي إلى الانتقال وبتأثير درجة الحرارة؛ إذ عند درجةٍ محدّدةٍ تبدأ حالة الغليان ومن ثم التبخر، وعند درجة أخرى تبدأ الجزيئات بالتصلب، بينما لو تعرّضت جزيئات مادة أخرى مثل الحديد والفولاذ بنفس درجات الحرارة، فإنّ عملية الانتقال أو التحوّل لا تحدث، وهذا يعني أن الحاسم هو الصراع الداخلي بين القوى النقيضة، وليس درجة الحرارة التي لا تعدّ إلا عاملًا مؤثّرًا وليس حاسمًا.
وانسجامًا مع ذلك، ولو انتقلنا إلى واقعنا الفلسطيني الذي يشهد اليوم حالةً من الانقسام والتشرذم السياسي والاجتماعي منذ سنوات، وسألنا لماذا لم تحقّق الحركة الوطنيّة الفلسطينيّة بكل قواها وفصائلها رغم ما قدمته من تضحياتٍ جسامٍ الأهداف المعلنة في برامجها وهي التحرير والاستقلال، في الوقت الذي حققت فيه حركاتٌ ثوريّةٌ في العالم، سواء في الجزائر أو كوبا أو فيتنام أو غيرها أهدافها المنشودة؟ هل تآمر القوى الإمبريالية في العالم ودعمها غير المحدود للصهيونيّة هو السبب؟ هل العوامل الخارجية من موازين قوةٍ عالميّةٍ هي السبب؟ أم ضعف وتآمر القوى الرجعية العربية على ثورتنا هو السبب؟ هل انهيار الاتحاد السوفييتي وسيادة القطب الواحد هو السبب؟ أم كل هذه العوامل مجتمعة؟ أم أن أسباب وعوامل داخلية هي الرئيسية والعوامل الأخرى الخارجية هي السبب؟
الإجابة طبعًا، ومن منطلق المنهج المادي الجدلي في التحليل، هو العامل الذاتي الذي يجب أن نغوص فيه لتحليل الأسباب الرئيسية وحلّها (القلعة تُقتحم من حصان طروادة وليس من خارجها)، وفي حالتنا الفلسطينيّة هناك العديد من الأسباب الذاتية التي أدّت بنا إلى ما وصلنا إليه، ومنها البيروقراطية، الاستزلام، غياب الديمقراطية الثورية الحقيقية والتفرّد في القرار، الأقطاب والتكتلات، الموروث الفكري التقليدي الذي ما زال يسيطر على عقول الكثيرين، ومنهم قيادات وكوادر في أحزاب وفصائل وطنية وغيرها الكثير من الأسباب الذاتية المتراكمة، التي أدّت إلى انزلاقاتٍ وانحرافاتٍ عن المبادئ التحررية للثورة الفلسطينية المعاصرة، كما وأدت إلى انقساماتٍ عموديّةٍ وأفقيّةٍ في المجتمع الفلسطيني.
أما العوامل الموضوعيّة، وإن كان لها تأثير لا يمكن لأحد أن يُلغيه أو ينفيه فهي فقط قد تعرقل وتعيق التغيير ولكن لا تحسم المسار، فأي تراجعٍ أو نهوض، انتصار أو انكسار في الحركات الثورية سببه الأساسي هو الذاتي من الأسباب، وقد يلجأ الكثيرون لذكر الأسباب الموضوعية هروبًا من الذات وأسباب ضعفها أو تراجعها أو فشلها، وهم بذلك يقعون في وحل المثاليّة بعيدًا عن العلمية التي تعمق فحصها وتحليلها للذاتي بترابطه الجدلي مع الموضوعي الذي يؤثر فيه.
والأمثلة تبقى كثيرةً في حياتنا اليومية والنضالية وتؤكّد نفس النتيجة، فإن جاء أحد ليسأل عن أسباب الصمود أو السقوط في أقبية التحقيق، كمعركة بين نقيضين (الجلاد والمناضل)؛ فإن الجواب وببساطة يكمن في الذات أيضًا (البيضة تكسر في اليد أما الصوان فلا) فليس تراجع الحركة الوطنية الفلسطينية هو السبب، وليس أساليب التحقيق المختلفة من تعذيبٍ جسديٍّ أو نفسيٍّ هو السبب، وليس تنامي الاهتمام بالشأن الخاص على حساب العام هو أيضًا السبب، وليس لأن هناك تراجعًا تنظيميًّا وما يعنيه من ضعفٍ في التربية الثقافيّة والأمنيّة هو السبب، أو غيرها من الأسباب التي قد يسردها البعض لتفسير أو تبرير السقوط، فكل هذه العوامل تبقى موضوعيّةً وغير حاسمةٍ، وإن كانت تؤثّر في معركة الإرادات بين إرادة الانسان المناضل الثورية، وإرادة الجلادين والجلاوزة، فمهما تكالبت وتكاثفت الظروف على المناضل يبقى هو من يصنع قراره ومصيره، سواء صموده أو سقوطه.
إذن؛ فسواء كان الذاتي المجتمع، والموضوعي العالم ككل أو الطبيعة، أو كان الذاتي هو الإنسان والمجتمع هو الموضوعي، أو الحزب الثوري هو الذاتي والشعب هو الموضوعي، أو أن الشعب بقواه وفصائله هو الذاتي والوضع الدولي والإقليمي وموازين القوى في العالم هو الموضوعي، فإنه يبقى في إطار التأثير والتأثر المتبادلين، الذاتي هو الحاسم في التطور، أما التناقضات الخارجية فهي فقط الدافع والشرط الضروري للتطور.
وعلى هذا الأساس علينا الابتعاد عن المثالية بأنواعها، فهي تقودنا إلى تبرير أخطائنا وتراجعنا وضعفنا وانكسارنا، ولا تجعلنا نمسك بالأسباب الحقيقيّة التي تدفعنا إلى الأمام والنهوض للوصول إلى أهدافنا سواء الكثيرة منها أو الصغيرة؛ فالوقوف أمام الذات ونقدها ومساءلتها ومحاسبتها أمر ضروري من أجل الخلاص من العيوب والنواقص وإلا سنبقى نلعن الظلام مليون مرة، وفي الختام هل وقفنا أمام ذواتنا؟